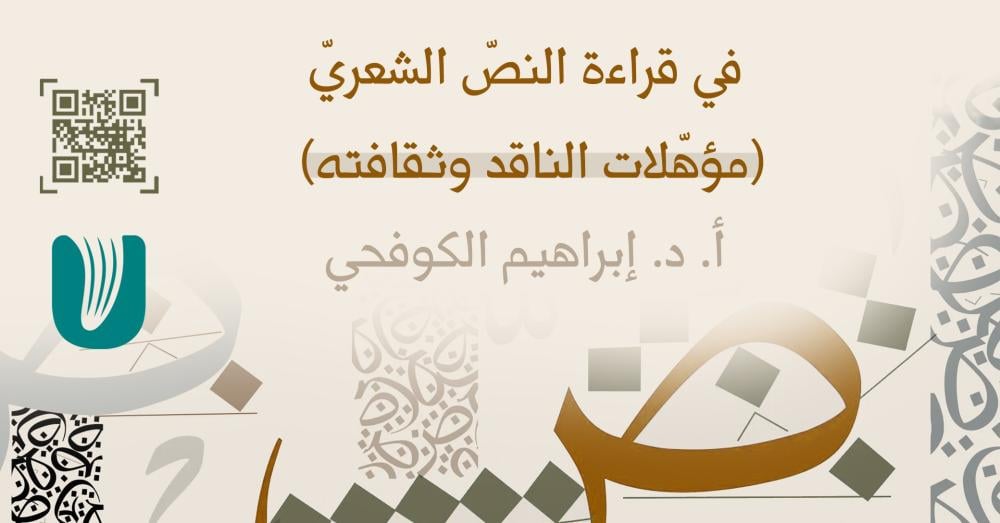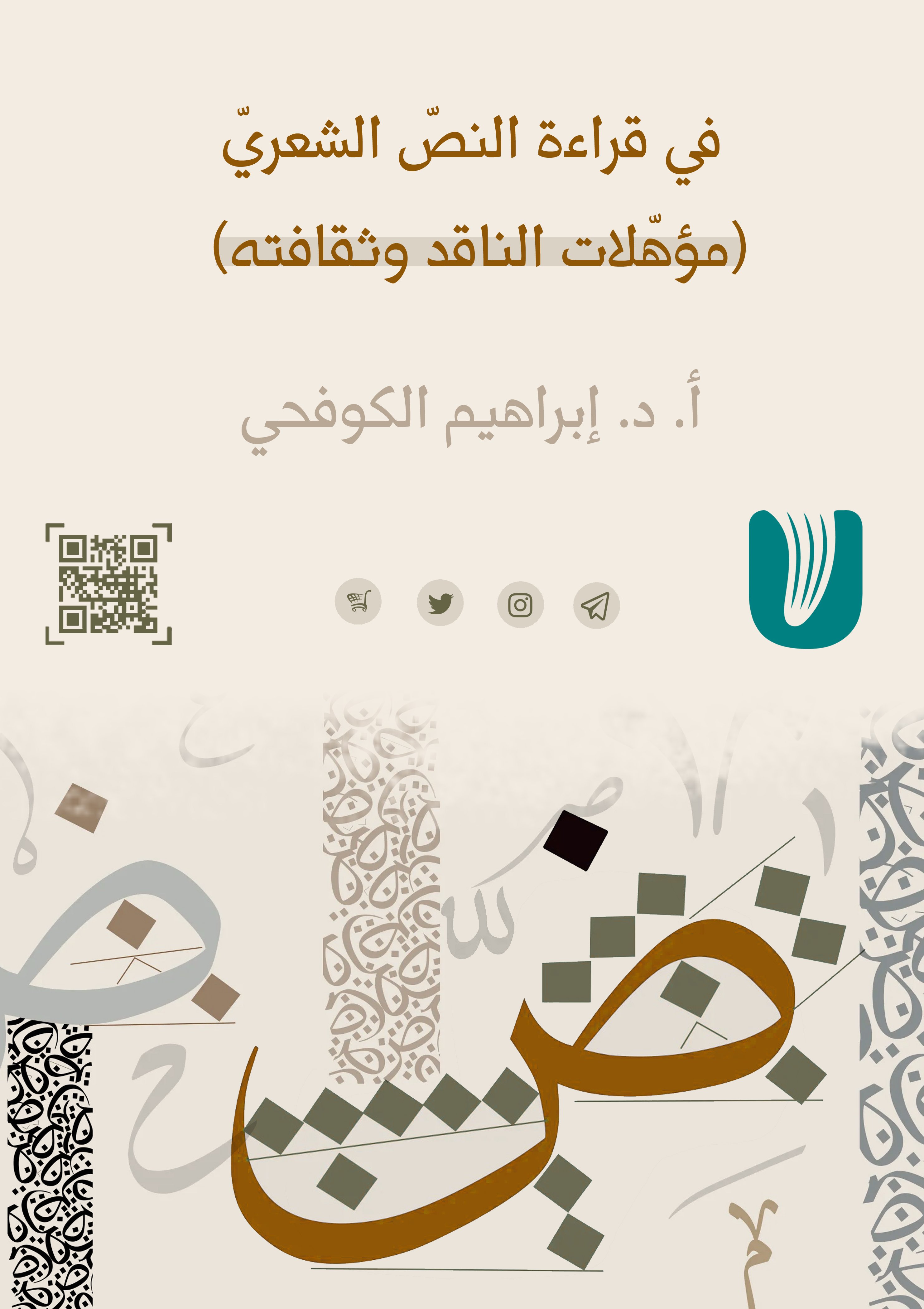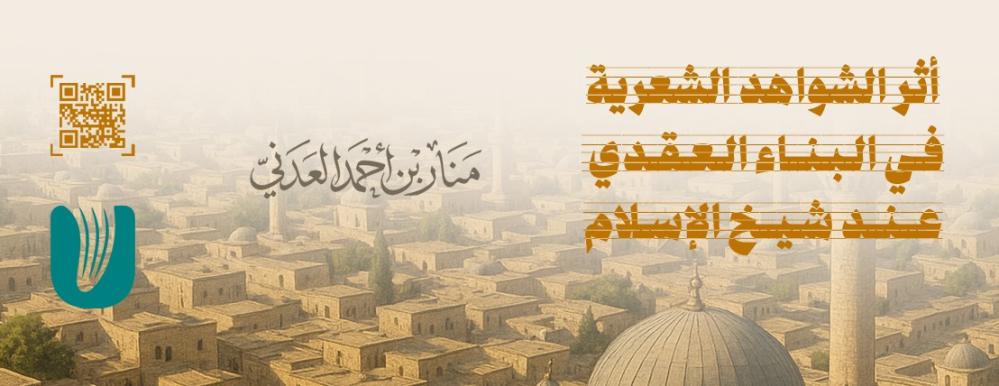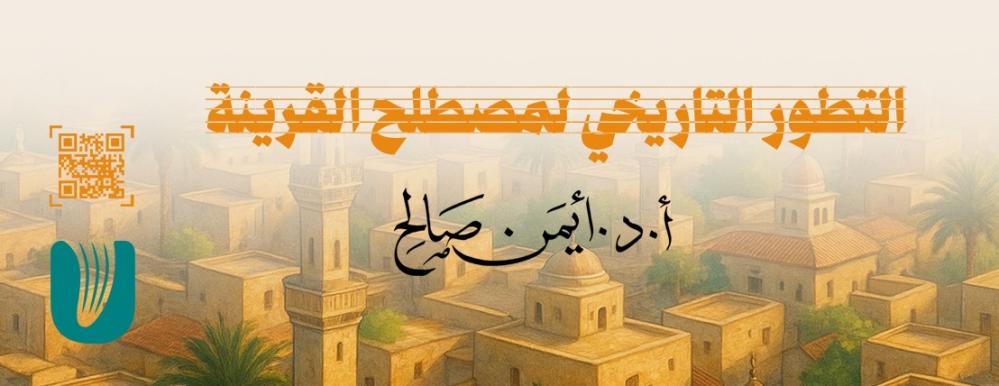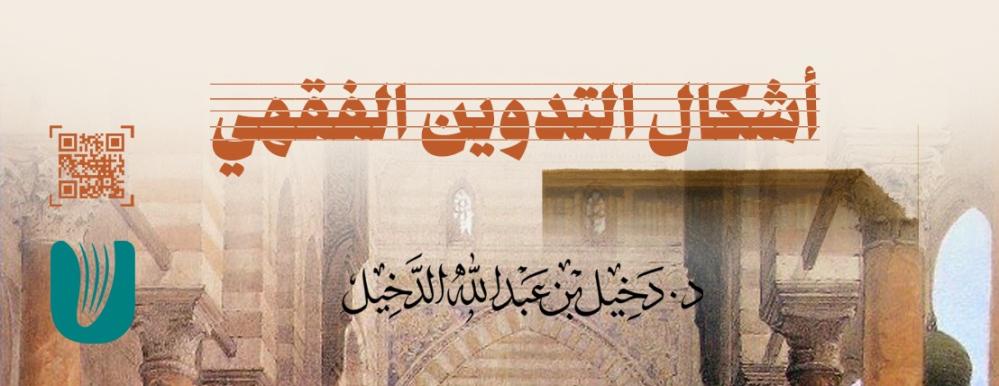في قراءة النص الشعري
(مؤهلات الناقد وثقافته) في التراث العربي
أ.د.إبراهيم الكوفحي
كلية الآداب، الجامعة الأردنية
عمّان/ الأردن
ناقش تراثنا النقديُّ، على امتداد قرونه المتتابعة، جَمّاً غفيراً من القضايا والموضوعات الأساسيّة التي تتعلّق بفنِّ الشعر، تحديداً، سواء على مستوى الإبداع أو التلقِّي، ومن ذلك ما يتصل بموضوع (مؤهّلات الناقد وثقافته)، الذي نحاول أنْ نجلوَ أبعاده بإذن الله تعالى في هذه الصفحات (القليلة) من خلال الوقوف على أقوال عَدَدٍ من النقّاد الذين تطرّقوا إليه وعُنوا بمناقشته، وهو موضوعٌ على قَدْرٍ كبيرٍ من الأهميّة والحيويّة، لارتباطه المباشر بفنّ الشعر، ومسيرته التجديديّة والتحديثيّة.
إنَّ الشعر هو موضوع العمل النقديّ، وهو فنّ، كغيره من الفنون، في حركة تطوريّةٍ دائبةٍ، سواء على صعيد الرؤية والمضمون أو على صعيد البناء والتشكيل الفنّي، وذلك مما يحور، في المقام الأول، إلى اختلاف الزّمان، وتطوّر الحياة الإنسانيّة، مادياً وثقافياً، وهذا يعني ببديهة العقل أنَّ أدوات القارئ/ الناقد هي الأخرى في حركةٍ تطورية مستمرّة، ليظلّ الناقد قادراً على ممارسة عمله، وأداء وظيفته، وتأكيد حضوره، وإلا فشل فشلاً مخزياً، وطرد شرّ طردةٍ.
ولعلَّ من السهولة أن نتبيّن ذلك، جليّاً، من خلال المقارنة بين الشعر العربيّ في العصر الجاهليّ، وما أصبح عليه في العصور اللاحقة، غبّ نزول القرآن، واستفاضة الإسلام، وفتوح البلدان، وبلوغ الحضارة العربيّة آمادها البعيدة..، وكذا حين نقارن بين الناقد/ الانطباعيّ الذي عرفه العصر الجاهليّ، والناقد/ المنهجيّ في العصور الإسلامية، ولا سيّما العصرُ العباسيّ، بعد أنْ صار النقد الأدبيّ اختصاصاً معلوماً له رجاله، وميداناً رحيباً يقتضي من نازليه أنْ يمتلكوا العدّة اللازمة، والأسباب المؤهّلة.
لقد تنبّه نقدنا العربيّ إلى صعوبة فنّ الشعر، إذ يتطلّب أشياء كثيرةً، وعلى صاحبه أنْ يبذلَ جهوداً كبيرةً، إذا ما أراد أن يكون شاعراً مبدعاً ومؤثراً..، ولا شكَّ أنَّ هذا يشوّر، في الوقت عينه، إلى صعوبة الممارسة النقدية، وكذلك إلى الجهود الضخمة التي يجب أن يبذلها الناقدُ، حتى يكون ناقداً معتبراً، يقبل رأيه، ويؤخذ بحكمه. وكثيراً ما جرى، في هذا السياق، استحضار صورة (البحر) بملامحها المتعدّدة، لبيان ذلك...، فالشعر «كالبحر أهون ما يكون على الجاهل أهون ما يكون على العالم، وأتعب أصحابه قلباً مَنْ عرفه حقّ معرفته»([1])، وهو «بحرٌ لا ساحل له، يحتاج صاحبه إلى تحصيل علومٍ كثيرةٍ، حتى ينتهي إليه، ويحتوي عليه»([2])، وهو «البحر الذي لم يصل أحدٌ إلى نهايته إلا مع استنفاد الأعمار»([3])... إلخ.
لا جَرَمَ أنَّ عملَ الشاعر أو الناقد ليس من اليسر، فهو عملٌ له أدواته ومستلزماته، وهذا يعني أنه لا يتهيأ لكلّ مَنْ هبَّ ودبَّ، بل له أهله والمختصّون به، ولذلك كثيراً ما تعالت الشكوى من كثرة المدّعين لهذا الفنّ والمتطفّلين في ساحته، وهي شكوى لا تكاد تنقطع على مرّ الأدهار، ويكفي أنْ يشار هنا، على سبيل التمثيل، إلى قولِ الآمدي: «... ثم إنَّ العلم بالشعر قد خصَّ بأن يدّعيه كلّ أحدٍ، وأنْ يتعاطاه مَنْ ليس من أهله، فلم لا يدّعي أحد هؤلاء المعرفة بالعين والورق والخيل والسلاح والرقيق والبزّ والطيب وأنواعه؟ ولعلّه قد لابس من أمر الخيل وركوبها والسلاح والعلم بذلك أو الرقيق واقتنائه أو الثياب ولبسها أو الطيب واستعماله، أكثر مما عاناه من أمر الشعر وروايته، فلا يتِّهم نفسَه في المعرفة بالشعر تهمته إياها بالمعرفة ببعض هذه الأشياء مما عاناه وتناوله»([4]). وكذلك إلى قول ابن الأثير: «ومن أعجب الأشياء أني لا أرى إلا طامعاً في هذا الفنّ، مدّعياً له على خلوّه من تحصيل آلته وأسبابه... فسبحان الله! هل يدّعي بعضُ هؤلاء أنه فقيه، أو طبيبٌ، أو حاسبٌ، أو غير ذلك، من غير أنْ يحصّل آلاتِ ذلك، ويتقن معرفتها؟ فإذا كان العلم الواحد من هذه العلوم الذي يمكن تحصيله في سنةٍ أو سنتين من الزمان لا يدّعيه أحدٌ من هؤلاء، فكيف يجيء إلى فنّ الكتابة، وهو ما لا تحصل معرفته إلا في سنين كثيرةٍ، فيدّعيه، وهو جاهلٌ به؟»([5]).
وها هنا يأتي حديثُ النقّاد، أوّلَ بدءٍ، عن ضرورة وجود ما يسمّى (الطبع أو الذوق)، أي هذه القوّة الخفيّة التي تكون سبباً في اختيار الإنسان لهذا الفنّ دون سواه من الفنون الأخرى، فينصرف إليه انصرافاً تامّاً، ويشغل به العمرَ كلّه، دون أنْ يكون ثمّة تفسيرٌ لذلك، إذ كان اختياراً بلا وعيٍ منه أو إرادةٍ، لأنه يرتدّ إلى تلك القوّة المستكنّة في أصل خلقه، المسؤولة عن توجيهه الوجهةَ المناسبة، فإنْ خالف وأبى إلا سواها، لم يكنْ مصيره إلا الإخفاق والنّدم.
ولعلَّ هذا ما أومأ إليه الجاحظ في قوله: «وقد يكون الرجلُ له طببعةٌ في الحساب وليس له طبيعةٌ في الكلام، وتكون له طبيعةٌ في التجارة وليست له طبيعةٌ في الفلاحة، وتكون له طبيعةٌ في الحداء أو في التغبير، أو في القراءة بالألحان، وليست له طبيعةٌ في الغناء، وإنْ كانت هذه الأنواعُ كلّها ترجع إلى تأليف اللحون، وتكون له طبيعةٌ في الناي وليس له طبيعةٌ في السُّرْناي، وتكون له طبيعةٌ في قصبة الراعي ولا تكون له طبيعةٌ في القصبتين المضمومتين، ويكون له طبعٌ في صناعة اللحون ولا يكون له طبع في [غيرها]، ويكون له طبعٌ في تأليف الرسائل والخطب والأسجاع ولا يكون له طبعٌ في قرض بيت شعرٍ، ومثل هذا كثيرٌ جداً، وكان عبد الحميد الأكبر، وابن المقفّع، مع بلاغة أقلامهما وألسنتهما، لا يستطيعان من الشعر إلا ما لا يُذكر مثلُه»([6]).
وظاهرٌ أنَّ الناس في ذلك ليسوا على حدّ شَرَعٍ، بل هم يختلفون اختلافاً كبيراً، فليس بمكْنة كلّ أحدٍ أنْ يكون شاعراً أو ناقداً، لأنه يفتقرُ أولّ ما يفتقرُ إلى وجود هذه الموهبة أو الحاسّة الفطريّة التي تجعله ينحرف انحرافاً إلى ميدان الشعر أو النقد دون غيره من الميادين الأخرى، وهي حاسّة لا تأتي بالتعلّم، مهما اجتهد المرءُ في محاولة ذلك، لأنها تنشأ مع هذا الإنسان الذي نسمّيه (شاعراً أو ناقداً) منذ البدئية. يقول ابن سنان الخفاجي: «... ولهذا لا يمكن أحد أنْ يعلّم الشعر مَنْ لا طبع له، وإنْ اجتهد في ذلك، لأنَّ الآلة التي يتوصّل بها غير مقدورةٍ لمخلوقٍ، ويمكن تعلّم سائر الصناعات لوجود كلّ ما يحتاج إليه من آلاتها»([7]). ويقول عبد القاهر الجرجاني، في معرض حديثه عن بلاغة النظم: «وكما لا تقيم الشعر في نفس مَنْ لا ذوق له، كذلك لا تفهم هذا الشأن مَنْ لم يؤت الآلة التي بها يفهم»([8]).
وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنفُ هذه الحاسّة وآليّة عملها، فإنها تعدّ عنصراً أساسياً في استبانةِ الشعر ونقده، والوقوف على خصائص تأليفه، وأسباب حسنه، ووسائل تأثيره وإدهاشه، وخاصّةً عندما ينطوي الكلامُ على «أمورٍ خفيّةٍ، ومعانٍ روحانيّةٍ، فأنت لا تستطيع أنْ تنبّه السامع لها، وتحدث له علماً بها، حتى يكون مهيئاً لإدراكها، وتكون فيه طبيعةٌ قابلة لها، ويكون له ذوقٌ وقريحةٌ يجد لهما في نفسه إحساساً بأنَّ من شأن هذه الوجوه والفروق أنْ تعرض فيها المزيّة على الجملة، ومَنْ إذا تصفّح الكلام وتدبّر الشعر، فرّق بين موقع شيءٍ منها وشيءٍ»([9]).
والواقع أنَّ أغلبَ حديث المتقدّمين عن/ الطبع أو الذوق، إنّما ينصرفُ إلى مفهوم الذوق/ المثقّف، الذي نمّته المعرفة، وأرهفته الخبرة وطول الملابسة، أي (ذوق العالم المتخصّص)، الذي أطال الاعتكاف في محراب فنّه، فسبر أغواره، وعرف أسراره، ووقف على دقائقه، يقول ابن سلام الجمحي، فيما يسوقة من الأمثلة الموضّحة: «ويقال للرجل والمرأة، في القراءة والغناء: إنه لنديّ الحلق، طلّ الصوت، طويل النفس، مصيبٌ للحس - ويوصف الآخر بهذه الصفة، وبينهما بونٌ بعيدٌ، يعرف ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع له، بلا صفةٍ ينتهي إليها، ولا علمٍ يوقف عليه – وإنْ كثرة المدارسة لتعدي على العلم به، فكذلك الشعر يعلمه أهلُ العلم به...، وقال قائلٌ لخلف: إذا سمعت أنا بالشعر أستحسنه، فما أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك. قال: إذا أخذت درهماً فاستحسنته، فقال لك الصرّاف: إنه رديءٌ! فهل ينفعك استحسانك إياه»([10]).
ونحن نجد صدى هذا الكلام، الذي يقوله ابن سلاّم، يتردَّد عند غير واحدٍ من النقّاد، حيث يضربون الأمثال ويسوقون الأخبار الكثيرة، الدالّة على أهميّة حاسّة/ الطبع أو الذوق، ودورها الفاعل في تمييز جيّد الشعر من رديئه، والكشف عن ملامحه المميّزة، الظاهرة منها والخفّية، وخاصّةً عندما تقترنُ هذه الحاسّة بالمعرفة العميقة، والخبرة الواسعة، والدّربة الطويلة. يقول الآمدي، على سبيل التمثيل: «... وكذلك الجاريتان البارعتان في الجمال، المتقاربتان في الوصف... قد يفرّق بينهما العالم بأمر الرقيق، حتى يجعل بينهما في الثمن فضلاً كبيراً، فإذا قيل له وللنخّاس: من أين فضّلت أنت هذه الجارية على أختها؟... لم يقدرْ على عبارةٍ توضّح الفرق بينهما، وإنما يعرفه كلّ واحدٍ منهما بطبعه، وكثرة دُرْبته، وطول ملابسته. فكذلك الشعر: قد يتقارب البيتان الجيّدان النادران، فيعلم أهلُ العلم بصناعة الشعر أيّهما أجود إنْ كان معناهما واحداً، أو أيّهما أجود في معناه إنْ كان معناهما مختلفاً»([11]). ثم يقول غبّ ذلك: «فمن سبيل مَنْ عرف بكثرة النظر في الشعر والارتياض فيه وطول الملابسة له أن يُقضى له بالعالم بالشعر والمعرفة بأغراضه، وأنْ يسلم له الحكم فيه، ويُقبل منه ما يقوله، ويعمل على ما يمثله، ولا ينازع في شيء من ذلك، إذ كان من الواجب أن يُسلّم لأهل كلّ صناعةٍ صناعتهم، ولا يخاصمهم فيها، ولا ينازعهم إلا مَنْ كان مثلهم في الخبرة وطول الدّربة والملابسة، فإنه ليس في وسع كلّ أحدٍ أنْ يجعلك أيها السائل...، في العلم بصناعته كنفسه...، لأنَّ ما لا يدرك إلاّ على طول الزّمان ومرور الأيام، لا يجوز أنْ تحيطَ به في ساعةٍ من نهارٍ»([12]).
وليس يخفى هاهنا تأكيدهمْ مسألةً في غاية الأهمية، وهي أنَّ للشعر علماءه أو نقاده، وأنَّ هؤلاءِ هم المعوّل عليهمْ وحدهمْ في صناعته، وما يفتي في شأنها، إذ «لا معرّج على ما يقوله في الشيء مَنْ لا يعرفه، ولا التفات إلى رأيه فيه، فإنَّما يطلب الشيء من أهله، وإنّما يقبل رأي المرء فيما يعرفه»([13]). أما كيف يصل المرء إلى هذه الرتبة، أو يكتسب هذه الصفة، (صفة العالم بالشعر أو الناقد)، فإنهم يؤكّدون دوماً أنَّ الأمرَ ليس سهلاً، كما يظنّ أوّل وَهْلَةٍ، إذ لا بدّ، أوّل كلّ شيءٍ، من وجود حاسّة/ الطبع أو الذوق، ثمّ لا بدّ بعد ذلك من توفّره على فنّ الشعر، وإخلاصه له، بحيث يطيلُ ملابسته، ولا يملّ تأمّله وتقليبه ودراسته، «لأنَّ العلم، أيَّ نوعٍ كان، لا يدركه طالبه إلا بالانقطاع إليه، والإكباب عليه، والجدّ فيه، والحرص على معرفة أسراره وغوامضه، ثمّ قد يتأتّى جنسٌ من العلوم لطالبه ويتسهّل عليه، ويمتنع عليه جنسٌ آخر ويتعذّر، لأنَّ كلَّ امرىءٍ إنّما يتيسّر له ما في طبعه قبوله، وما في طاقته تعلّمه»([14]).
ومن هنا، نلحظُ أنَّ صفة (العالم بالشعر)، إنما تنصرفُ إلى (الشاعر، والناقد)، على وجه التحديد، لأنَّ كلاًّ منهما لديه هذه الحاسّةُ الفطريّة، حاسّة/الطبع أو الذوق، كما أنَّ فنّ الشعر هو ميدانه الأول، ميدان اهتمامه واشتغاله وخبرته...، فإذا كان عمل الشاعر هو (الإبانة) بالشعر، فإنَّ عمل الناقد هو (استبانة) هذا الشعر، ولذلك كثيراً ما يمتزج العملان، سواء لدى الشاعر نفسه أو لدى الناقد، كما أننا لا نكاد نجد شاعراً إلّا وله مشاركاتٌ وخطراتٌ في النقد، سواء على مستوى النظرية أو التطبيق، مثلما لا نكاد نجد ناقداً أيضاً إلاّ وله مشاركاتٌ ومعالجاتٌ شعرية، وإن كان الشاعر، في نهاية المطاف، هو مَنْ غلب عليه قول الشعر واشتهر به، والناقد مَنْ غَلَب عليه مزاولة العمل النقديّ واشتهر بذلك...، ومهما يكنْ، فإنَّ من شأن هذا كلّه أنْ يكشف عن مدى انتحاء الشاعر على البعد النقديّ في أثناء العمليّة الإبداعيةّ، وأيضاً عن مدى استعانة الناقد بخبرته الشعريّة أثناء تلقّيه النصّ الشعريّ وقراءته النقديّة.
وفي ضوء ذلك، نرى المتقدّمين يميّزون بين شيئين: بين نقّاد الشعر من جهةٍ، وشرّاحه وممَّن يُعنون بآلته من نحوٍ وصرفٍ وغريبٍ...، دون الغوص إلى أعماق البيان الشعريّ، والوقوف على سماته الفنيّة والجماليّة من جهةٍ أخرى . وفي هذا نطالع: «وأهل صناعة الشعر أبصرُ به من العلماء بآلته من نحوٍ وغريبٍ ومثلٍ وخبرٍ وما أشبه ذلك، ولو كانوا دونهم بدرجاتٍ، وكيف وإن قاربوهمْ أو كانوا منهم بسببٍ، وقد كان أبو عمرو بن العلاء وأصحابه لا يجرون مع خلف الأحمر في حلبة هذه الصناعة، أعني النقد، ولا يشقّون له غباراً، لنفاذه فيها، وحِذقه بها، وإجادته لها»([15]).
ولا شكَّ أنَّ هذه النظرة إلى علماء النحو واللغة ترجعُ إلى افتقار كثيرٍ منهم إلى حاسّة/ الطبع أو الذوق، التي تأتي في طليعة ما يشترط وجوده فيمنْ يريد أنْ يشتغل بدراسة الشعر ونقده، لأنه «إذا لم يكنْ ثَمَّ طبعٌ، فإنه لا تغني تلك الآلات شيئاً، ومثال ذلك كمثل النار في الزناد، والحديدة التي يقدح بها، ألا ترى أنه إذا لم يكنْ في الزناد نارٌ لا تفيد تلك الحديدة شيئاً»([16]). فهذه الحاسّة الفطرية هي التي تجعلُ عمل الناقد أقربَ إلى خصوصيّة الخطاب الشعريّ، وأبعد إيغالاً في زوايا صنعته الفنية وخفاياها، إذ كان البحث في لغة الشعر، لا يتوقّف عند حدود السلامة النحوية واللغوية وما إلى ذلك، فلا جَرَمَ هذا أمرٌ بديهيّ، وإلاّ سقط النصّ الشعريّ مرّةً واحدةً، لما يصيب بنيانه من اضطرابٍ وفسادٍ، وإنما هو يتعدّى ذلك إلى ما هو أبعد بكثيرٍ، مما يتصل بأسلوب الشاعر واختياراته، وطرائق تعبيره، ووسائله الإيحائية والتأثيرية، «فالشاعر لم ينظمْ شعره وغرضُه منه رفع الفاعل ونصب المفعول أو ما جرى مجراهما، وإنما غرضه إيرادُ المعنى الحسن في اللفظِ الحسن المتصفينِ بصفة الفصاحة والبلاغة... فليس الغرض من نظم الشعر إقامة إعرابِ كلماته، وإنما الغرض أمرٌ وراء ذلك»([17]). ومن هنا نراهم يؤكدون دوماً «أنَّ نقدَ الشعر صناعةٌ لا يعرفها حقَّ معرفتها إلاّ مَنْ قد دفع إلى مضايقِ القريض، وتجرّع غصصَ اعتياصه عليه، وعرف كيف يتقحّم مهاويه، ويترامى إليه»([18]).
وإذاً، لا بدّ من اجتماع (الذوق والمعرفة) في آنٍ، لأنَّ اجتماعهما هو الذي يؤهّل الإنسان، ليكون (عالماً بالشعر أو ناقداً)، ولا ريب أنَّ هذا من الصعوبة بمكانٍ، وقد سلفت الإشارة قبل هنيهةٍ إلى أنَّ حاسّة/ الطبع أو الذوق لا يد للإنسان في إيجادها، إذ كانت منحةً ربانيّةً، يختصّ بها بعض النّاس، وهم قلّةٌ نادرةٌ في كلّ زمانٍ، أما الآلات والمعارف التي ينبغي أنْ يحصّلها، فهي من الكثرة والتنوّع، بحيث لا يطيقُ ذلك إلاّ أولو العزم من النقّاد.
ويكفي أنْ يشار هنا إلى متطلبّات العمليّة الإبداعيّة نفسها، وما ألزموا الشاعرَ أنْ يتعلمّه ويتقنه، ليكون شاعراً مجلّياً في مضمار صنعته . يقول ابن طباطبا، على سبيل التمثيل: «وللشعر أدواتٌ يجب إعدادها قبل مراسه وتكلّف نظمه، فمنْ تعصّت عليه أداةٌ من أدواته، لم يكملْ له ما يتكلّفه منه، وبان الخللُ فيما ينظمه، ولحقته العيوبُ من كلّ جهةٍ، فمنها: التوسّع في علم اللغة، والبراعة في فهم الإعراب، والرواية لفنون الآداب، والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم، ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر، والتصرف في معانيه، في كلّ فنّ قالته العرب فيه، وسلك مناهجها في صفاتها ومخاطباتها وأمثالها، والسّنن المستدلّة... وإيفاء كلّ معنى حظّه من العبارة، وإلباسه ما يشاكله من الألفاظ، حتى يبرز في أحسن زيّ، وأبهى صورة..، وجماع هذه الأدوات: كمال العقل الذي به تتميّز الأضداد، ولزوم العدل، وإيثار الحسن، واجتناب القبيح، ووضع الأشياء في مواضعها»([19]).
ويذهبُ ابنُ رشيقٍ في هذا الموضوع إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث يقول: «والشاعر مأخوذٌ بكلّ علمٍ مطلوبٌ بكلّ مكرمةٍ، لاتساع الشعر واحتماله كلّ ما حمّل من نحوٍ ولغةٍ وفقهٍ وخبرٍ وحسابٍ وفريضة... وليأخذ نفسه بحفظ الشعر والخبر ومعرفة النّسب وأيام العرب، ليستعمل بعض ذلك فيما يريده من ذكر الآثار وضرب الأمثال، وليعلق بنفسه بعض أنفاسهم، ويقوّي طبعه بقوّة طباعهم، فقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدِّمين يفضل أصحابه برواية الشعر ومعرفة الأخبار والتملذة بمن فوقه من الشعراء، فيقولون: فلانٌ شاعرٌ راويةٌ، يريدون أنه إذا كان مطبوعاً لا علم له ولا رواية ضلّ واهتدى، من حيث لا يعلم، وربّما طلب المعنى، فلم يصلْ إليه، وهو ماثلٌ بين يديه، لضعف آلته، كالمُقْعَد يجد في نفسه القوّة على النهوض فلا تعينه الآلة...، ولا يستغني المولّد عن تصفّح أشعار المولّدين، لما فيها من حلاوة اللفظ وقرب المأخذ وإشارات الملح ووجوه البديع الذي مثله في شعر المتقدِّمين قليلٌ، وإنْ كانوا هم فتحوا بابه، وفتقوا جلبابه»([20]).
ويقول ابنُ سنان، في «سرّ الفصاحة»، فيما عقده تحت عنوان «ما يحتاج مؤلّف الكلام إلى المعرفة به»، خاتماً به كتابه: «وبالجملة، إنَّ مؤلّف الكلام لو عَرَفَ حقيقة كلّ علمٍ، واطلع على كلّ صناعةٍ، لأثّر ذلك في تأليفه ومعانيه وألفاظه، لأنه يدفع إلى أشياء يصفها، فإذا خبر كلّ شيءٍ وتحقّقه، كان وصفه له أسهل، ونعته أمكن، إلاّ أنَّ المقصود في هذا الموضع بيان ما لا يسعه جهلُه، دون ما إذا علمه أثّر عنده علمه، فإنَّ ذلك لا يقف على غايةٍ»([21]).
وقد خصَّص ابنُ الأثير في مقدّمة «المثل السائر» فصلاً كاملاً لما يحتاجُ إليه الأديب من آلاتٍ وأدواتٍ، فذكر من ذلك ثمانية أنواعٍ، جعلها كالأصل لما يجبُ إتقان معرفته، ثمَّ أعقب ذلك بذكر فائدةِ كلّ نوعٍ من هذه الأنواع، ليدلّ على أهميّته وأنَّ معرفته مما تمسّ الحاجةُ إليه، وهو يختتمُ هذه الفصل بقوله: «وبالجملة فإنَّ صاحبَ هذه الصناعة يحتاج إلى التشبّث بكلّ فنّ من الفنون، حتى إنه يحتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النّساء، والماشطة عند جلوة العروس، وإلى ما يقوله المنادي في السوق على السلعة، فما ظنك بما فوق هذا؟ والسّبب في ذلك أنَّه مؤهّلٌ لأنْ يهيم في كلّ وادٍ، فيحتاج أنْ يتعلّق بكلّ فنّ»([22]).
ويربطُ كثيرٌ من النقّاد بين القدرة الموسيقيّة لدى الشاعر، وحاسّة/ الطبع أو الذوق، التي تعدّ أساس الشاعريّة، ويبدو أنهم يعتبرون هذه القدرة جزءاً من عمل الحاسّة الفطريّة، لاختصاص الشعر بعنصر النظم تحديداً، ولذلك لا يرون تعلّم العروض أمراً واجباً لا بدّ منه، بل يشترطون ذلك على الشاعر في حالةٍ واحدةٍ، عند اضطراب السليقة عليه، لأنَّ الإنسان إذا لم يرزق هذه الحاسّة الفطرية، فإنه لا يمكن أنْ يفلحَ في هذه الصناعة، وليس أدلّ على ذلك من اعتقادهم أنَّ معرفة العروض أو غيره من الآلات والعلوم، كالنحو والصرف والغريب...، كلّ ذلك لا يصنع شاعراً كبيراً، مع غياب هذه الحاسة الضروريّة، كما هو شأن كثيرٍ من اللغويين والعلماء، كالخليل وسيبويه ومن كان على شاكلتهما.
وفي هذا يقول ابن طباطبا: «فمنْ صحَّ طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعَروض التي هي ميزانه، ومن [اضطرب] عليه الذوق لم يستغنِ من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العَروض والحِذْق به، حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلّف معه»([26]).
ويذهب ابن رشيقٍ إلى أنَّ المطبوع من الشعراء «مستغنٍ بطبعه عن معرفة الأوزان وأسمائها وعللها، لنبوّ ذوقه عن المزاحف منها والمستكره، والضعيف الطبع محتاجٌ إلى معرفة شيءٍ من ذلك يعينه على ما يحاوله من هذا الشأن»([27]). ويؤكد ذلك ابن الأثير، في سياق حديثه عن الآلات والمعارف الضروريّة التي لا بدّ أنْ يكون الشاعر عارفاً بها، حيث يقول: «وأما النوع الثامن، وهو ما يختصّ بالناظم دون الناثر، وذلك معرفة العَروض وما يجوز فيه من الزّحاف وما لا يجوز – فإنَّ الشاعر محتاجٌ إليه، ولسنا نوجب عليه المعرفة بذلك لينظم بعلمه، فإنَّ النظم مبنيّ على الذوق...، وإنما أريد للشاعر معرفة العَروض، لأنَّ الذوق قد ينبو عن بعض الزحافات، ويكون ذلك جائزاً في العَروض، وقد ورد للعرب مثله، فإذا كان الشاعر غير عالمٍ به لم يفرّق بين ما يجوز من ذلك وما لا يجوز»([28]).
ومهما يكنْ، فإننا نلحظ مدى المشقّة التي يمكن أنْ يعانيها الشاعر والناقد، على حدّ سواء، إذ كان المعوّل عليه عندهم، في شأن العلم بالشعر ونقده، هو الطبع أو الذوق/ المثقف، القادر على تمييز الكلام جيّده من رديئه، ومحموده من مذمومه، وبيان العلل والأسباب الموجبة لهذا الحكم أو ذاك، إذ لا يكفي أنْ يظلّ عمل الناقد في إطار الأحكام الانطباعية، والعبارات الفضفاضة، بل لا بدّ أنْ يقوم عمله على تفصيل القول، والتعليل والتدليل..، وهذا لا يتحقق إلاّ بالوقوف على أصول هذا الفنّ، والتعلّم الطويل، وكثرة التأمّل والمدارسة . يقول الآمدي: «وبعدُ، فإني أدلّك على ما ينتهي بك إلى البصيرة والعلم بأمر نفسك في معرفتك بأمر هذه الصناعة أو الجهل بها، وهو أن تنظر ما أجمع عليه الأئمة في علم الشعر من تفضيل بعض الشعراء على بعضٍ، فإن عرفت علّة ذلك، فقد علمتَ، وإنْ لم تعرفها، فقد جهلت..، فإنْ قلتَ: إنك قد انتهى بك التأمّلُ إلى علم ما علموه، لم يقبلْ ذلك منك حتى تذكر العِلل والأسباب، فإنْ لم تقدرْ على تلخيص العبارة عن ذلك، حتى تعلم شواهد ذلك من فهمك ودلائله من اختياراتك وتمييزك بين الجيّد والرديء»([29]).
وهذا الذي يقوله الآمدي، نجده يتكرّر، ويتراحب ويتضح أكثر، عند غير قليلٍ ممن أتوا بعده، ولا سيّما عبد القاهر الجرجاني، الذي يلحّ على تأكيد ذلك. ويذهب إلى تشقيق القول فيه، ولعلَّ أوّل ما يحاول أن يؤكّده «أنك لنْ تعلم في شيءٍ من الصناعات علماً تُمرّ فيه وتُحلي، حتى تكون ممّن يعرف الخطأ من الصواب، ويفصل بين الإساءة والإحسان، بل حتى تفاضل بين الإحسان والإساءة، وتعرف طبقاتِ المحسنين»([30]). وبناءً على ذلك، فإنه «لا يكفي في علم (الفصاحة) أنْ تنصبَ لها قياساً ما، وأن تصفها وصفاً مجملاً، وتقول فيها قولاً مرسلاً، بل لا تكون من معرفتها في شيءٍ، حتى تفصل القول وتحصّل، وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم وتعدّها واحدةً واحدةً، وتسمّيها شيئاً شيئاً، وتكون معرفتك معرفة الصّنِع الحاذق»([31])، ثمّ يقول بعد ذلك: «وجملة ما أردتُ أنْ أبيّنه لك: أنه لا بدّ لكلّ كلامٍ تستحسنه، ولفظ تستجيده، من أن يكون لاستحسانك ذلك جهةٌ معلومةٌ، وعلّة معقولةٌ، وأنْ يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل، وعلى صحّة ما ادعيناه من ذلك دليلٌ»([32]).
ولستُ هناهنا بصدد البحث في هذا المنهج، أو الخوض في تفاصيله، والوقوف على تجلّياته النظرية والتطبيقية، إذ كان ذلك ليس من مقاصد هذه الورقة، وإنما جرى الإلماعُ إلى ذلك، لنتبيَّن هذه النقلة النوعيّة التي وصل إليها النقد العربيّ، وأنَّ الأمر لم يعدْ لقاءً آنيّاً سريعاً بين النصّ والقارئ، أو كلاماً يلقى على عواهنه، بل لا بدّ أنْ يستند إلى التحليل العميق، والبحث الدقيق، وذكر العلل والأسباب، وإيراد الأدلّة المقنعة – وهذا يعني أنَّ التصدّيَ لهذه المهمّة، من الأمور الصعبة، وأنه ليس بمقدور كلّ إنسانٍ، لما تتطلبّه من مؤهّلاتٍ وقدراتٍ، وآلاتٍ وأدواتٍ، وجهودٍ وأوقاتٍ.
لقد تطرّق عبد القاهر، في مواطنَ عديدةٍ، إلى بيان صفة الناقد الحقيقيّ، وطبيعة القراءة التي ينبغي أنْ يصل إليها، وهو يعالج البيان أو النصّ الشعريّ، وخاصّةً أنه كان يشاهد كثرة المتطفلّين، ومَنْ يتكلّمون ويتخوّضون في شأن النقد، وهم ليسوا أهلاً لذلك، بل يفتقرون إلى أبسط المؤهّلات والآلات، فالناقد الحقيقيّ الذي يعوّل عليه لا بدّ أنْ «يكون من أهل الذوق والمعرفة..، فأما مَنْ كان لا يتفقّد من أمر (النظم) إلّا الصحّة المطلقة، وإلاّ إعراباً ظاهراً، فما أقلّ ما يجدي الكلام معه، فليكنْ مَنْ هذه صفته عندك بمنزلة مَنْ عَدِم الإحساس بوزن الشعر، والذوق الذي يقيمه به، والطبع الذي يميّز صحيحه من مكسوره... – في أنك لا تتصدّى له، ولا تتكلّف تعريفه، لعلمك أنه قد عَدِم الأداة التي معها يعرف، والحاسّة التي بها يجد»([33]).
إنَّ العمليّة النقديّة لم تعدْ قراءةً سطحيّة، أو تعليقاً عابراً، أو وصفاً عاماً، دون بيانٍ أو برهانٍ، فهذا لا قيمة له، بل لا بدّ أنْ «تتجاوز حدّ العلم بالشيء مجملاً، إلى العلم به مفصّلاً، وحتى لا يقنعك إلاّ النظر في زواياه، والتغلغل في مكامنه، وحتى تكون كمن تتبّع الماءَ حتى عرف منبعه، ومجرى عروق الشجر الذي هو منه»([34]). ومن هنا كثيراً ما أكّد عبد القاهر أنَّ هذا المستوى من الممارسة النقديّة، يحتاج «إلى صبرٍ على التأمل، ومواظبةٍ على التدبّر، وإلى همّةٍ تأبى عليك أن تقنع إلاّ بالتمام، وأن تربع إلاّ بعد بلوغ الغاية»([35])، كما أنَّ الكلام لا يبوح لك بأسراره الفنية والجمالية، ويكشف لك عن خباياه وركائزه المضمونية، «حيث تسمع بأذنك، بل حيث تنظر بقلبك، وتستعين بفكرك، وتُعمل رويّتك، وتراجع عقلك، وتستنجد في الجملة فهمك»([36]).
وكذا الأمر عند حازم القرطاجني، فهو يلحّ على ضرورة اجتماع الذوق الصحيح والمعرفة العميقة بأصول صناعة الشعر وما انتهى إليه العلماء والمختصّون، حيث يرفض أن يكون الاعتماد على الطبع أو الذوق وحده، وذلك أنَّ الطباع قد «تستجيد الغثّ وتستغثّ الجيّد من الكلام ما لم تقمعْ بردّها إلى اعتبار الكلام بالقوانين البلاغية، فيعلم بذلك ما يحسن وما لا يحسن»([37]). وعليه، فإنَّ هذه الطباع تظلّ في مسيس الحاجة، إلى أنْ تقوّم، سواء من جهة تصحيح المعاني أو من جهة تصحيح الألفاظ المعبّرة عنها، «إذ لم تكن العرب تستغني بصحّة طباعها وجودة أفكارها عن تسديد طباعها وتقويمها باعتبار معاني الكلام بالقوانين المصحّحة لها، وجعلها ذلك علماً تتدارسه في أنديتها ويستدرك به بعضهم على بعضٍ وتبصير بعضهم بعضاً في ذلك»([38])، كما لم تكن كذلك «تستغني في قولها الشعر الذي هو بالحقيقة شعر ونظمها القصائد التي كان تسمّيها أسماط الدهور، عن التعليم والإرشاد إلى كيفيّات المباني التي يجب أنْ يوضع عليها الكلام، والتعريف بأنحاء التصرّف المستحسن في جميع ذلك، والتنبيه على الجهات التي منها يداخل الخلل المعاني، ويقع الفساد في تأليف الألفاظ والمعاني»([39]).
كما نجده في سياق آخر، يوجّه نقداً عنيفاً لمن يتولّج في غير ميدانه، ويفتي فيما لا علم له به، كما راح يفتي في شأن القريض، جماعةٌ من المتكلّمين، «لم يكنْ لهم علمٌ بالشعر، لا من جهة مزاولته، ولا من جهة الطرق الموصلة إلى معرفته...، والذي يورّطهم في هذا أنهم يحتاجون إلى الكلام في إعجاز القرآن، فيحتاجون إلى معرفة ماهيّة الفصاحة والبلاغة من غير أنْ يتقدّم لهم علمٌ بذلك، فيفزعون إلى مطالعة ما تيسّر لهم من كتب هذه الصناعة، فإذا فرّق أحدهم بين التجنيس والترديد، وماز الاستعارة من الإرداف، ظنَّ أنه قد حصل على شيءٍ من هذا العلم، فأخذ يتكلّم في الفصاحة بما هو محض الجهل بها»([41]).
إنَّ الشعر صناعةٌ لها خصوصيّتها، كما لها أربابها الألى انصرفتْ همّتهم إليها انصرافاً تاماً، حتى عرفوها حقّ المعرفة، ووقفوا على أدقّ تفاريقها وأسرارها، وهؤلاء هم الذين سمّوهم الخليل بن أحمد: «أمراء الكلام»([42])، لما يملكونه من سلطةٍ واقتدارٍ في هذا الشأن، وهؤلاء كذلك، فيما يقول حازم: «ليس ينبغي أنْ يعترض عليهم في أقاويلهم إلاّ مَنْ تُزاحم رتبته في حسن تأليف الكلام وإبداع النظام رتبتهم، فإنما يكون مقدار فضل التأليف على قدر فضل الطبع والمعرفة بالكلام، وليس كلّ مَنْ يدّعي المعرفة باللسان عارفاً به في الحقيقة... وإنما يعرفه العلماء بكلّ ما هو مقصودٌ فيه من جهة لفظٍ أو معنى، وهؤلاء هم البلغاء الذين لا معرّج لأرباب البصائر في إدراك حقائق الكلام إلاّ على ما أصّلوه، فمن جعل ذلك دليله، هدي سبيله»([43]).
وهكذا نلحظ عناية المتقدّمين بشخصيّة الناقد ومؤهّلاته، فإذا كان «ليس يجب أنْ يكون الإنسان شاعراً، ولا كاتباً، ولا صاحب كلامٍ يؤثر، ولفظٍ يروى»([44])، فإنه ليس يجب أنْ يكون ناقداً كذلك، فيتكلّم في صناعة الشعر، وهو ليس مؤهّلاً أو مختصّاً، إذ سرعان ما ينكشف جهله، وتتبدّى عوراته، كما هو الشأن في جميع الفنونِ والصناعات، وذلك أنَّ لكلّ صناعةٍ علماءها، الذين أخلصوا لها، وأفنوا أعمارهم في ميدانها، فهؤلاء هم وحدهم أصحاب الكلمة العليا، والحكم الذي يجب أن يتلقّاه الناس بالتسليم والرضى.
ومع تطوّر حركة النقد العربيّ القديم، كان تطوّر شخصيّة الناقد ومؤهّلاته، وبروزها على نحو أوضح، وهنا يمكن أنْ يشار، في تاريخ النقد الأدبيّ عند العرب، إلى مرحلتين بارزتين، هما: مرحلة النقد الذاتـيّ/ غير المعلّل، الذي نجده في النأنأة الأولى، وعصوره الباكرة، ثمّ مرحلة النقد الموضوعيّ/ المعلّل، الذي ظلّ النقّاد يدعون إليه، ويتطلّعون إلى تحقيقه، ويجتهدون في إرساء قواعده وأسسه.
فإذا كان النقد في مرحلته الأولى يعتمد اعتماداً كبيراً على الإحساس المجرّد، و الخبرة الفرديّة، مكتفياً بالنظرة الجزئيّة، والتعليق الخاطف، وإطلاق الأحكام العامّة، والأوصاف الجامعة، على شاكلة قولهم: هذا أشعر بيتٍ، وفلانٌ أشعر العرب، وهذه القصيدة «سمط الدهر»، إلى غير ذلك من أحكامٍ وآراء كان يطلقها أصحابها دون تعليقٍ واضحٍ أو مقنعٍ – فإنَّ النقد فيما بعد لم يعدْ يرضى بهذا المستوى، وخاصّةً بعد مرحلة تدوين النتاج الشعريّ والأدبيّ، وتأصيل العلوم، وامتزاج العرب بغيرهم من الأممِ والشعوب والثقافات، إذ أصبح معيباً أنْ لا يفيد الناقدُ من ذلك كلّه، لينعكس على تفكيره النقديّ، وقراءته للنصّ الشعريّ، كما صار مطلوباً من الناقد أنْ يكشف، في كلّ حكم يصدره أو رأي يقوله، عن العلل والأسباب التي دفعته إلى إصدار هذا الحكم أو بلورة ذاك الرأي، وهذا يعني أنَّ المسألة لا تتوقّف عند حدود الذوق الشخصيّ حسب، صحيحٌ أنَّ هذا الذوق هو ذوق شاعرٍ أو خبيرٍ بالشعر، إلاّ أنَّ هذا لم يعدْ كافياً، بل لا بدَّ من التعليل والتحليل، والاستناد إلى قواعد ومعاييرَ، واتباع منهجٍ لاحبٍ، وإلاّ ظلّ عمل الناقد عُرْضةً للغموض تارةً، ومسرحاً للفوضى تارةً أخرى.
إنَّ النقد الأدبيّ الفاعلَ، كما استتبَّ أخيراً في أذهان المتقدّمين، لا يعتمدُ على مجرّد الذوق، كما لا يعتمد على مجرّد المعارف والآلات، وإنما أساسه الرّكين هو الذوق المشحون بالثقافة الواسعة: الخاصّة والعامّة، الموروثة والحديثة، العربيّة وغير العربيّة، إذ بغير ذلك لا يستطيع الناقدُ أنْ يضوّئ أبعادَ النتاج الشعريّ، الموضوعيّة والفنيّة، وأنْ يؤدّي وظيفته على نحوٍ صحيحٍ، ليفيد منها المبدعُ والمتلقِّي، على حدّ سواء.
وقد كان لهذا الأساس دوره البارز، على امتداد العصور الأدبيّة، في تطوّر مسيرة النقد العربيّ، وتقديمِ أهمّ المقاربات المنهجيّة في محاولة فهم الحقيقة الأدبيّة، وقراءة النصّ الشعريّ، على وجهٍ التحديد، سواء أكانت هذه القراءة ترمي إلى فهمه وتفسيره أم إلى تقويمه من نواحيهِ المتعدّدة: اللغويّة والأسلوبيّة والجماليّة والتأثيريّة، وهنا يمكن الإلماع، على سبيل التمثيل، إلى منجزات عديدٍ من الهامات النقديّة، على ما بينها من تفاوتٍ، كابن سلاّم، والجاحظ، وابن قتيبة، وابن طباطبا، وقدامة بن جعفر، والأموي، والقاضي الجرجاني، وابن رشيق، وابن سنان الخفاجي، وعبد القاهر الجرجاني، وابن الأثير، وحازم القرطاجني.. وسواهم.
اقرأ المزيد من خلال رابط الملف
انقر هنا للوصول إلى صفحة الكتاب كاملاً.
انقر على الصورة للوصول إلى النسخة المصورة (pdf) قابلة للتحميل والنشر.
----------------------------------------------------
([1]) العمدة في صناعة الشعر ونقده، لأبي الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1983، ص:87.
([2]) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لأبي الفتح ضياء الدين ابن الأثير، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1939، ج1، ص:351.
([3]) منهاج البلغاء وسراج الأدباء، لأبي الحسن حازم القرطاجني، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط3، 1986، ص:88.
([4]) الموازنة بين أبي تمام والبحتريّ، للحسن بن بشر الآمدي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، ص:373.
([5]) المثل السائر، ج1، ص:351، وما بعدها.
([6]) البيان والتبيين، للجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، 1990، ج1، ص:208.
([7]) سرّ الفصاحة، لأبي محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، تحقيق: النبوي عبد الواحد شعلان، دار قباء، القاهرة، 2003، ص:126.
([8]) دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلَّق عليه: أبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1989، ص: 549.
([9]) نفسه، ص:547.
([10]) طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلاّم الجمحي، قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، السفر الأول، ص: 6، وما بعدها.
([11]) الموازنة، ص: 374.
([12]) نفسه، ص: 374، وما بعدها.
([13]) منهاج البلغاء، ص: 86.
([14]) الموازنة، ص:377، وما بعدها.
([15]) العمدة، ص: 87.
([16]) المثل السائر: ص:8.
([17]) نفسه، ص: 19.
([18]) نَضْرة الإغريض في نُصرة القريض، للمظفر بن الفضل العَلَوي، تحقيق: نهى عارف الحسن، دار صادر، بيروت، ط2، 1995، ص: 231، وما بعدها.
([19]) عيار الشعر، لابن طباطبا، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: عباس عبد الساتر، ط1، 1982، ص: 10، وما بعدها.
([20]) العمدة، ص: 140، وما بعدها.
([21]) سر الفصاحة، ص: 430، وما بعدها.
([22]) المثل السائر، ج1، ص: 31.
([23]) نفسه، ج1، ص: 351.
([24]) جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة، لأحمد زكيّ صفوت، المكتبة العلمية، بيروت، ج4، ص: 177.
([25]) العمدة، ص: 140.
([26]) عيار الشعر، ص: 9.
([27]) العمدة، ص: 99.
([28]) المثل السائر، ج1، ص: 31
([29]) الموازنة، ص: 376، وما بعدها.
([30]) دلائل الإعجاز، ص: 37.
([31]) نفسه، والصفحة ذاتها.
([32]) نفسه، ص: 41.
([33]) نفسه، ص: 291.
([34]) نفسه، ص: 26.
([35]) نفسه، ص: 37.
([36]) نفسه، ص: 64.
([37]) منهاج البلغاء، ص: 26.
([38]) نفسه، والصفحة ذاتها.
([39]) نفسه، ص: 27.
([40]) نفسه، والصفحة ذاتها.
([41]) نفسه، ص: 86، وما بعدها.
([42]) نفسه، ص: 143.
([43]) نفسه، ص: 144.
([44]) سرّ الفصاحة، ص: 94.
([45]) محمد غنيمي هلال، النقد الأدبيّ الحديث، دار الثقافة/ دار العمدة، بيروت، 1973.
([46]) نفسه، ص: 25، وما بعدها.
([47]) أحمد كمال زكي، النقد الأدبيّ الحديث: أصوله ومناهجه، دار النهضة العربية، بيروت، 1981، ص: 23.
([48]) نفسه، ص: 26، وما بعدها، وانظر: شكري عيّاد، دائرة الإبداع: مقدّمة في أصول النقد، دار الياس العصرية، القاهرة، 1986، ص:33، وما بعدها من الصفحات.
([49]) انظر: محمود محمد شاكر، المتنبي – رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، دار المدني بجدة، مكتب الخانجي بمصر، 1987، ص:8.
([50]) محمود محمد شاكر، المتنبي ليتني ما عرفته (3)، مجلة الثقافة المصرية، العدد 63، ديسمبر 1978، ص:15.