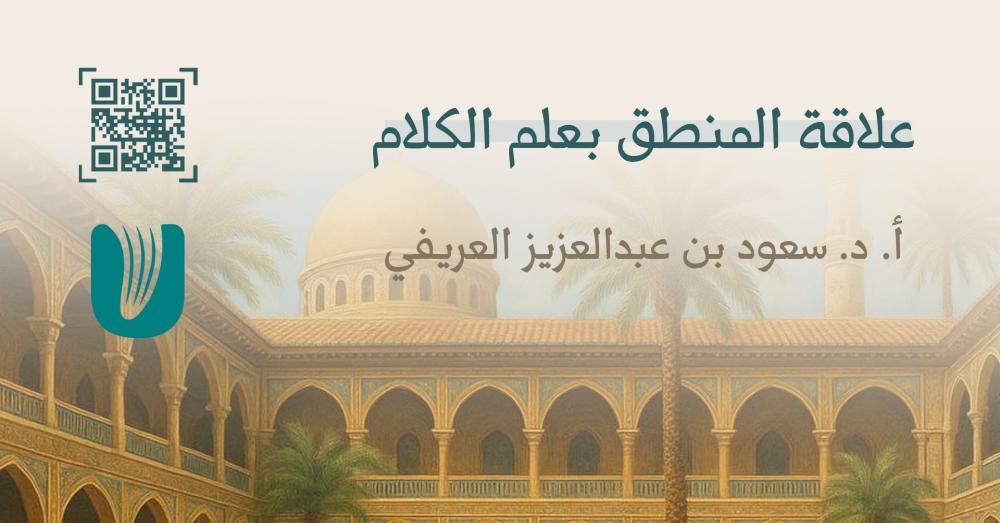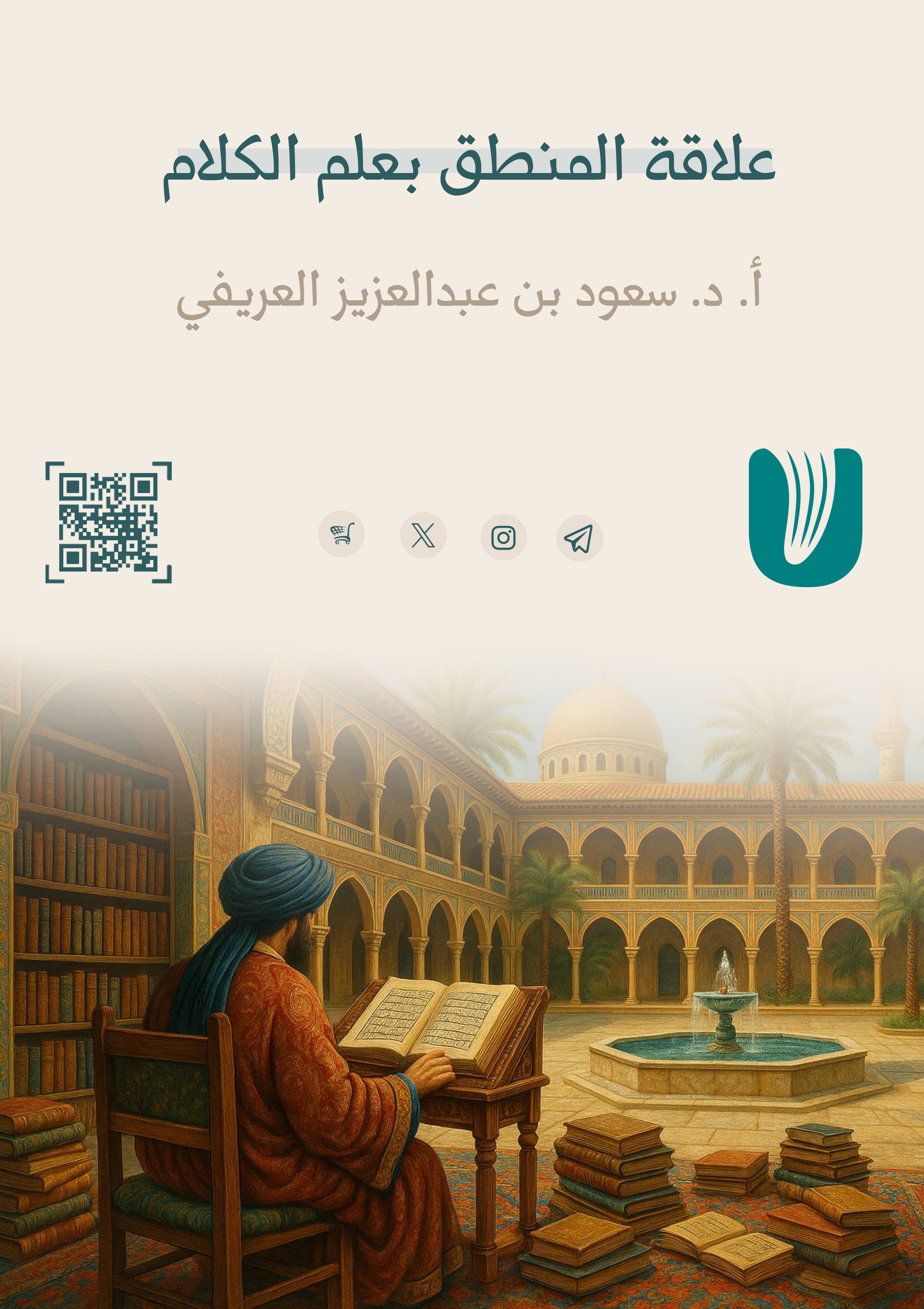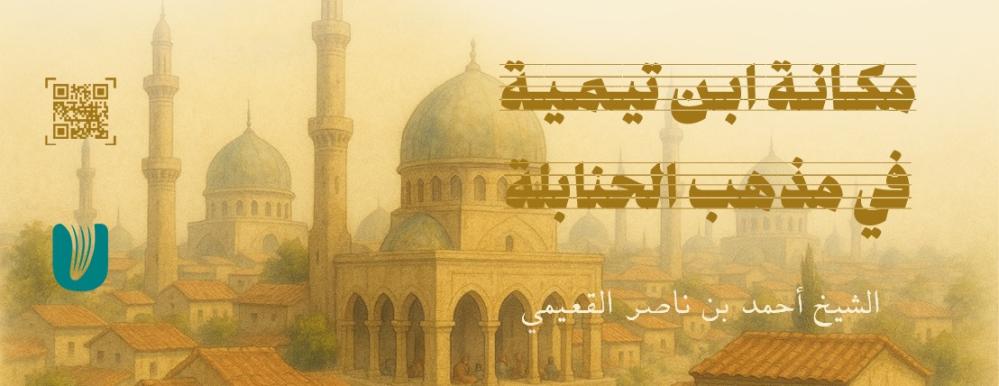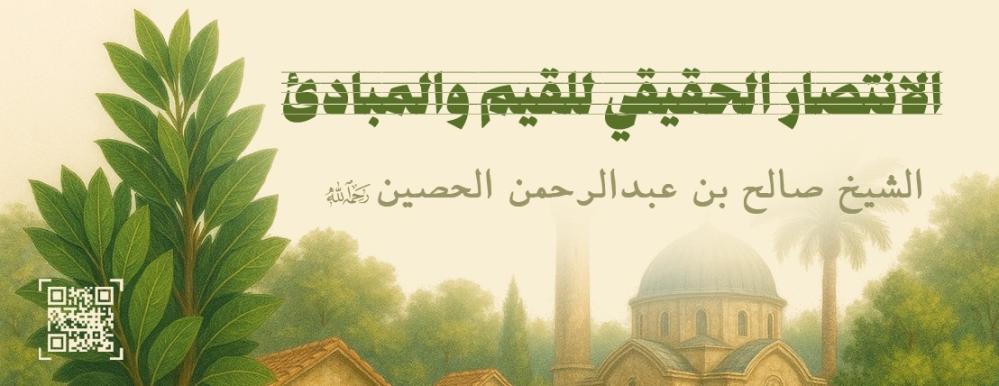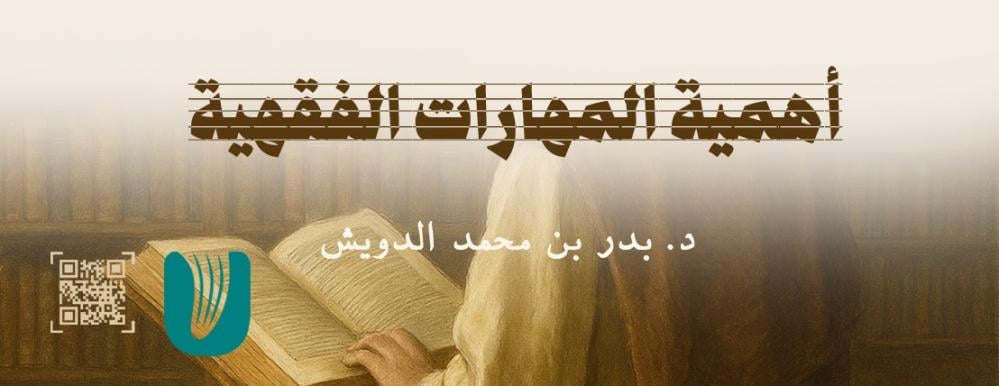علاقة المنطق بعلم الكلام
أ.د.سعود بن عبدالعزيز العريفي
يُطْلق علمُ الكلام على المسائل والموضوعات التي تناولها المتكلمون في العقائد، كما يُطْلق على المنهج الذي اعتمدوه في تقرير هذه المسائل وبحثها، كالتأويل وتقديم العقل عند التعارض مع النقل.
ومحصَّلُ تعريفات علم الكلام أنه "علم الاستدلال والدفاع العقلي عن العقيدة"[1]، ولهذا اعتبره بعض المتكلمين كالإيجيِّ (ت ٧٥٦هـ) والتَّفْتازاني (ت ٧٩٣هـ) والجُرجاني (ت ٨١٦هـ) للشرعيات كالمنطق للفلسفة[2]، أي: أن علم الكلام في نظرهم هو النسخةُ الإسلامية للمنطق؛ لما يتضمنه من مبادئ منهجية تُرتِّبُ النظرَ العقلي في تحقيق العقائد الدينية التي يقررها المتكلمون.
فالجامع بين العلمين إذن مصدريةُ العقل؛ فدلائلُ الكلام وحِجاجُه عقلي، والمنطق قواعد تضبِط هذا الاستدلال، حتى قيل: إن علم الكلام إنما سُمِّي كلامًا مضاهاةً للمنطق عند الفلاسفة؛ فالكلام والمنطق مترادفان[3].
وعلى هذا فإن علم الكلام في نظر أربابه ما هو سوى إعمال القواعد المنطقية في تعضيد العقائد الإيمانية؛ وهو ما يفسِّرُ عدم القطيعة التامة بين المنطق وقدماء نُقَّاده من المتكلمين؛ فاستدراكاتهم عليه إنما كانت من ناحية التكلف والتحكم والمجافاة للسان العربي، لا اعتراضًا على مبدأ محورية العقل في الاستدلال، وتقديمه على غيره من مصادر المعرفة، لذلك لم تَخْلُ مصنفاتُهم من المسائل والقواعد المنطقية[4].
لكن المنطق بعد ذلك أخذ في الرُّسوخ والاتساع في مصنفات من تلاهم من المتكلمين، كعبد الجبار المعتزلي (ت ٤١٥هـ) والجويني (ت ٤٧٨هـ) والغزالي (ت ٥٠٥هـ) ومن بعدهم، ثم توغَّل مع غيره من العلوم الفلسفية عند متأخريهم؛ كالرازي (ت ٦٠٦هـ) والبيضاوي (ت ٦٨٥هـ) حتى الْتَبَس علمُ الكلام بالفلسفة واختلطت مسائلهما[5]، و (حتى أصبحت القواعدُ والمقدمات المنطقية أحد أركان علم الكلام)[6].
وعلى هذا فالخلل لم يدخُلْ في علم الكلام من جهة صورة المنطق وقواعده الاستدلالية، بل من جهة شوائب المادة الفلسفية فيه؛ حيث كانت كتب الفلسفة محَطَّ أنظار المتكلمين بقصد الرد عليها، فلم يَسْلَموا من التأثر بها[7].
يقول ابن بدران الحنبلي (ت ١٣٤٦هـ): (إذا رأيت كتُبَ الذين يزعمون أنهم أشاعرةٌ رأيتهم على مذهب أرسطاطاليس ومن تبعه كابن سينا والفارابي، ورأيتَ كتبهم عنوانُها علمُ التوحيد وباطنُها النوع المسمَّى بالإلهي من الفلسفة)[8].
ويجدر التنبُّه إلى أن هذا التناظر المذكور بين المنطق والكلام لا ينفي الاختلافَ بينهما؛ فالمبادئ المنهجية لعلم الكلام لم تُفرَدْ بعلم مستقل عن موضوعات علم الكلام؛ كما هو شأن المنطق بالنسبة للفلسفة، وكما هو شأنُ أصول الفقه بالنسبة للفقه، وإنما نشأت هذه المبادئ متأخرةً على هيئة مقدمات لبعض الكتب الكلامية، كـ"شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبد الجبار، و"التمهيد" للباقلَّاني، كما أن المنهجَ الكلاميَّ في الاستدلال مرتبط بغاياته العقدية، مبنيٌّ عليها [9].
ويرى الغزالي أن الفلسفة لا تختصُّ بالمنطق إلا من ناحية التسمية؛ وإلا فالمنطق ليس إلا مبادئَ عقليةً فِطرية عامة تُعَدُّ أصلًا لكل علم صحيح؛ وهو ما يسمَّى في علم الكلام: "كتاب النظر"، أو "كتاب الجدل"، أو "مدارك العقول"[10].
وهو بهذا يوافق ابن حزم الذي أسلفنا قوله عن كتب أرسطو وتقريبه لحدودها: (ولْيَعلَمْ من قرأ كتابنا هذا أن منفعة هذه الكتب ليست في علم واحد فقط، بل في كل علم)[11].
ويقول ابن تيمية: (ما ذكره أهلُ المنطق من حصر طرق العلم يوجد نحوٌ منه في كلام متكلمي المسلمين، بل منهم من يذكره بعينه، إما بعباراتهم وإما بتغيير العبارة)[12].
والحاصل أن من يَرَوْن علم الكلام الوسيلةَ الوحيدة لمواجهة مخالفي العقائد الإيمانية: لا بُدَّ أن يجعلوا معرفة القواعد المنطقية مقدمةً أساسيةً وشرطًا منهجيًّا لضبط دفاعهم عن العقائد وضمان جدواه[13]، وعلى هذا مآخِذُ منها:
1- أنهم لا يَقْصُرون العقائدَ التي يوظفون المنطق في الدفاع عنها على ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون من التوحيد والإيمان بالآخرة، وما يتفرع على ذلك من تفاصيل العقائد، بل يُدْرِجون في عقائدهم ما يُضادُّ ما جاءت به الرسلُ من إثبات الصفات الإلهية والقضاء والقدر، فيُسَلِّطون التأويل على حقائقها بما يُضاهي التحريف في الأمم السابقة[14].
2- عدم التمييز بين القدْر الفِطْري من المنطق الذي يتفق عليه العقلاء عامة، وبين القَدْر المختلَف فيه مما اجتهد أرسطو وأتباعه في وضعه.
3- إغفال التطوُّر الحاصل في المدارس الكلامية، والتناقضات الأصولية بينها، رغم اتِّكائها جميعًا على القواعد المنطقية التي تعصم من الخطأ بزعمهم!
4- إهمال الخطاب العقلي الشرعي الوارد في القرآن والسنة، والنظرُ إليه بعين القُصور عن الوفاء بأغراض الدفاع عن العقائد الإيمانية[15].
___________
[1] انظر: وائل الحارثي، "علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق" ص ١٧٢.
[2] انظر: الإيجي (ت ٧٥٦هـ)، المواقف، ص ٨، الجرجاني (ت ٨١٦هـ)، شرح المواقف (١/٤٦)، التفتازاني (ت ٧٩٣هـ)، شرح المقاصد (١/١٦٤)، الحارثي، "علاقة أصول الفقه بعلم المنطق" ص ٢٠٠.
[3] انظر: الشهرستاني، الملل والنحل، (١/٣٠).
[4] انظر مثلًا: "المواقف في علم الكلام" للإيجي، ص ١١ وما بعدها. وانظر: وائل الحارثي، "علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق" ص ١٨٤، ١٨٦، ١٨٩، ١٩٠.
[5] انظر: ابن خلدون، "المقدمة"، (٣/١٠٨٢). صديق حسن خان، "أبجد العلوم"، (١/٤٨٥، ٤٨٦).
[6] وائل الحارثي، "علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق"، ص ٢٠٤.
[7] انظر: وائل الحارثي، "علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق"، ص ١٩٤.
[8] "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل"، ص ٤٩٦. تحقيق عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠١هـ، بيروت.
[9] انظر: وائل الحارثي، "علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق" ص ٢٠١. ومؤخرًا ظهرت دراسات منهجية متعددة تغطي هذا الجانب، مثل "المدخل لعلم الكلام" لحسن الشافعي، "منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة" لعثمان على حسن.
[10] انظر: أبو حامد الغزالي، "تهافت الفلاسفة، ص ٢٠٣.
[11] "التقريب لحد المنطق"، ضمن رسائله (٤/١٠٢).
[12] الرد على المنطقيين ٥٥٦.
[13] انظر مثلًا: أبوالحجاج المكلاتي (ت626هـ)، "لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول"، ص5،6. سعيد فودة، "تدعيم المنطق"، ص ٢٤، ٢٥.
[14] انظر: ابن القيم، "الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة"، (١/٣٤٨).
[15] انظر: سعود العريفي، "الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد"، ص ١٤٧ – ١٥٦.
انقر هنا للوصول إلى صفحة الكتاب كاملاً.
انقر على الصورة للوصول إلى النسخة المصورة (pdf) قابلة للتحميل والنشر.