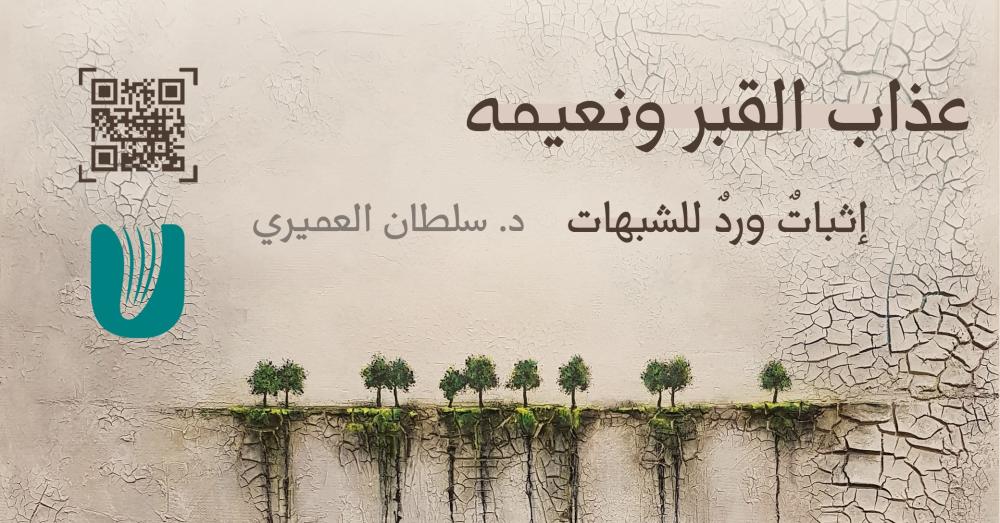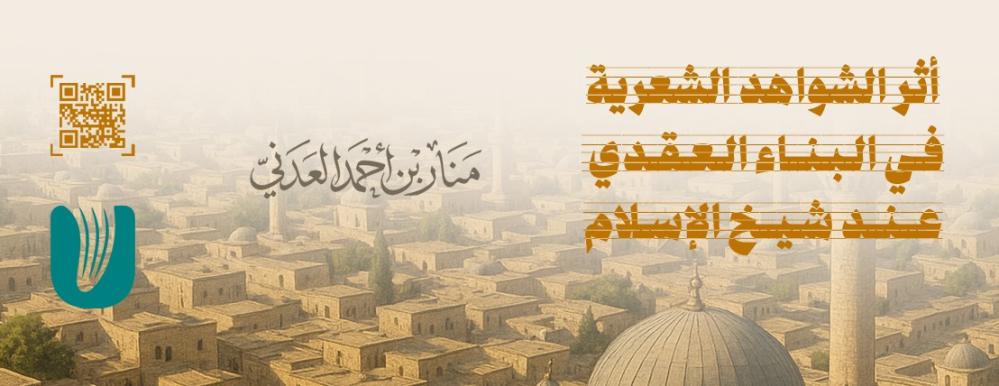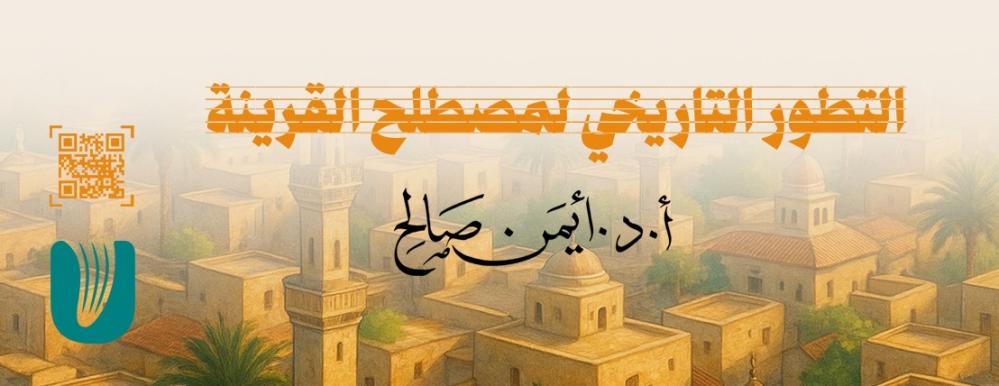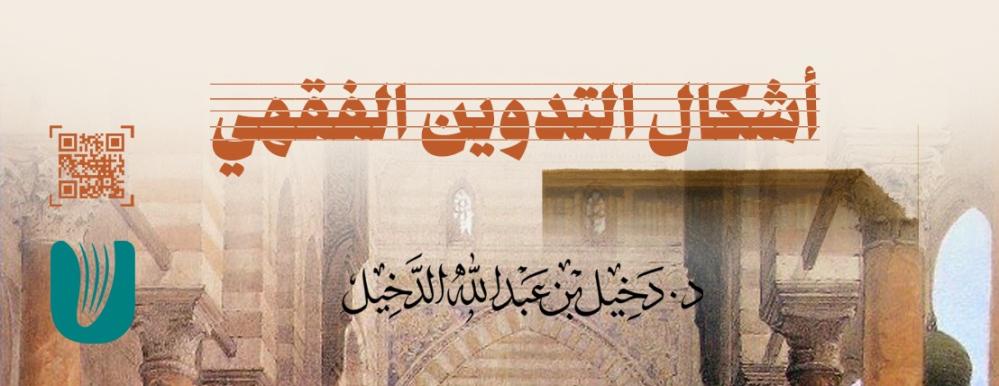عذاب القبر ونعيمه
"إثباتٌ وردٌ للشبهات"
د. سلطان بن عبدالرحمن العميري
يعتقد أهل السُّنَّة والجماعة وجمهور الأمة من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة أن عذاب القبر ونعيمه ثابت، وحقيقة من الحقائق.
وعذاب القبر قضية خبرية محضة لا دخل للعقل فيها، وقد دلَّ عليها القرآن والسُّنَّة المتواترة، إلا أن دلالة القرآن عليها ليست صريحةً، وليست قاطعةً، وثم دلالات كثيرة، ونصوص كثيرة، وآيات كثيرة من القرآن استدل بها العلماء، سنعرض عددًا منها، ونسبر دلالتها هل هي قاطعة أم أنها ظنية؟
الآية الأولى: قوله تعالى: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ *} [غافر: 46] ، فقد استدل بهذه الآية على عذاب القبر عدد من أئمة السلف؛ كمجاهد بن جبر، وعكرمة، ومقاتل، ومحمد بن كعب، والبخاري في «صحيحه»، وغيرهم، واعتمدوا على قوله: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ}؛ فالنار التي يعرضون عليها ليست هي عذاب الآخرة؛ إذ لو كان هو عذاب الآخرة لما صح أن يقال: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ *}.
الآية الثانية: قول الله سبحانه وتعالى: {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ *} [السجدة: 21] . وهذه الآية اختلف فيها أئمة السلف كثيرًا، فمنهم من قال: المراد بالعذاب الأدنى: مصائب الدنيا، ومنهم من قال: المراد بالعذاب الأدنى: الحدود التي تقام في الدنيا، ومنهم من قال: المراد بالعذاب الأدنى: القتل بالسيف، ومنهم من قال: المراد بالعذاب الأدنى: هو عذاب القبر، وهو قول مجاهد.
والأقرب في دلالة هذه الآية أنها ليست في عذاب القبر، مع اشتهار الاستدلال بها، يقول الطبري: «أولى الأقوال في ذلك أن يقال: إن الله وعد هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده في الدنيا العذاب الأدنى أن يذيقهم دون العذاب الأكبر، والعذاب: هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم، أو شدة من مجاعة أو قتل، أو مصائب يصابون بها، فكل ذلك من العذاب الأدنى»[(47)]، ولم يذكر عذاب القبر.
والآية دلَّت على أن المراد بها ليس عذاب القبر، وذلك في قوله: {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ *} فواضح من دلالته من تركيب الآية على أن المراد به: الرجوع والإنابة والتوبة، ومن مات لا يمكن أن يرجع.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ *} [الطور: 47] ، وقد اختلف أئمة السلف في تحديد العذاب الذي دون ذلك، فمنهم من قال: المراد به عذاب القبر، وهذا القول قاله البراء بن عازب، وابن عباس من الصحابة، ومنهم من قال: المراد به الجوع، ومنهم من قال: المراد به المصائب في الدنيا.
ورجح ابن جرير الطبري أن المراد بالعذاب الذي دون ذلك كل هذه الأمور، فيشمل عذاب القبر[(48)].
ولكن بناء على هذا الاختلاف فالآية ليست نصًّا قاطعًا في عذاب القبر، فلو لم تأت نصوص أخرى تثبت عذاب القبر؛ لما صح أن نثبت عذاب القبر بهذه الآية؛ لأنها لا دلالة فيها، وإنما حكمنا بالعموم لدلالات نصوص أخرى، فلو لم تأت تلك النصوص لما علمنا بعذاب القبر.
الآية الرابعة: قوله تعالى: {وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ *} [التوبة: 101] ، وقد اختلف العلماء في العذاب مرتين، فمنهم من قال: المراد بالعذاب الأول: السبي، والعذاب الثاني: عذاب القبر. ومنهم من قال: المراد بالعذاب الأول: المصائب، والعذاب الثاني: عذاب القبر. ومنهم من قال: المراد بالعذاب الأول: الحدود، والعذاب الثاني: القبر. وقيل غير ذلك.
والذي يتأمل في تفاسير أئمة السلف لهذه الآية يجد أنهم كادوا يُجمعون على أن العذاب الثاني هو عذاب القبر، وأما العذاب الأول فقد اختلفوا فيه كثيرًا، وممن ذكر أن العذاب الثاني هو عذاب القبر: ابن عباس من الصحابة، والسُّدِّي، ومجاهد، وقتادة، وغيرهم.
يقول الطبري: «أولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن الله أخبر أنه يعذب هؤلاء الذين مردوا على النفاق مرتين، ولم يضع لنا دليلاً نتوصل به إلى علم ذينك العذابين؛ وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنبأنا عنه ـ أي: الأقوال التي سبقت ـ وليس عندنا علم بأيِّ ذلك من أيٍّ، على أن في قوله تعالى: {ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ *} [التوبة: 101] دلالة على أن العذاب في المرتين كليهما قبل دخول النار، والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر»[(49)].
الآية الخامسة: قوله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ *} [الأنعام: 93] ، وهذه الآية استدل بها عدد من العلماء على إثبات عذاب القبر، منهم: البخاري، وابن رجب، وابن القيم.
وقد بيَّن ابن القيم وجه الدلالة منها، فقال: «هذا خطاب هذه الآية، خطاب لهم عند الموت، وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذٍ يجزون عذاب الهون عند موتهم، أو ما يقرب من موتهم، ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم: اليوم تجزون»[(50)].
الآية السادسة: قوله تعالى: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ *حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ *كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ *ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ *} [التكاثر: 1 ـ 4] ، وهذه الآية استدل بها عدد من أئمة السلف على عذاب القبر، فروي عن ابن عباس أنه قال: «كلا سوف تعلمون ما ينزل بكم من عذاب القبر»[(51)]، وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: «كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية»[(52)]. ولكن هذا الأثر ضعيف ضعفه عدد من العلماء.
يقول الطبري: «قوله: {حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ *} [التكاثر: 2] ؛ يعني: حتى صرتم إلى المقابر فدفنتم فيها؛ وفي هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر؛ لأن الله ـ تعالى ذكره ـ أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا القبور وعيدًا لهم وتهديدًا»[(53)].
فهذه الآية سيقت مساق الوعيد، والوعيد عُلق بالقبر؛ فدل على أنهم يتلقون عذابًا في القبر؛ فدلالتها ظاهرة؛ بل هي من أقوى الأدلة القرآنية على عذاب القبر.
الآية السابعة: قوله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى *} [طه: 124] ، وقد اختلف العلماء في تحديد المعيشة الضنك، فمنهم من قال: المراد بها الضيق في الدنيا، ومنهم من قال: المراد بها عذاب القبر، وممن قال بهذا القول أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، والسدي، واختاره الطبري وغيره.
أما دلالة السُّنَّة ، فقد تضافرت السُّنَّة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، والنصوص النبوية التي جاءت في هذه القضية بلغت حد التواتر، وحكم عليها بالتواتر: ابن تيميَّة، وابن القيم، وابن رجب، وابن أبي العز، وغيرهم[(54)]، ومن ذلك:
الحديث الأول: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقول: «اللَّهُمَّ أني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات» [(55)]، وفي هذا الحديث ذكرت الاستعاذة من عذاب القبر، ولم يذكر سؤال نعيم القبر.
الحديث الثاني: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر» [(56)].
ومنها النصوص التي جاءت في نعيم الشهداء والنعيم المتعلق بأرواح المؤمنين.
إشكاله ودفعه:
فإن قيل: يشكل على نعيم القبر ما جاء من أن الملك يقول للمؤمن في القبر بعد الامتحان: «نم صالحًا، فقد علمنا أن كنت لموقنًا»[(57)].
قيل: ذلك ليس مشكلاً؛ لأنه يمكن حمل هذا الحديث على أن المراد بالنوم مقدار يسير، أو حمله على نوم الجسد لا الروح.
* الموقف من عذاب القبر:
أنكر عدد من الطوائف عذاب القبر، ومن أشهرهم: الماديون قديمًا وحديثًا، وإنكارهم قائم على إنكارهم لكل الغيب، وأوردوا بعض الشبهات على عذاب القبر بخصوصه، منها:
الشبهة الأولى: أن المصلوب لا يرى عليه أثر التعذيب، فلو كان كافرًا يعذب بعد موته؛ لظهر أثر العذاب عليه، وكذلك لو كان المؤمن ينعم بعد موته لظهر ذلك عليه.
الشبهة الثانية: لو كشفنا القبر مباشرة بعد الدفن لما وجدنا الميت تغير عن حاله، والحديث فيه أنه يُقعد فيسأل.
وهذه الشبهات ليست جديدة، فقد عرفها علماء الإسلام قبل أكثر من ألف سنة، وذكرها القاضي عبد الجبار وابن القيم وغيرهم، وأجابوا عنها[(58)]، وحاصل الجواب: أن هذه الأسئلة كلها مبنية على قياس أحوال الآخرة والبرزخ على أحوال الدنيا، ونحن لا نقول بذلك، فلا يلزمنا الأخذ بتلك المعاني إلا إذا قلنا ما يحصل في القبر متفق في حقيقته مع ما يحصل في الدنيا، وهذا ليس قولنا؛ بل نحن نصرح بإنكاره.
والإيمان بالأشياء دون إدراك حقائقها ليس خاصًّا بالمؤمنين، فإن كثيرًا من الناس في علم الفلك وفي علوم أخرى يؤمنون بأشياء ويعرفون معانيها، ولكنهم لا يعرفون حقائقها.
والطريقة الصحيحة في مناقشة هؤلاء هو أن نرجعهم إلى الأصل الذي انطلقوا منه، وهو إنكار الغيب، ونثبت بطلانه؛ فإذا فعلنا ذلك سهُل حينئذ نقاشهم في هذه التفصيلات.
تنبيهٌ:
كثيرًا ما يُنسب إلى المعتزلة بجملتهم إنكار عذاب القبر، والصحيح: أن المعتزلة أجمعوا على إثبات عذاب القبر ونعيمه ولم ينكره إلا قليل منهم، يقول القاضي عبد الجبار: «فصل في عذاب القبر، وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة، إلا شيء يُنقل عن ضرار بن عمرو، وكان من أصحاب المعتزلة، ثم التحق بالْمُجَبِّرة، ولهذا ترى ابن الراوندي يُشنع علينا، ويقول: إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر، ولا يُقِرون به»[(59)]، ثم أخذ القاضي عبد الجبار يستدل على عذاب القبر ونعيمه، وقال أبو علي الجُبَّائي ـ وهو أحد أئمة المعتزلة الكبار ـ: «سألت الشحام ـ وهو أيضًا أحد أئمة المعتزلة ـ عن عذاب القبر فقال: ما منا من أحد ينكره، وإنما يحكى ذلك عن ضرار»[(60)].
وقد يشكل على هذا الكلام قول القاضي عبد الجبار: «أنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال؛ لأن الأخبار واردة بذلك في الجملة، فالذي يقال به هو قدر ما تقتضيه الأخبار دون ما زاد عليها، ولذلك لا يُوَقت في ذلك التعذيب وقتًا، وإن كان الأقرب في الأخبار أنها الأوقات المقاربة للدفن، وإن كنا لا نُعَيِّن ذلك»[(61)].
والجواب: أن هذا النص لا يتعلق بأصل العذاب، وإنما بوقت العذاب، وقد فهم منه بعض الدارسين أن القاضي عبد الجبار ينسب إلى أكثر المعتزلة إنكار عذاب القبر، وهو ليس كذلك؛ لأنه لا يتحدث عن أصل عذاب القبر ووقوعه، وإنما يتحدث عن وقته.
والمعتزلة اختلفوا في هذه المسألة إلى أكثر من ثلاثة أقوال كما حكاه عنهم الجشمي ـ وهو أحد أئمتهم ـ: هل يقع بعد الدفن مباشرة أم يبقى وقتًا أو يكون قبل يوم القيامة بقليل أو نحو ذلك؟
المسألة الثانية: على ماذا يكون عذاب القبر ونعيمه؟
هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، وهي مسألة طويلة جدًّا، وحاصلها:
القول الأول: أن عذاب القبر ونعيمه يكون على البدن فقط، وهذا القول نسبه ابن حجر إلى ابن جرير الطبري، وقال به الكرامية.
القول الثاني: أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح فقط، وهذا القول انتصر له ابن حزم بقوة، واستدل بقوله تعالى: {رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ *} [غافر: 11] ، وذكر أن الميت لو كان يحيا في قبره لما كانت الحياة مرتين والموت مرتين، وإنما كانت ثلاث مرات[(62)]، ثم جزم ابن حزم بأنه لم يصح في النصوص إرجاع الروح إلى الجسد.
ولكن هذا الاستدلال من ابن حزم غير صحيح؛ لأنا لا نقول: إن رجوع الروح إلى البدن في القبر رجوع مستقر، بحيث أنها تكون حياة مستقرة، ومفارقتها تكون موتًا جديدًا، وإنما نقول: هو رجوع يتحقق به سماع السؤال، ثم يقع الانفصال.
فالروح لها تعلقات مختلفة بالجسد، منها: تعلق الروح بالجسد في بطن الأم، فالجنين في بطن أمه ليس ميتًا، وتعلق الروح بالجسد في الدنيا، وتعلق الروح بالجسد في القبر، وتعلق الروح بالجسد يوم القيامة، وكل تعلق من هذه التعلقات يختلف في طبيعته وحقيقته عن التعلق الآخر، فتعلق الروح بالجسد في بطن الأم ليس كتعلقها به في الدنيا.
فهذه الآية لا تتعلق بحالة تعلق الروح بالجسد في القبر، وإنما بتعلقها في الدنيا وتعلقها في الآخرة؛ لأن هذين التعلقين هما اللذان يحصل بهما الحياة المستقرة التي يترتب عليها التكليف.
والصحيح في معنى الآية: أن المراد بالموت الأول كونهم لم يخلقوا، والمراد بالموت الثاني هو موتهم ودخولهم القبر، والمراد بالحياة الأولى حياتهم في الدينا، والمراد بالحياة الثانية حياتهم في الآخرة ، «قال الضحاك: عن ابن عباس في قوله: {رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ} قال: كنتم ترابًا قبل أن يخلقكم، فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى. فهذه ميتتان وحياتان، فهو كقوله: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ} [البقرة: 28] ، وهكذا روي عن السدي بسنده، عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة، عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك»[(63)].
فهذه الآية لا تعرُّض فيها لما يحصل في القبر، ولا ما يحصل في النوم، ولا ما يحصل للجنين في بطن أمه، فلا يصح ترك النصوص الظاهرة في قضية عذاب القبر لهذه الدلالة المحتملة.
وأما كون النصوص لم يصح فيها شيء عن عذاب القبر، فهذا غير صحيح، فقد صح عدد من النصوص في إرجاع الروح إلى الجسد.
القول الثالث: أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح وعلى الجسد، وهذا القول اختاره جمهور العلماء، ونسبه ابن تيميَّة إلى أهل السُّنَّة والجماعة، وحكم على القولين السابقين بالشذوذ.
وهذا القول عليه أدلة كثيرة، منها:
حديث القبر الطويل، وفيه: «ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرْزَبَة من حديد، لو ضُرب بها جبل لصار ترابًا، فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين» [(64)]؛ فالصياح ليس حالة روحية ولا حالة جسدية، وإنما هو مجموع ما بين الحالتين.
ومنها: ما جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «فتعاد الروح إلى الجسد» [(65)].
ومنها: ما جاء أن الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، فهذا عذاب على الجسد. وهذا القول هو القول الصحيح.
المسألة الثالثة: هل عذاب القبر ونعيمه عامٌّ لكل الأمم أم خاص بأمة الإسلام؟
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:
والصحيح: أن عذاب القبر عام لكل الأمم، ومما يدل على ذلك قوله تعالى عن آل فرعون: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ *} [غافر: 46] ، فقد سبق أن ذكرنا أن هذه الآية من الآيات التي تتضمن دلالة لا بأس بها على عذاب القبر، وهي متعلقة بآل فرعون.
ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت اليهودية: أعاذك الله من عذاب القبر، فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك للنبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: «نعم، اليهود يعذبون في قبورهم» [(66)].
ومن ذلك أيضًا: حديث أبي أيوب قال: خرج علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتًا فقال: «اليهود يعذبون في قبورهم» [(67)].
فهذه الأحاديث تدل على أن عذاب القبر ليس خاصًّا بأمة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وإنما هو متعدٍّ إلى غيرها، وذُكر في هذه النصوص آل فرعون وأمة اليهود.
المسألة الرابعة:هل يقع عذاب القبر على المسلمين أم هو خاص بالكفار؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على قولين:
القول الأول: أن العذاب في القبر يكون للكفار ويكون للمسلمين أيضًا، وهو قول الجمهور.
واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير...» الحديث، والحديث متفق عليه، وفيه أن صاحبي القبر يعذبان في البول وفي الغيبة[(68)].
ومن ذلك أيضًا قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه» [(69)].
والقول الثاني : أن عذاب القبر لا يكون إلا على الكفار، والمسلمون لا يعذبون في قبورهم، وهذا القول اختاره بعض المعتزلة.
وهو أقرب إلى الشذوذ لمخالفته الصريحة الظاهرة للنصوص الواردة في هذه المسألة.
المسألة الخامسة: هل يمكن للأحياء أن يدركوا عذاب القبر؟
تتضمن النصوص دلالة لا بأس بها على أن عذاب القبر يمكن أن يدرك من قبل الأحياء، ومن ذلك ما روى أنس بن مالك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر» [(70)].
فهذا الحديث يدل على أنه يمكن للأحياء أن يسمعوا عذاب القبر؛ إذ لو كان مستحيلاً لما صح أن يدعو به النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ لأن الأمور المستحيلة لا يجوز الدعاء بها؛ بل الدعاء بها نوع من الاعتداء.
وقد كثرت الأخبار عن أناس كثيرين سمعوا شيئًا من عذاب القبر، حتى عقد ابن رجب في كتابه «أهوال القبور» بابين في هذه القضية، وذكر أخبارًا كثيرة جدًّا، وكذلك فعل الغزالي وابن القيم وغيرهم، يقول ابن تيميَّة: «قد انكشف لكثير من الناس ذلك ـ يعني: عذاب القبر ـ حتى سمعوا صوت المعذبين صوتًا في قبورهم، ورأوهم يعذبون، ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة»[(71)]، ويقول ابن رجب: «قد أطلع الله من شاء من عباده على كثير مما ورد في هذه الأحاديث حتى سمعوه وشاهدوه عيانًا، ونحن نذكر بعض ما بلغنا من ذلك»[(72)].
وحاصل التقرير السابق: أن النصوص الشرعية دلت على إمكان إدراك عذاب القبر، وأما تحقق إدراك ذلك فلم يأت إلا في الأخبار عن عدد من السالفين. ولكن يشكل على القول بتحقق سماع ما في القبر عدد من النصوص الشرعية، ومنها قوله صلّى الله عليه وسلّم: «ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» [(73)]، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا وُضِعت الجنازة، فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها! أين تذهبون بها؟! يسمع صوتها كلُّ شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق» [(74)]، فظاهر هذه الأحاديث أن البشر لا يمكن أن يسمعوا ما يحصل للميت في قبره.
ومما يشكل عليه أيضًا أن ما في القبر عالم غيبي لا يمكن التحقق من صحته، فالجزم بأن الأصوات التي تسمع عند القبور صادرة من أصحابها يعد جزمًا لا مسوغ له ولا دليل عليه، فما الذي يمنع أن الجن والشياطين هم مصدر تلك الأصوات.
وهذا القول له وجاهة، ومع ذلك يمكن أن يقال: إن ما ذُكر من النصوص ليس فيه منع مطلق من سماع ما في القبور، وإنما غاية ما فيه أن الإنس لا يسمعون الصوت الصادر بعد الضربة بالمرزبة، وليس فيه أنهم لا يسمعون كل صوت من الأموات، وليس فيه منع ظاهر من امتناع سماع ما في القبر مطلقًا ولو لبعض الناس.
وأما أن ما في القبر يعد من الغيب، فلا ريب فيه ، ولكن يمكن أن يقع التحقق من ذلك ولو بغلبة الظن في دائرة ضيقة، فكونه غيبًا ليس مسوغًا للجزم بأنه لا يمكن التحقق منها مطلقًا، خاصة وأن من قرر سماع الأصوات من الأموات علماء أجلاء لا يمكن أن يقرروا ما هو غير قابل للتحقق.
ومع ذلك لا بد من التأكيد على أن هذه القضية يقع فيها الخطأ والتلبيس كثيرًا ، فلا بد من الاحتياط الشديد فيها، يقول ابن تيمية: «يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يُظن أنه من الميت، وقد يكون من الجن والشياطين، مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلّمه وعانقه، وهذا يُرى عند قبور الأنبياء وغيره ، وإنما هو شيطان، فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدَّعى أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبًا في ذلك، وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وهي كثيرة جداً، والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهما، والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان»[(75)].
المسألة السادسة: هل يحصل انقطاع في عذاب القبر؟
سبق فيما مضى أن العذاب في القبر متعلق بصنفين من الناس: الكفار والمسلمين، أما الكفار فقد اختلف العلماء فيهم على قولين:
القول الأول: أن عذابهم دائم في القبر، واستدلوا بقوله تعالى: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} [غافر: 46] ، وبحديث البراء بن عازب الحديث الطويل، وفيه: «ثم يُفتح ـ يعني: للكافر والمنافق ـ له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة» [(76)].
القول الثاني: أن الكفار قد ينقطع عنهم العذاب في القبر، واستدلوا بقوله تعالى: {قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} [يس: 52] ، قالوا: هذه الآية تدل على أنهم كانوا غير معذبين، ثم رجع إليهم ما يُشعر بالعذاب، واختار هذا القول القصاب وغيره من العلماء.
والصحيح القول الأول، لقوة دلالة النصوص على ذلك؛ وأما الآية التي استدل بها أصحاب القول الثاني؛ فالمراد بها: أن الكفار يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوه في محشرهم {قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا}، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد[(77)].
ويمكن أن يقال: إن عذاب الكفار في القبور مستمر ما دامت الحياة في الأرض باقية إلى حين نفخة الصعق، فإنهم ينامون نومة يستيقظون منها إلى البعث، وقد ذكر هذا المعنى عدد من أئمة السلف، وهذا لا ينافي دوام عذابهم.
فإن قيل: القول بأن عذاب القبر على الكفار دائم لا ينقطع يوقع في إشكال، حاصله: أن الكافر الذي مات في زمن متقدم يلزم أن يكون عذابه أكثر وأطول من الكافر الذي مات في زمن متأخر، وهذا منافٍ للعدل.
قيل: هذا غير مشكل؛ لأن العدل في العذاب لا يكون بالمساواة دائمًا، وإنما بإعطاء كل أحد ما يستحقه؛ ولأن طول مدة العذاب لا يعني أكثريته، فقد يكون العذاب أطول من غيره ولكن أخف منه ألمًا، ثم لا يلزم من ذلك التساوي في العذاب يوم القيامة، فقد يكون الكافر المتأخر أشد عذابًا في نار جهنم، والمقصود: أن تحقيق العدل في العذاب له جهات متعددة، وليس مقتصرًا على طول الزمن.
وكذلك يقال في نعيم القبر، فإنه لا يلزم أن يكون نعيم المسلم المدفون أولاً أكثر من نعيم المسلم المدفون متأخرًا؛ لأن العبرة في النعيم ليست بالمساواة دائمًا، ولأن العبرة ليست بطول المدة، وإنما بحقيقة النعيم وحجمه وكيفيته، وما يقع يوم القيامة.
وأما بالنسبة للمسلمين، فقد دل مجموع النصوص على أن العذاب الذي ينزل بالمسلمين في قبورهم نوعان: عذاب منقطع، وعذاب غير منقطع.
ففي بعض النصوص أن بعض أصحاب الكبائر يعذب بنوع من العذاب يستمر معه إلى يوم القيامة، كما في حال من ينام عن الصلاة المكتوبة، وحال من يجر ثوبه خيلاء وغير ذلك، وفي بعض النصوص أن المسلم يعذب بقدر ذنبه أو بما يكفر عنه قدرًا من الذنوب ثم يرتفع عنه العذاب.
وقد ذكر بعض العلماء أن عذاب القبر ينقطع ليلة الجمعة ويومها؛ تشريفًا لهذا اليوم، ولكن هذا القول ليس عليه دليل، وهذه من القضايا الغيبية التي لا بد فيها من دليل ثابت في الشريعة.
المسألة السابعة: أنواع عذاب القبر
دلَّت النصوص الشرعية على أن عذاب القبر أنواع، جمعها ابن رجب في عدد من الأنواع حاصلها وأظهرها: الضرب بمطرقة، وتسليط الحيات والعقارب، وضرب الرأس بحجر، وشد الشدقين، ونحو ذلك، كما في حديث سمرة الطويل، وتضييق القبر على الميت حتى تختلف أضلاعه، وغيرها[(78)].
وما ذكر في تلك النصوص ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل الذكر التمثيلي، وقد يكون في القبر أنواع من العذاب لا نعلمها ولم يأت الخبر بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[47] جامع البيان، الطبري (20/191).
ـ[48] جامع البيان، الطبري (22/486).
ـ[49] جامع البيان، الطبري (14/445).
ـ[50] الروح، ابن القيم (75).
ـ[51] التحرير والتنوير، ابن عاشور (30/521).
ـ[52] جامع البيان، الطبري (24/580).
ـ[53] جامع البيان (24/600).
ـ[54] انظر: مجموع الفتاوى (4/285)، والتخويف من النار، ابن رجب (43)، وشرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز (399).
ـ[55] أخرجه البخاري (2823، 2893، 4707، 5425)، ومسلم (2706).
ـ[56] أخرجه مسلم (2867).
ـ[57] أخرجه البخاري (86).
ـ[58] انظر: الروح، ابن القيم (112) وما بعدها.
ـ[59] شرح الأصول الخمسة (730).
ـ[60] طبقات المعتزلة، ابن المرتضى (72).
ـ[61] فضل الاعتزال، لعبد الجبار (202).
ـ[62] انظر: الدرة فيما يجب اعتقاده (282).
ـ[63] تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (1/212).
ـ[64] أخرجه أبو داود (4753)، وأحمد (18534)، وصححه الألباني.
ـ[65] أخرجه الحاكم في المستدرك (107)، والسمرقندي في تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، وصححه ابن حجر.
ـ[66] أخرجه البخاري (1049)، ومسلم (584، 586).
ـ[67] أخرجه البخاري (1375، 2869).
ـ[68] أخرجه البخاري (216، 218، 1361، 1378، 6052، 6055)، ومسلم (292).
ـ[69] أخرجه أحمد (8331)، ابن ماجه (348)، والحاكم (653)، وصححه الألباني.
ـ[70] أخرجه مسلم (2867).
ـ[71] مجموع الفتاوى، ابن تيمية (4/296).
ـ[72] أهوال القبور (16).
ـ[73] رواه البخاري (1338).
ـ[74] رواه البخاري (1314).
ـ[75] مجموع الفتاوى (1/168).
ـ[76] أخرجه أبو داود (4753)، وأحمد (18534، 18614)، وصححه الألباني.
ـ[77] انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (6/581).
ـ[78] أهوال القبور، ابن رجب (69).
انقر هنا للوصول إلى صفحة الكتاب كاملاً.
انقر على الصورة للوصول إلى النسخة المصورة (pdf) قابلة للتحميل والنشر.