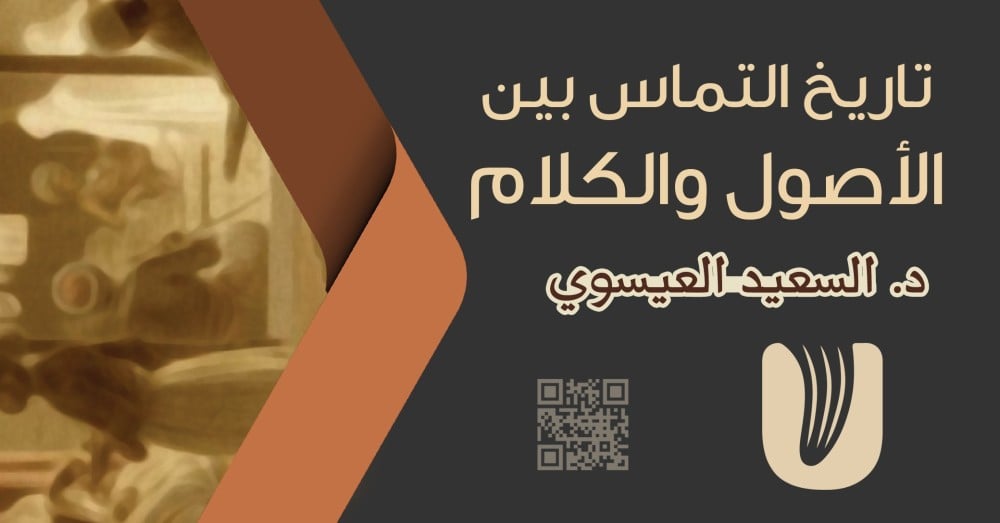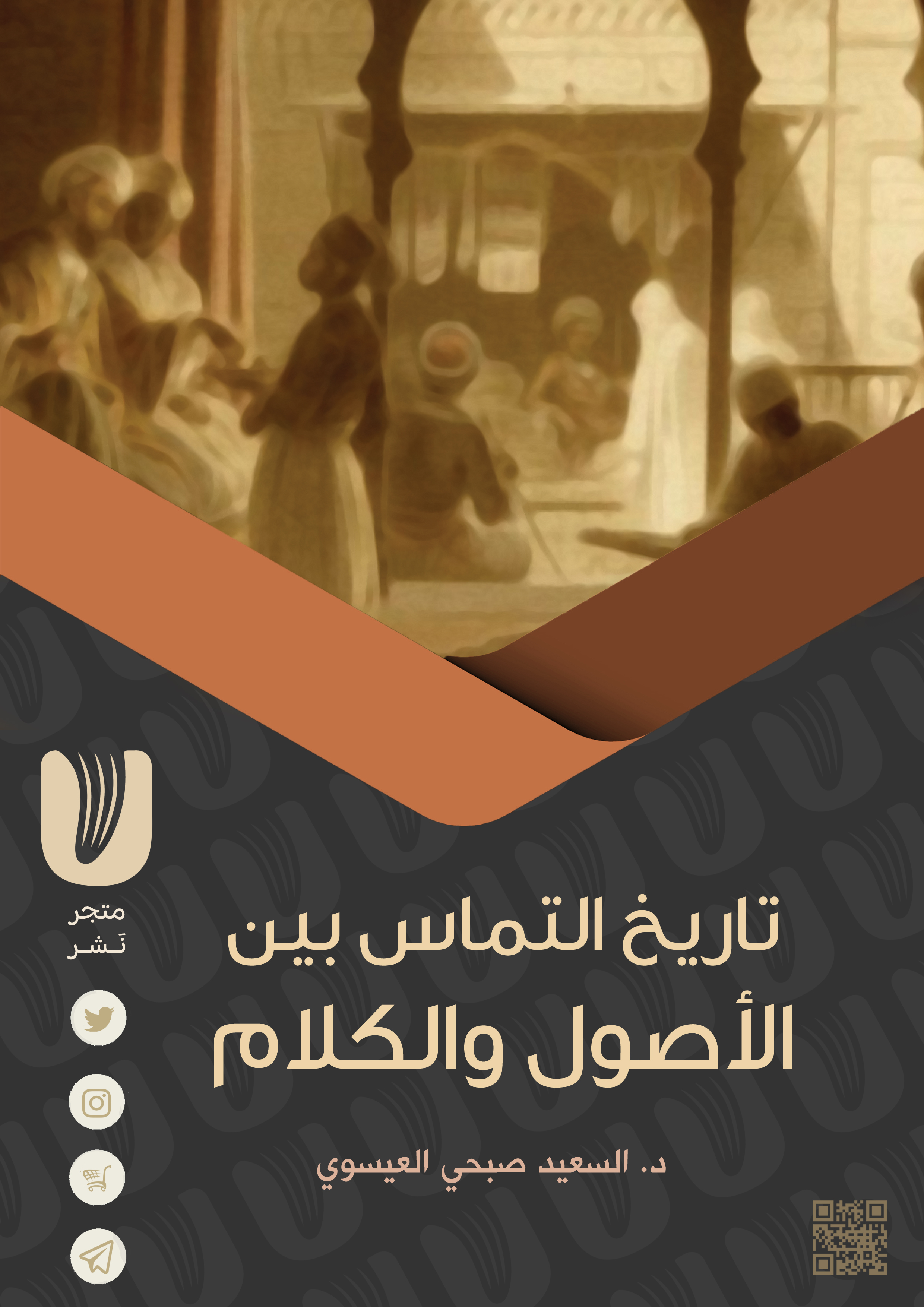تاريخ التماس بين الأصول والكلام
د. السعيد صبحي العيسوي
استُهلت بشائرُ الكتابات الأولى في علم أصول الفقه حاملة في طياتها رسالة مؤكِّدة على دور علم أصول الفقه كعلم خادم للفقه وغيره من المباحث الـمُعينة على الاستنباط والاستدلال.
فلهذه الطبيعة الخَدَمية في ترقية الفقيه لمراتب الاجتهاد، فإنه ظل بعيداً عن المباحثات الكلامية، ولم يُعهد في مصادر الأصول الأولى تمازج بينهما، وهذا ظاهر جداً عند الإمام الشَّافعي في "الرسالة".
وقد ظهرت بدايات الاتصال الأولى بين العلمين تدريجياً في القرن الثَّالث الهجري، ثم تكثفت في القرن الرَّابع، حتى ظهرت في أواخره كتابات أصولية معتزلية وأشعرية، مزجت بين علم أصول الفقه وعلم الكلام، فكانت منطلقاً لإحكام الربط بين العِلْمَين في أكثر الكتب الأصولية التي دُوِّنت في القرون الموالية، والتي شهدت تزايداً بشكل أكثر وضوحاً مع تأخُّر الزمن([1]).
ولم يكد القرن الرَّابع الهجري ينتصف حتى برز القاضي عبدالجبار المعتزلي([2]) المتوفى في بداية القرن الخامس، بعد أن عاش كثيراً منه في القرن الرَّابع، فهو أشهر متكلمٍ معتزليٍّ اهتمّ بالتراث الأصولي لأسلافه توضيحاً واحتجاجاً، ونقداً، وإضافةً، ويمكن وصفَهُ بأنه متكلم أصولي، وذلك أنه لم يكتفِ بإدخال المسائل الكلامية في كتبه الأصولية، بل أدخل المسائل الأصولية في كتبه الكلامية، ومن أهم كتبه "النهاية" و"العُمَد" و"شرح العمد"، ومع أن هذه الكتب لم تصلنا، فإن كتاب "المعتمد" الذي شرح فيه أبو الحسين البصري كتاب "العمد" دليل واضح على إدخال الكلاميات في علم أصول الفقه.
أما ذكره للمسائل الأصولية في كتاباته الكلامية فيظهر بوضوح في كتابه "المغني في أبواب العدل والتوحيد"، فبالإضافة إلى ما أورده من قضايا أصولية متفرقة في سائر الأجزاء، كما في الجزء السادس عشر على الخصوص، فقد خصَّص الجزء السابع عشر بأكمله للكلام في "الشرعيات"، فكان هذا الجزء كتاباً أصولياً فيما يلتقي فيه الأصلان؛ أصل الاعتقاد، وأصل العمل. وقد اهتم القاضي عبدالجبار في هذا الجزء بتفصيل كثير من المسائل التي أهملها الأصوليون أحياناً، أو أجملوا القول فيها. ولا تكاد كتبه الأخرى تخلو من المسائل الأصولية، ولو عرضاً، أو على سبيل الاستدلال بها، مثل كتاب "شرح الأصول الخمسة" -على فرض ثبوت نسبته إليه-، بل إن كتابه "المحيط في التكليف" يهتم بموضوع يعدُّ من أهم المواضيع المشتركة بين عِلمي الكلام والأصول. وبإمكاننا اعتبار مؤلفات القاضي من أهم المصادر التي تحفظ آراء المعتزلة الأصولية واستدلالاتهم([3]).
أما الخطوة التالية، فكانت ردة الفعل من قبل الأشاعرة والماتريدية لنقد الآراء الاعتزالية المبثوثة في العلوم، ومنها علم أصول الفقه، وحدثت نقطة تحوُّل قوية؛ حيث حلَّت مدرسة الأشاعرة محل المدرسة الاعتزالية، واستُبدل بالخطاب الجدلي نوع آخر من الجدل العلمي المنظَّم([4]).
وقد اتخذت الفكرة الأشعرية شكل المعارضة العقلية للفكرة الاعتزالية، مما كان له الأثر البالغ في رفع المعتزلة من مستوى براهينهم وحُججهم، وذلك لأنه قد كان وراء هذه المدرسة الجديدة أناس خَبَروا الاعتزال، ووقفوا على مثالبه ومعايبه، وأدركوا مواطن الخلل في تفكير المعتزلة، ومناهجهم؛ الأمر الذي يعني قدرة هذه المدرسة ورموزها على مناهضة أفكار المعتزلة، وآرائهم، اعتماداً على المنهج ذاته الذي يعتمدونه في إفحام خصومهم([5]).
وشهدت هذه المرحلة بروز القاضي أبي بكر الباقلاني، فقد كان له دور كبير في التأليف الأصولي، ومناقشة المعتزلة فيما أوردوه بشكل أكثر بَسْطاً، وقد امتاز بكثرة التصانيف والمؤلفات. وكان محلَّ عناية واهتمام كثير من الأصوليين والمتكلمين ممن أتوا بعده. وإذا كان الشَّافعي قد أدخل علم أصول الفقه في مرحلة التدوين، فإن الباقلاني قد انتقل بالتأليف الأصولي إلى مرحلة التوسع الشمولي، وإلى التوسع في التمازج مع علم الكلام([6])، أو كما وصفه البعض بأنه «أغرق فيه أصول الفقه في بحر الكلام، حتى لم يَسَع من بعده إلا متابعته»([7]) .
ويؤرخ الإمام الزركشي لهذه الفترة فيقول: «وجاء مَنْ بعده [أي بعد الشَّافعي رحمه الله]، فبيَّنوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا، حتى جاء القاضيان: قاضي السُّنَّة أبو بكر ابن الطيب وقاضي المعتزلة عبدالجبار، فوسَّعا العبارات، وفكَّا الإشارات، وبيَّنا الإجمال، ورفعا الإشكال. واقتفى الناس بآثارهم، وساروا على لاحب نارهم، فحرَّروا وقرَّروا، وصوَّبوا، وصوَّروا»([8]).
والملاحظ عند كثير ممن أرَّخ للعلاقة بين العِلْمين إغفال التأريخ لمنهج أهل السُّنَّة والجماعة ودورهم في نقد الآراء الاعتزالية والأشعرية، ومن هؤلاء الأئمة الذين كان لهم دور كبير في نقد المدارس الكلامية وإيراداتها في علم الأصول الإمام أبو المظفَّر -رحمه الله-، ولعل هذه الدراسة التي بين أيدينا برهان عن دوره في نقد الأثر الكلامي في علم الأصول.
تلا ذلك ظهور مؤلفات أصولية كثُر فيها التداخل بين العِلْمين، وكلٌّ ينتصر لمذهبه واعتقاده، ككتب أبي المعالي الجويني([9])، وأبي حامد الغزالي([10])، والآمدي([11])، وأبي الخطاب الكلوذاني([12])، وابن قدامة([13])، وابن تيمية -رحمهم الله تعالى، ولم تكن كتب الأصول لِتَسْلَم مِنْ تبعات التداخل الكلامي، وغلبة الجدل، وتشقيق الخلافات والاعتراضات ونحو ذلك.
أما أثر هذا التداخل في علم الأصول، فإن المتأخرين بهذا «حجَّروا ما كان واسعاً، وأبعدوا ما كان شاسعاً، واقتصروا على بعض رؤوس المسائل، وكثَّروا من الشُّبَه والدلائل، واقتصروا على نقل مذاهب المخالفين من الفرق، وتركوا أقوال من لهذا الفن أصَّل، وإلى حقيقته وصل، فكاد يعود أمره إلى الأوَّل، وتذهب عنه بهجة المعول، فيقولون: خلافاً لأبي هاشم([14])، أو وفاقاً للجبائي([15])، وتكون للشافعي منصوصة، وبين أصحابه بالاعتناء مخصوصة، وفاتهم من كلام السابقين عبارات رائقة، وتقريرات فائقة، ونقول غريبة، ومباحث عجيبة»([16]).
وجملة القول إن المتكلمين منذ القرن الرَّابع الهجري وضعوا أيديهم على علم أصول الفقه، وغلبت طريقتهم فيه طريقة الفقهاء فنفذت إليه آثار الفلسفة والمنطق، واتصل بهما اتصالاً وثيقاً، حتى أصبحت كأنها هي السمة السائدة في كتابات الأصوليين([17]).
وهذا قد سطَّره أحد أعيان القرن الخامس، وهو أبو المظفَّر؛ يقول: «وقد غلب الجدليون غلبةً عظيمةً، واقتنعوا بدفاع الخصوم، ورضوا بعبارات مُزوَّقة، فاضلةٍ عن قَدْر الحاجات»([18]).
فلم يكد يطلع القرن الخامس الهجري حتى امتزج العِلْمان؛ علم أصول الفقه وعلم الكلام، وشُحنت أفكار أصول الفقه بمقدمات ومباحث من علم الكلام؛ والكل ينطلق من عقيدته ومنهجه، ويقرر ما يرتضيه مذهباً وما يدينُ الله به.
___________________________________________
([1]) ينظر: فلوسي، مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه، ط.1 ص304، والشتيوي، علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام، ط.1 ص106-107.
([2]) هو عبدالجبار الهمذاني الأسدآبادي، المعتزلي الشافعي. له: المغني في أبواب التوحيد والعدل، وطبقات المعتزلة. توفي بالرِّي سنة 415هـ. ينظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى 5/97، وكحالة، معجم المؤلفين، د.ط 5/78.
([3]) خثيري، الفكر الأصولي عند المعتزلة ط.1 ص166، والشتيوي، علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام ص108.
([4]) يُنظر كمثال: الماتريدي، التوحيد، د.ط ص151-152، وابن فورك، مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ط.1 ص128، ومدكور، المنهج الأرسطي والعلوم الكلامية والفقهية، (جزء مترجم عن الفرنسية) د.ط ص 164-165.
([5]) ينظر: سانو، قراءات معرفية في الفكر الأصولي، ط.1 ص90-91.
([6]) ينظر: الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص45-46.
([7]) ينظر: العروسي، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، ص12- 16، والحارثي، علاقة أصول الفقه بعلم المنطق، ط. 1، ص133.
([8]) الزركشي، البحر المحيط 1/25-26.
([9]) هو عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، الشافعي الأشعري، له: البرهان، والورقات، ونهاية المطلب. توفي بنيسابور سنة 478هـ. انظر السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 5/165، وابن كثير، طبقات الفقهاء الشافعيين، د.ط 2/466.
([10]) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، الشافعي، متكلم أشعري، له: المستصفى، والإحياء، والمنخول. توفي سنة 505هـ. ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات 1/211، والذهبي، سير أعلام النبلاء، 19/323، والزركلي، الأعلام 7/23.
([11]) هو علي بن أبي علي، أبو الحسن سيف الدين الآمدي، الأشعري، له: أبكار الأفكار، والإحكام في أصول الأحكام. تُوفي بدمشق سنة 631هـ. ينظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى 8/ 306، والصفدي، الوافي بالوفيات 21/ 225.
([12]) هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب، الحنبلي. وله: التهذيب في الفرائض، والتمهيد في الأصول. توفي 510هـ. ينظر: ابن مفلح، المقصد الأرشد، ط.1 3/20، والذهبي، سير أعلام النبلاء 19/348، والزركلي، الأعلام 5/291.
([13]) هو عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي، المقدسي، الحنبلي، أبو محمد موفق الدين. له: المغني، والكافي، وروضة الناظر. تُوفي سنة 620هـ. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء 22/166 - 173، والصفدي، الوافي بالوفيات، 17/ 23.
([14]) هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي المعتزلي، له: الجامع الكبير، والعرض. تُوفي ببغداد سنة 321هـ. ينظر: البغدادي، تاريخ بغداد، ط.1 11/56، والذهبي، سير أعلام النبلاء 15/63 – 64، والصفدي، الوافي بالوفيات 4/55.
([15]) هو محمد بن عبدالوهاب، أبو علي الجبائي المعتزلي، له: الأصول، والنهي عن المنكر، والرد على ابن كلاب. توفي 303هـ. ينظر: الذهبي، السير 14/183، والصفدي، الوافي بالوفيات 4/55، والزركلي، الأعلام 6/256.
([16]) ينظر: الزركشي، البحر المحيط 1/26.
([17]) ينظر: عبدالرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، د.ط.ت ص364، وعلي، سلسلة تصفية علم الأصول من الفضول، ص85.
([18]) السَّمعاني، القواطع 3/1017-1018.
انقر هنا للوصول إلى صفحة الكتاب كاملاً.
انقر على الصورة للوصول إلى النسخة المصورة (pdf) قابلة للتحميل والنشر.