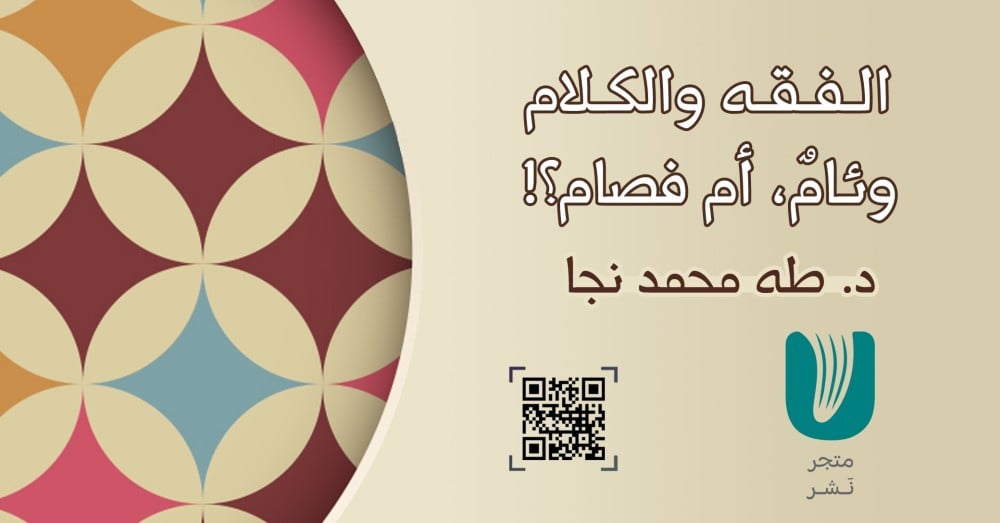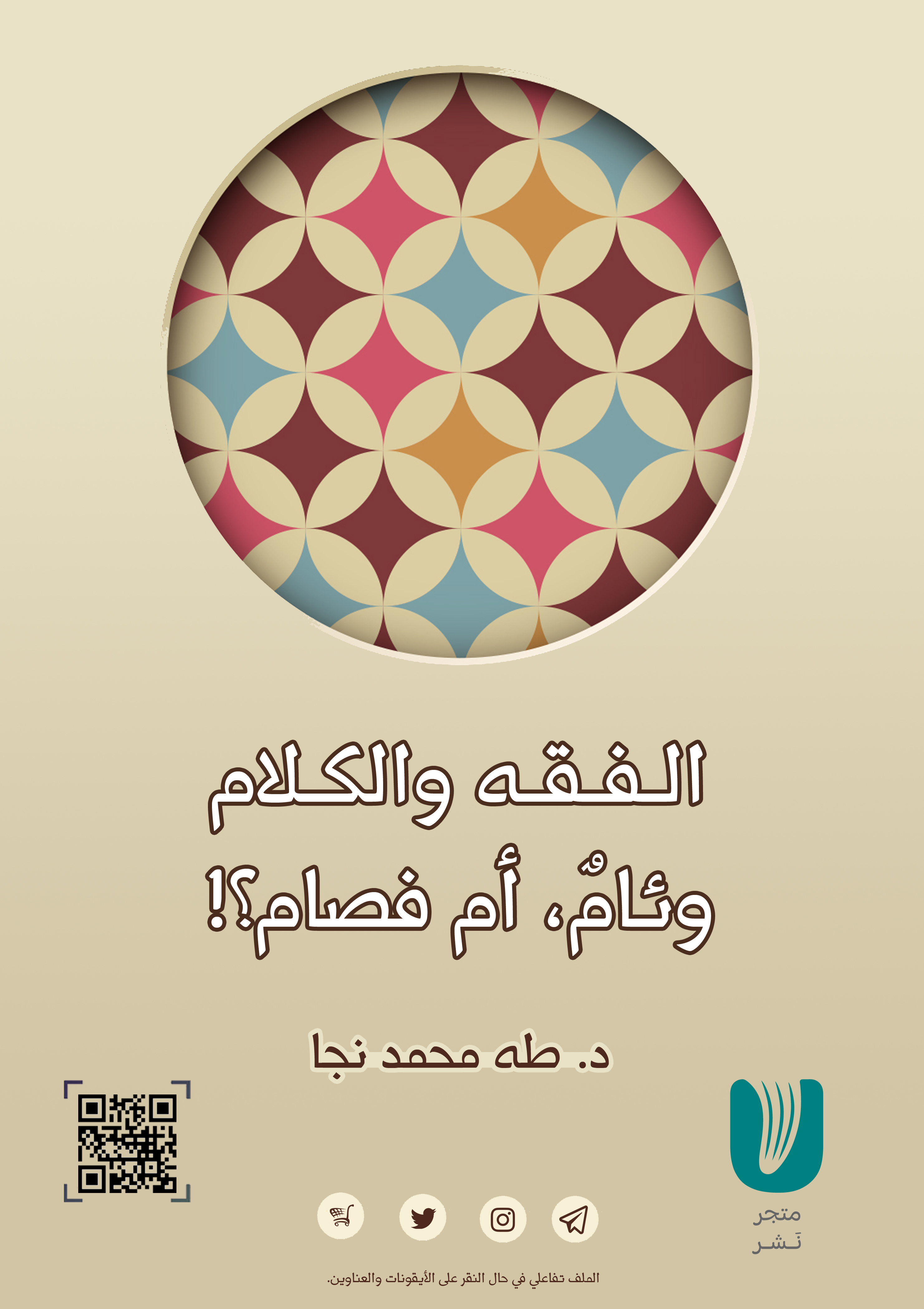الفقه والكلام... وئامٌ، أم فصام؟!
د. طه محمد نجا
لسنا هنا في حاجةٍ إلى أن نغلوَ في تقدير العلاقة بين علم الكلام وغيره من علوم الشريعة، وندعيَ أن سائر العلوم خَدمٌ له([1])، كما أنه لا ضرورة بنا إلى أن نميل إلى الطرف الآخر في التأريخ لتلك العلاقة، فندعيَ أن علم الكلام ظلَّ خادمًا للفقه، إلى أن تحرَّر منه في القرن الرابع أو الثالث([2])؛ وإنما يكفينا أن نخلص من ذينِك الطرفين، إلى أنَّ علمَ الفقه (الفروع)، وعلمَ الكلام (الأصول)([3])، كان بينهما من العلاقة والاتصال الوثيق، ما يجمعهما في إطارٍ واحدٍ، بحيث أمكن لناظرٍ أن يبصر في ذلك الجامع بينهما، لُحْمَة الخادم والمخدوم، أو اللازم والملزوم.
وبعبارةٍ أخرى: كان العلمان جميعًا من أفراد علم الآخرة، الذي يضمُّ إليهما أحوالَ القلوب ومراتب الأعمال، وكلَّ ما يعين على طريق الآخرة؛ يضمُّ ذلك كله في النطاق العام الشامل للعلم النافع([4]). وهو الأمر الذي يعبر عنه الحَليميُّ (ت: 403 هـ) بقوله: «إنَّ تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح: حادثٌ ..؛ والحقُّ أن اسم الفقه يعمُّ جميع الشريعة، التي من جملتها: ما يُتوصل به إلى معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته، وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم السلام، ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب، والقيام بحقِّ العبودية، وغير ذلك»([5]).
وهي عبارةٌ، بقدر ما تؤرِّخ للفكرة التي أشرنا إليها؛ تلمح إلى عدم القبول بذلك الفصل، أو عدم الرضا عن الآثار المترتبة عليه، ومنها حرمان علم الكلام من ذلك اللقب الممدوح (الفقه)، وما يترتب على ذلك الحرمان من آثارٍ؛ وهو ما يذكره الحَليميُّ، صراحةً، بعد ذلك:
«وليست بنا، من تعظيم اسم الفقه، والتنويه باسم الرأي: وحشةٌ، ولا ذاك بالذي يَلحقنا منه مساءةٌ؛ فإنَّا بحمد الله، من أهل ذلك كله ... وإنما يسوؤنا أن يخرَج من جملة الفقه، ما ليس بخارجٍ منها، ليُتذرَّع بذلك إلى نبذه وهجره، والبخس بحقه، والإزراء بقدره»([6]).
وإذا كان التمازج، بين هذه العلوم، وأمثالها، ممكنًا في بداية الأمر؛ حيث العلوم الشرعية حديثة النشأة، وحيث يصدر الجميع عن أصولٍ تسلك مسائل العلمين في نسقٍ معرفيٍّ واحدٍ؛ فإن تطور العلوم، وسعةَ التصنيف، وانتشارَ المذاهب، وتعدُّدَ المناهج، والضرورات التعليمية، كلُّ ذلك - وغيره - كان من شأنه ألا يدع مكانًا لهذه النظرة الأولى، وأن يفتح الباب نحو التمايز الطبيعيِّ بين هذه العلوم، وانفراد كلٍّ بالميدان الذي صار إليه آخر الأمر.
نقول ذلك، مع إدراكنا: أن ذلك الانفصال - المنطقيَّ، فيما نرى - لم يكن طلاقَ البتة (!!)؛ ولا هو بالممكن، في واقع الأمر: أن ينعزل كلُّ علمٍ، بحقله المعرفيِّ، بعيدًا عن الآخَر؛ بل بقيَت هنالك، بعد التقاسم: قواسم مشتركةٌ بين العلمين؛ فيما يعبِّر عنه أبو حيان التوحيديُّ (ت: بعد 400 هـ) بقوله: «وبابه - يعني: علم الكلام -: مجاورٌ لباب الفقه، والكلام بينهما مشتركٌ؛ وإن كان بينهما انفصالٌ وتباينٌ؛ فإن الشرِكة بينهما واقعةٌ، والأدلةَ بينهما متصارعةٌ»([7]).
ولعل أوضح هذه التخوم المشتركة، وأقربها مثالًا: أن نتذكر أن العلمين كانا مادة استمدادٍ لعلم أصول الفقه([8])، الذي هو «علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين»([9])؛ فهذا علمٌ - برأسه - يشترك العلمان، جميعًا، في تأسيسه، ومن الواضح أن هذه المشاركة سوف تفتح قنوات التواصل، من جديد، وتتيح فرصًا شتى، للتأثير والتأثر.
وأما من حيث المسائل، ومفردات العلوم، فنذكر - على سبيل المثال - قضية العبادة ومفهومها، ومعلومٌ ما شأنُ هذه القضية من الدين كله، وهي قيمةٌ مشتركةٌ بين العلمين، يحتاج كلٌّ منهما في مسائله وتفريعاته إليها، وهذا ما يظهر من هذا النص للإمام النَّوويِّ (ت: 676 هـ):
«واختلف العلماء في حد العبادة: فقال الأكثرون: العبادة؛ الطاعة لله تعالى، والطاعة موافَقة الأمر. وكذا نقل هذا عن المصنف [الشِّيرازيّ].
وذكر المصنف في كتابه في الحدود الكلامية والفقهية خلافًا في العبادة، فقال: العبادة والتعبد والنسك بمعنًى، وهو الخضوع والتذلل؛ فحد العبادة ما تعبدنا به على وجه القربة والطاعة ...
وقال إمام الحرمين في كتابه الأساليب في مسائل الخلاف هنا: العبادةُ: التذلل والخضوع بالتقرب إلى المعبود بفعل ما أمر.
وقال المتولي في كتابه في الكلام: العبادة فعلٌ يكلِّفه الله تعالى عباده، مخالفًا لما يميل إليه الطبع على سبيل الابتلاء، وقال الماوَرْديُّ في الحاوي: العبادة ما ورد التعبد به قربة لله تعالى...»([10]).
نحن هنا إذًا ، أمام نص (شارِحٍ)، يعالج مشكلة واحدة، هي مفهوم العبادة، من خلال تحليل متن مذهبي (المهذب، للشيرازي)، ومن خلال هذا الدرْس يراوح الشارح (النَّوويّ) في تقريره بين مصدر يُعنى بفقه المذهب (=الحاوي)، وآخر للخلاف مع الأحناف (=الأساليب)، وثالث مشترك بين الفقه والكلام (=الحدود)، ثم من تتمة أنواعها: مصدر كلامي خالص، وهو كتاب المتولي (ت: 478 هـ)([11])، ومؤلفه - أيضًا - فقيه شافعي، من كبار فقهاء المذهب، ولا يخفى الطابع المميز لتعريفه، من بين التعريفات المذكورة.
وبين يدينا نص بارع للإمام النَّوويِّ (ت: 676 هـ) يعرض لنا صورة لتوارد العلمين، على بحث مسألة واحدة، وهي: تكليف الكفار بفروع الشرائع؛ بينما يتمايز كل علم بمأخذه المختلف عن الآخر:
«وأما الكافر الأصلي:
فاتفق أصحابنا في كتب الفروع: على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج، وغيرها من فروع الإسلام.
وأما في كتب الأصول: فقال جمهورهم: هو مخاطب بالفروع، كما هو مخاطب بأصل الإيمان. وقيل: لا يخاطب بالفروع. وقيل: يخاطب بالمنهي عنه، كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباهها، دون المأمور به، كالصلاة.
والصحيح: الأول، وليس هو مخالفا لقولهم في الفروع؛ لأن المراد هنا، غير المراد هناك.
فمرادهم في كتب الفروع: أنهم لا يطالبون بها في الدنيا، مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم: لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة.
ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة، زيادة على عذاب الكفر؛ فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعًا، لا على الكفر وحده. ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا.
فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين، وفي الفروع حكم الطرف الآخر. والله أعلم»([12]).
وبذلك الإدراك لتمايز المآخذ، يتحرر للباحث نظره في تلك المشكلات، والمسائل المشتركة بين العلوم.
والمثال الأشهر والأوضح من ذلك: كتاب (الردة)، وهو معروف في كل كتب الفقه يتعلق بالمسلم: متى يسمى كافرًا؟ وما الأحكام التي تترتب على ذلك؟ ثم الشق الآخر للبحث، وهو عكس الأول: «فيما تحصل به توبة المرتد؟ وفي معناها: إسلام الكافر الأصلي»([13]).
ومعلوم أن (الأسماء والأحكام) كتابٌ دائرٌ في عامة كتب الكلام، أيضًا([14]).
وفي «البيان والتحصيل» لابن رشدٍ الجدِّ (ت: 520 هـ)، بحثٌ نفيسٌ حول قول الرجل لامرأته: أنت طالقٌ، إن لم أكن من أهل الجنة، وجواب الإمام مالكٍ في ذلك. وتصوير حالات ذلك، بحسب البحث الكلامي لمسائل الإيمان، والاستثناء فيه، وما يتعلق بذلك([15]).
وأما الأحناف، فلعلهم أكثر المذاهب، فيما رأيت، من حيث الاستطرادات الكلامية، في مصنفاتهم الفقهية([16]).
وهذا الأثر الذي أشرنا إليه قد انتقل إلى أشد المدارس حفاظا، وتصوُّنا عن البحوث الكلامية والفلسفية، وهي المدرسة الحنبلية؛ ولسنا نمثل هنا بنصوص لأبي يعلى (ت: 458 هـ)، أو ابن عقيل (ت: 513 هـ)، أو ابن الزاغوني (ت: 527 هـ)، ونحوهم ممن كانت له مشاركات كلامية، وبحوث ألبت عليه أصحابه من الحنابلة؛ بل سوف ننقل هنا نصًّا لواحدٍ من أهم وأبرز تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأعلمهم بفقهه واختياراته، وهو شمس الدين محمد بن مفلحٍ (ت: 763 هـ):
«قال القاضي أبو يعلى في قوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلًا، وإنما تجب بالشرع، وهو بعثة الرسل وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنار .. ..
والمشهور في أصول الدين عن أصحابنا: أن معرفة الله تعالى: وجبت شرعًا، نص عليه. وقيل: عقلًا، وهي [يعني: على هذا القول]: أول واجبٍ لنفسه، ويجب قبلها النظر، لتوقفها عليه([17])، فهو أول واجبٍ لغيره، ولا يقعان ضرورةً. وقيل: بلى ...
وفسر أحمد الفطرة فقال: التي فطر الله الناس عليها، شقي أو سعيد، قال القاضي: المراد به الدين، من كفرٍ أو إسلامٍ، قال: وقد فسر أحمد هذا في غير موضعٍ، وذكر الأثرم: معناه على الإقرار بالوحدانية، حين أخذهم من صلب آدم {وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: 172]، وبأن له صانعًا ومدبرًا، وإن عبد شيئًا غيره وسماه بغير اسمه ...»([18]).
وإذا كانت هذه مادةً كلاميةً في علم الفقه، فإن مباحث الإمامة وما يتعلق بها، هي مادةٌ فقهيةٌ في عامة كتب الكلام، وهو ما يعبر عنه الجويني (ت: 478 هـ)، بعبارةٍ حاسمةٍ، مقتضبةٍ: «وليست الإمامة من قواعد العقائد ..»([19]).
بل إن بعض المحققين يرى أن مسائل السمعيات، مثل: خلق الجنة والنار، والكلام على الصراط، ونحو ذلك، هي مسائل فرعيةٌ، فقهيةٌ، انتقلت إلى علم الأصول، الكلام([20])، ومن المألوف أيضًا أن نجد في كتب الكلام والفرق بعض الآراء الفقهية، وهي تنقل - عادة - على سبيل الطعن فيمن تنسب إليه، وعيبه([21])!!
ومن المهم هنا؛ ألا ننسى أنه لم يكن بد للفقيه أن (يتكلم)، ولا للمتكلم أن (يتفقه)؛ ولسنا نعني - هنا - أنه كان على كل فقيه أن يصير متكلِّمًا، بالمعنى الاصطلاحي، أو عكسه([22])، ولكنا نقول: إن ارتباط العلمين بالدين العام، أصله وفرعه؛ من شأنه أن يجعل من اللازم على كل مشتغل بعلم، أن يكون له موقف ما، من قضايا العلم الآخر، ولو بصورة إجمالية؛ وهذا أمر بدهي([23]).
***
بيد أنه من مهمات النظر، والتأريخ هنا: ألا نحمل أمثال هذه النصوص أكثر مما تحتمل، فنتراءى الصورةَ على خلاف ما كانت عليه، أو على غير ما هي عليه، في واقع الأمر؛ ونعتقد أن الانفصال بين الفقه والكلام كان انفصالًا سلميًا، قائمًا على حسن الجوار، وتبادل المنافع والمواقع، إن صح لنا أن نستعير لغة السياسة فيما نحن فيه.
فنحن نرى إمام الحرمين، أبا المعالي، يشير إلى بعض المشكلات، والمسائل (المشتركة - البينية)، بين علمي (الفقه) و(الكلام)، وينعى على الفقهاء ركونهم إلى تقريرات (المتكلمين)، في هذه الأبواب، وعدم نهوضهم بحملها، دونهم:
«أما تفاصيل القول في الأمر بالمعروف: فإنه يحويه كتاب، يليق بالفقهاء أن يستقصوه، فوكلوه إلى المتكلمين، كما وكلوا إليهم التوبة، وتفاصيل الأقوال في الخروج عن المظالم»([24])!!
وإذا ما وسعنا أفق التأمل شيئًا ما، وغيرنا زاوية النظر إلى تاريخ العلاقة بين العلمين، فبإمكاننا أن نقرأ فيه صفحة أخرى، ونرى مشهدا آخر؛ فنتراءى حبل الوجهتين في انجذام، والخرق بينهما في اتساع؛ وهكذا الشأن، دائما، في كل افتراق؛ فإنه، وإن بدا يسيرا عند مفرق الطريق؛ فلا يلبث مع طول الأمد، وتوالي المسير، أن يصل إلى حيث يعز اللقاء!!
فكيف إذا غَذَتْه حسائكُ النفوس، وفرحُ كل فريق بما عنده، واستخفافه بما عليه الآخرون([25])، كما هي عادة الناس في تصرفهم، وهِجِّيراهم في تقلبهم: «وقل ما رأيت سالكَ طريقٍ إلا ويستقبح الطريق التي لم يسلكها، ولم يُفتح عليه من قِبَلها، ويضع عند ذلك من غيره، لا ينجو من ذلك إلا القليل من أهل المعرفة والتمكين!!»([26]).
وهو لون وراثة من الأمتين قبلنا، كما يرى ابن تيمية في تحليله لجحد كل طائفة ما عند الآخرين من الخير والصواب([27]).
يقول أبو المظفَّر السَّمْعانيُّ (ت: 489 هـ): «وعن ثمامة بن الأشرس (ت: 213 هـ)، وكان من أئمة المعتزلة المذكورين فيهم، أنه رأى قومًا يتعادَوْن يوم الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوت الصلاة، فقال: انظروا إلى البقر، انظروا إلى الحمير؟!
وقال عمرو بن النضر([28]): مررت بعمرو بن عبيدٍ، فجلست إليه، فذكرت شيئًا، فقلت: ما هكذا يقول أصحابنا!! قال: ومن أصحابك؟ قلت: أيوب، وابن عونٍ، ويونس بن عبيدٍ، والتيميُّ. فقال: أولئك أرجاسٌ أنجاسٌ، أمواتٌ غير أحياءٍ!!»([29]).
وليس مما يعنينا هنا كثيرًا أن نتثبت من إسناد تلك المقالة، أو أن نحكم على من نُسبت إليه بمقتضاها، إنما يعنينا دلالتها على النظرة المتبادلة بين الفقهاء والمتكلمين([30])، أو على الأقل: كيف يرى الفقهاء مكانهم في أعين المتكلمين؛ وهو أمر سوف يؤثر - لا محالة - في موقف الفقهاء من المتكلمين!!
***
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) انظر: رأي طاش كبري زاده في: مفتاح السعادة ومصباح السيادة (1/32). ومن هنا أدخل فيه المتأخرون طائفةً من المباحث المستعارة من غيره من العلوم؛ أنفةً من أن «يحتاج أعلى العلوم الشرعية» إلى غيره. انظر: أبجد العلوم، صديق حسن خان (2/67).
([2]) انظر: رأي آدم متز في: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع (1/333) وحاشية المترجم، رقم (1).
([3]) يقف الجاحظ عند وجهٍ آخر لهذه الفكرة، ليفضل (الكلام) لأنه (الأصل)، على الفقه، الذي هو (فرع) له. انظر: رسائل الجاحظ (4/250). بينما يقرِّر الغزالي، وفي كتابه الكلاميِّ المهم (الاقتصاد في الاعتقاد): أن ذكر ثنائية: (الأصل) و(الفرع)، في هذ السياق، تهويلٌ خادعٌ: «ولا يغرَّنَّك ما يهوِّل به، من يعظِّم صناعة الكلام، من أنه (الأصل)، والفقه (فرع) له؛ فإنها كلمة حقٍّ، ولكنَّها غيرُ نافعةٍ في هذا المقام؛ فإن (الأصل): هو الاعتقاد الصحيح، والتصديق، والجزم؛ وذلك حاصلٌ بالتقليد، والحاجة إلى البرهان، ودقائق الجدل: نادرةٌ ..» اهـ (1/98 - ط مصطفى عمران). بينما يعرض ابن القيم، ذلك الترتيب بين العلمين، في نفَس هادئٍ، منتجٍ؛ حيث يحيل في بحثه لبطلان الحيل، على باب معرفة الرب، وأسمائه وصفاته، ثم يقول: «فهذا استدلال بالفقه الأكبر، في الأسماء والصفات، على الفقه العملي، في باب الأمر والنهي ..» اهـ التبيان في أيمان القرآن (346).
([4]) انظر: إحياء علوم الدين (1/32-33)، فضل علم السلف على علم الخلف، لابن رجب (45) وما بعدها، وانظر أيضًا: مصطفى عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفة (118-121، 211-212).
([5]) نقله الزركشي في البحر المحيط (1/23)، وقارن أصل العبارة في: المنهاج في شعب الإيمان (1/13) وينظر أيضًا: عبد الكريم زيدان: مدخل إلى الشريعة الإسلامية (62-63)، بكر أبو زيد: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/39-41).
([6]) المنهاج في شعب الإيمان، لأبي عبد الله الحَليميِّ (1/14-15).
([7]) رسالة في العلوم، لأبي حيان التوحيدي (22).
([8]) حول استمداد علم الأصول، انظر: البرهان في أصول الفقه، للجويني (1/77-78)، أصول الفقه، للشيخ الخضري (18-19)، الفكر الأصولي، د.عبد الوهاب أبو سليمان (22-23).
([9]) ابن تيمية: الاستقامة (1/50)، وينقل حاجي خليفة عن علاء الدين الحنفي، أحد أصوليي الأحناف، أن علم أصول الفقه فرع لعلم أصول الدين. انظر: كشف الظنون (1/110).
([10]) المجموع شرح المهذب (1/355)، وانظر: نحوُا مما نقلناه - حول مفهوم العبادة - مع بعض زيادات، عند الزركشي في: المنثور في القواعد (2/367).
([11]) لم أقف على هذا النص في كتاب (الغنية في أصول الدين) المطبوع، له؛ فلا أدري: هل سقط منه، أم للمتولي كتابٌ كلاميٌّ آخر، لم نقف عليه؟!
([12]) المجموع شرح المهذب (3/5)، وعنه: شرح الكوكب المنير، للفتوحي الحنبلي (1/503).
([13]) النص للنووي في روضة الطالبين (10/82)، ونقل هناك نصًّا مهمًّا عن الحَليميِّ (83-85)، وهو تقرير كلاميٌّ صرفٌ. ومن الجدير بالذكر هنا؛ أن نشير إلى ما نقله الحافظ صلاح الدين العلائيُّ الشافعيُّ (ت: 761 هـ) عن بعض شيوخه في ضبط أبواب فقه المعاملات، بتوزيعها على الحواس الخمس: المذوقات، والملموسات، والمبصرات، والمسموعات، والمشمومات. انظر كتابه المهم: المجموع المُذْهَب في قواعد المَذهب (1/14-16). وهي محاولة طريفةٌ ومهمةٌ، لم تجد - فيما أعلم - من ينتبه إليها، فضلًا عن أن يدرسها أو يحاول تعميقها أو محاكاتها. وانظر أيضًا محاولةً قريبةً، يعرضها الزركشي في: المنثور (2/84-86). ولأبي الحسن العامري، الفيلسوف (ت: 381 هـ) محاولةٌ لحصر العلوم المِلِّية في «ثلاث صناعات: إحداها: حسيةٌ، وهي صناعة المُحدِّثين، والثانية: عقليةٌ: وهي صناعة المتكلمين، والثالثة مشتركةٌ بين الحس والعقل: وهي صناعة الفقهاء» انظر: الإعلام بمناقب الإسلام (84). بينما ينظر الفارابي إلى الفقه باعتباره شاملا للآراء التي تشرع في الله، وفيما يوصف به، وفي العالم أو غير ذلك. انظر هذه الفكرة والتعليق عليها في: تمهيد لتاريخ الفلسفة (263-265).
([14]) انظر: رد المحتار، لابن عابدين الحنفي (6/354-357) حيث يبدأ بحث هذه المسألة بتعريف الإيمان، ومعنى التصديق، وحكم الإقرار ...، وعامة مصادره في البحث كلاميه، وبالأخص المسايرة وشرحها. وأما مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، من كتب الشافعية (4/134-135) ففيه: «.. فمن نفى .. الصانع، وهو الله سبحانه، وهم الدهرية الزاعمون أن العالم لم يزل موجودًا كذلك بلا صانع. فإن قيل: إطلاق (الصانع) على الله تعالى لم يرد في الأسماء الحسنى، وإنما ذلك من عبارات المتكلمين المجوزين الإطلاق بالاشتقاق، والراجح أن أسماءه تعالى توقيفية؟ أجيب ... أو نفَى ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع كالعلم والقدرة، أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع، كحدوثه، أو قدم العالم، كما قاله الفلاسفة، قال المتولي: أو أثبت له لونًا، أو اتصالًا، أو انفصالًا.
تنبيه: اختلف في كفر المجسمة. قال في المهمات: المشهور عدم كفرهم، وجزم في شرح المهذب في صفة الأئمة بكفرهم. قال الزركشي في خادمه: وعبارة شرح المهذب: من جسم تجسيمًا صريحًا، وكأنه احترز بقوله صريحًا عمن يثبت الجهة: فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي، وقال الشيخ عز الدين: إنه الأصح، وقال في قواعده: إن الأشعري رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة؛ لأن الجهل بالصفات ليس جهلًا بالموصوفات اهـ. وأُوِّل نصُّ الشافعي بتكفير القائل بخلق القرآن؛ بأن المراد كفران النعمة لا الإخراج عن الملة، قاله البيهقي وغيره من المحققين، لإجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموارثتهم ..» اهـ. والنصُّ؛ واضحٌ جدًّا فيما ذكرناه، من حيث مادته الكلامية، والتي بلغت التصرف في نص إمام المذهب الشافعي، وتأويله ليتفق مع نص إمام المذهب الأشعري!!
([15]) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد (6/220-222)، ثم بحثًا موسعًا مهمًّا في: مواهب الجليل، للحطاب (5/354-358).
([16]) انظر، على سبيل المثال: رد المحتار، على الدر المختار، لابن عابدين (2/242-246)، حيث يورد مسائل كلاميةً متعلقةً بالأنبياء والملائكة ..، بمناسبة التسليم من الصلاة. وانظر أيضًا: كتاب الكراهية، من البحر الرائق، شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي (8/204) وما بعدها، وهي فصولٌ كلاميةٌ صرفةٌ. وهذه مسألةٌ تستحق العناية والدراسة: اختلاط الأصول الكلامية، بالمصنفات الفرعية الفقهية، وأثر ذلك.
([17]) قارن: درء التعارض (8/3) وما بعدها.
([18]) انظر: الفروع، لابن مفلح (6/185-187). وقارن: درء التعارض (8/359).
([19]) الغياثي (61)، وانظر: أصول الدين عند الإمام الطبري (481-482)، ومصادر البحث هناك.
([20]) انظر: الإبهاج شرح المنهاج - في أصول الفقه - لتاج الدين السبكي (1/36-37)، البحر المحيط، للزركشي (1/22)، وربما كانت أصول هذه الفكرة عند الشهرستاني. انظر: الآمدي وآراؤه (126). وقد قام د. عبد العزيز العبد اللطيف، أستاذ بجامعة الإمام، بجهد مشكور في جمع مسائل الفروع الواردة في مصنفات العقيدة، واقتصر فيه صاحبه على كتب السلف، كما نص هو في مقدمة بحثه، ص (310)، وهي فكرة لطيفة، تحتاج إلى جمع أشمل، ودراسة أعمق مما قام به.
([21]) انظر: الانتصار للخياط (96، 107، 135، 141، 146)، وناقشت د. سهير مختار بعض ما نسب إلى الكرامية من المسائل الفقهية. انظر: التجسيم عند المسلمين (349) وما بعدها، وقارن: مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني، لأستاذنا د. محمد بلتاجي، رحمه الله (1/66-68، 78-81).
([22]) يقول أبو حامد، في جملة كلامه عن الاشتغال بعلمي الفقه والكلام، وأيهما أوكد: «نعم؛ من أنس من نفسه تعلم الفقه، أو الكلام، وخلا الصقع عن القائم بهما، ولم يتسع زمانه للجمع بينهما، واستفتى في تعيين ما يشتغل به منهما = أوجبنا عليه الاشتغال بالفقه؛ فإن الحاجة إليه أعم، والوقائع فيه أكثر؛ فلا يستغني أحد في ليله ونهاره عن الاستعانة بالفقه، واعتوار الشكوك المحوجة إلى علم الكلام نادر، بالإضافة إليه ..» اهـ، الاقتصاد في الاعتقاد (1/97 - مصطفى عمران).
([23]) ذكر البيهقي - مناقب الشافعي (1/199) وما بعدها - مناظرات فقهية للشافعي مع بشر المريسي، ويحكي ابن قتيبة - تأويل مختلف الحديث (46-48) - طرفا من شذوذات النظّام الفقهية. أما الخياط فيقول: «علم الموافق والمخالف مقدار جعفر بن مبشر في الفقه والكلام ..، ومن قرأ كتبه في الفقه وفي الكلام، مثل كتاب السنن والأحكام، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب الطهارة، وكتاب الأشربة ... عرف تقدمه في علم الفقه والكلام، والحديث والقرآن» اهـ الانتصار (134)، وانظر نموذجا لتجاذب فرع فقهي في البحث الكلامي عند العمراني في الانتصار (1/193).
([24]) الغياثي (239).
([25]) انظر: الإعلام بمناقب الإسلام، للعامري (109) وما بعدها.
([26]) السبكي: طبقات الشافعية (6/244)، ثم قال: «ولقد وجدت هذا واعتبرته، حتى في مشايخ الطريقة»!! وهي حال، نعاها الإمام الخطابي، بأسى بالغ، على (أهل الفقه)، و(أهل الحديث): «ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانًا متهاجرين وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين»!! اهـ معالم السنن (1/6).
([27]) يقول ابن تيمية، في أحد نصوصه الرائعة التي يؤرخ بها لتلك القضية: «واختلاف أهل البدع؛ هو من هذا النمط؛ فالخارجي يقول: ليس الشيعي على شيءٍ، والشيعي يقول: ليس الخارجي على شيءٍ، والقدري النافي يقول: ليس المثبت على شيءٍ، والقدري الجبري المثبت يقول: ليس النافي على شيءٍ، والوعيدية تقول: ليست المرجئة على شيءٍ، والمرجئة تقول: ليست الوعيدية على شيءٍ. بل ويوجد شيءٌ من هذا بين أهل المذاهب الأصولية والفروعية المنتسبين إلى السنة، فالكُلّابي يقول: ليس الكرّامي على شيءٍ، والكرامي يقول: ليس الكلابي على شيءٍ، والأشعري يقول: ليس السالمي على شيءٍ، والسالمي يقول: ليس الأشعري على شيءٍ، ويصنف السالمي كأبي على الأهوازي كتابًا في مثالب الأشعري، ويصنف الأشعري كابن عساكر كتابًا يناقض ذلك من كل وجهٍ، وذكر فيه مثالب السالمية. وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها، لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية، وخلط هذا بهذا ... وهذا من جنس الرفض والتشيع؛ لكنه تشيعٌ في تفضيل بعض الطوائف والعلماء، لا تشيع في تفضيل بعض الصحابة؛ والواجب على كل مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله: أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وطاعة رسوله، يدور على ذلك ويتبعه أين وجده ...» اهـ من منهاج السنة النبوية (5/260-262)، وانظر أيضًا: اقتضاء الصراط المستقيم (1/79، 127-129).
([28]) في الأصل: «عمر بن النضر»، وأشار محققه إلى نسختين: «عمرو»، وهو الصواب، وفي ترجمته من الميزان (4/210): «مجهولٌ، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه». وقد وقفت على الأثر مسندًا، من طريق عمرو بن النضر، عند الدارقطني في: أخبار عمرو بن عبيدٍ، رقم (15). وانظر أيضًا: ميزان الاعتدال (4/194).
([29]) قواطع الأدلة (5/117-118)، وانظر نماذج لمواقف مختلقة - بكل وضوح - لتكريس هذه الصورة، عند ابن المرتضى في: المنية والأمل (31-34).
([30]) يقول أبو حيان التوحيدي: «... ولقد حدثني علي بن المهدي الطبري، قال: قلت ببغداد لأبي بشر: لو نظرتَ في شيء من الفقه مع هذه البراعة التي لك في الكلام، ومع هذا اللسان الذي تحير فيه كل خصم. قال: أفعل، قال: فكنت أقرأ عليه بالنهار مع المختلفة الكلام، وكان يقرأ علي بالليل شيئًا من الفقه، فلما كان بعد قليل أقصر عن ذلك، فقلت له: ما السبب؟ قال: والله ما أحفظ مسألةً جليلةً في الفقه، إلا وأنسى مسألةً دقيقةً في الكلام، ولا حاجة لي في زيادة شيء يكون سببًا لنقصان شيء آخر مني». الإمتاع والمؤانسة (2/35-36).
انقر هنا للوصول إلى صفحة الكتاب كاملاً.
انقر على الصورة للوصول إلى النسخة المصورة (pdf) قابلة للتحميل والنشر.