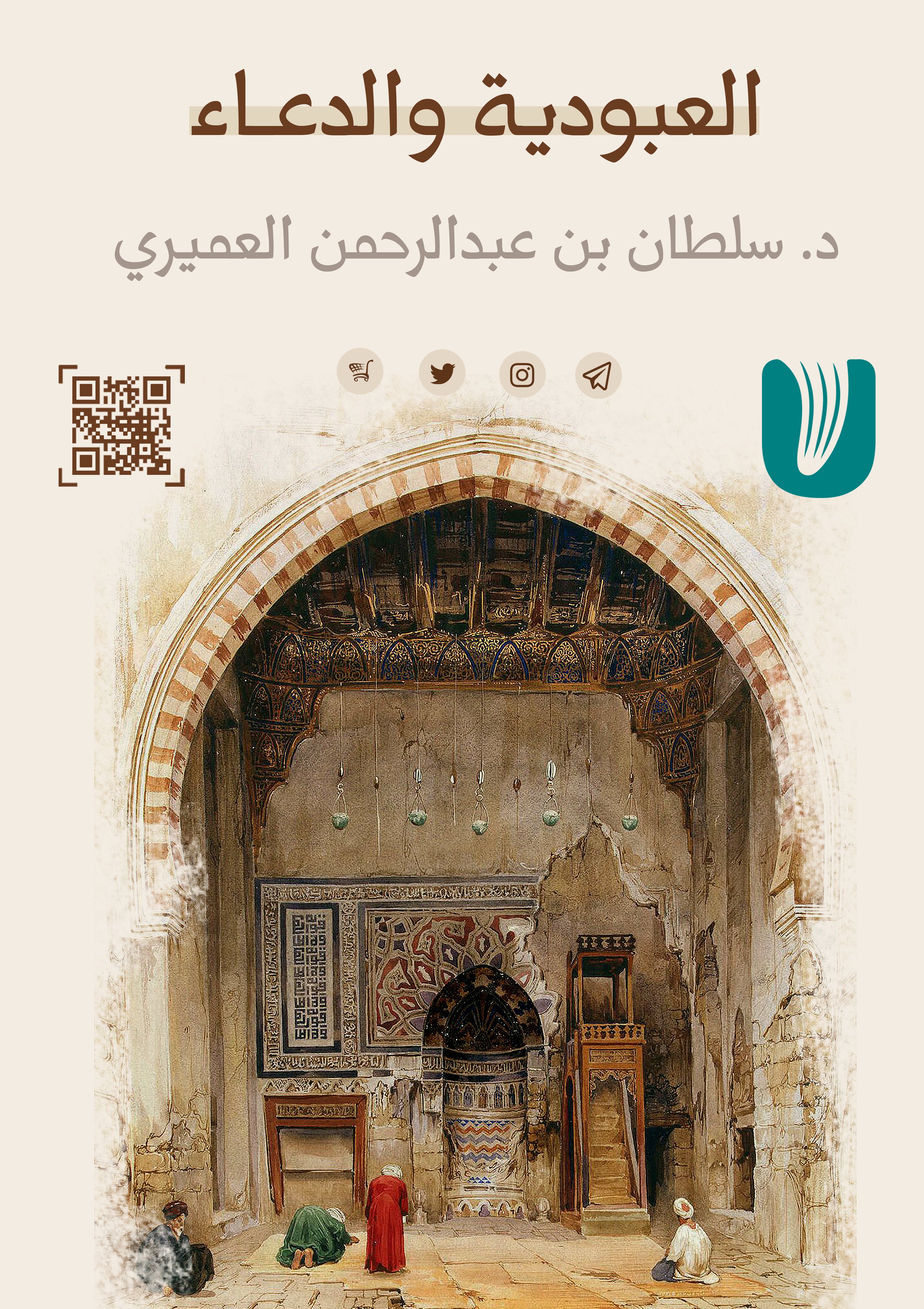العبودية والدعاء
د.سلطان بن عبدالرحمن العميري
في شرحه للوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية
كان الدعاء من أجل العبادات وأكرمها على الله لأنه يتضمّن معانٍ من العبودية لا تكاد تجتمع في غيره من العبادات، ومنها:
المعنى الأول: الدعاء يتضمّن إعلان الفقر وإظهار الحاجة لله سبحانه وتعالى.
المعنى الثاني: الدعاء يتضمّن إعلان غنى الله سبحانه وتعالى وعزّته وجبروته.
المعنى الثالث: الدعاء يتضمّن إخلاص التوجّه إلى الله وتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى.
فالمسلم حين يدعو الله عز وجل يُعلن أنه لا يلتفت لأحدٍ من الخلق، وإنما يتوجّه إلى الله سبحانه وتعالى.
المعنى الرابع: الدعاء فيه إظهارُ الصدق والمحبّة لله سبحانه وتعالى، فالمسلم حين تنزل به حاجة أو يريد أي شيء ولو كان ضئيلاً يتوجه إلى محبوبه.
المعنى الخامس: الدعاء فيه إظهار التوكل والإنابة على الله سبحانه وتعالى.
فالدعاء يتضمّن هذه المعاني الإيمانية، ولهذا كان الدعاء من أجلّ العبادات ومن أكرمها على الله I، فالمسلم حين يرفع يديه ويتوجّه بقلبه إلى الله هو في الحقيقة لا يمارس عملاً واحداً، وإنما يمارس أعمال كثيرة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس شيء أكرم الله من الدعاء"([1]).
ومن الدروس التربوية ضرورة الحرص على إظهار هذه المعاني في الدعاء، فالمسلم إذا دعا الله تعالى فلا بد أن يستحضر أن فعله هذا يتضمن عدد من أنواع العبادات وليس خاصا بطلب حصول المطلوب فقط.
يقول المؤلف: "فإنه مفتاح كل خير" وإنما كان الدعاء مفتاح كل خير لكثرة ما يترتب عليه من الخيرات والبركات، فهو من أعظم الأعمال التي تحقق عبودية الإنسان لربه، ومن أعظم ما يستجلب به العبد محبة الله له، وهو من أعظم العبادات التي تترتب عليها الأجور الكثيرة، وبه يستجلب الخير من الله، وبه تدفع به الشرور والأضرار، وبه ترفع بعد وقوعها، وبه يثبت المسلم أمام أعدائه وينتصر عليه، وبه يحقق الطمأنينة لنفسه.
قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: "تذكرتُ ما جماعُ الخيرِ فإذا الخيرُ كثيرٌ؛ الصومُ والصلاةُ وإذا هو في يدِ اللهِ عز وجل وإذا أنتَ لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أنْ تسأَلَهُ فيعطيَك فإذا جماعُ الخير الدعاء"([2]).
يقول المؤلف: "ولا يعجل، فيقول: قد دعوتُ، فلم يُستجب لي" يشير المؤلف إلى نوع من أنواع الخلل الواقع في الدعاء، وهو الاستعجال، وضابط الاستعجال: إظهار التذمر من عدم الاستجابة، وترك الدعاء عند عدم حصول المطلوب.
هذا الضابط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال يستجاب للعبد، ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت، فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء"([3]).
فهذا الحديث يدل على أن الاستعجال المذموم يتضمن أن المسلم يتكلّم ويتلفّظ ويقول دعوتُ ودعوت، يظهر التذمّر بالكلام، فيستحسر ويقع في قلبه اليأس ويترك الدعاء.
وقوله: "إظهار التذمر"، قيد مهم يخرج أمورا متعددة مما لا تدخل في الاستعجال المذموم:
الأمر الأول: التألم القلبي، فإذا وقع في قلب المسلم نوعٌ من الألم والحسرة على أنّ الله لم يستجب له، هذا لا يدخل في الاستعجال، إلا إذا استقرّ هذا الألم وأصبح مؤثراً على الإنسان.
أمّا إذا تألم الإنسان ووجد في نفسه حُزناً، أو وجد في نفسه قدرٌ من الضيق، فإنّ هذا لا إشكال فيه، ولا يُعدُّ استعجالاً.
فكم من مسلم لديه أمنية دعا الله عز وجل بها كثيراً، وسنواتٍ طويلة لكن لم يستجب الله له! وربما يتذكّر في يومٍ من الأيام هذه الأمنية وأنه دعا الله عز وجل ولم يتحقّق له مطلوبه، فيأتي في قلبه نوعٌ من الحُزن أو قدرٌ من الضيق، فهذا لا يدخل في الاستعجال المذموم. وإنما هذا أمر طبيعي لا يطالب المسلم بعدم وقوعه، وإنما يطالب بعدم الخضوع له.
الأمر الثاني: تمنّي سرعة المطلوب، يعني الإنسان يدعو الله عز وجل بشيء ويتمنّى أن يقع سريعاً، فهذا لا يدخل في الاستعجال.
الأمر الثالث: دعاء الله عز وجل بالتعجيل، كأن يقول المسلم: اللهم ائتني بهذا الأمر عاجلاً غير آجل، اللهم عجّل لي هذا الأمر، اللهم عجّل لي تحقيق هذا الأمر، فالدعاء بالتعجيل لا يدخل في الاستعجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم هذا النوع من الدعاء في الاستسقاء، فقال: "عاجلاً غير آجل"([4]).
علاقة الدعاء بقاعدة الأسباب:
من القواعد المهمة في التعامل مع الدعاء، هي أنّ الدعاء سببٌ من الأسباب، وبناءً عليه، تنطبق عليه قاعدة الأسباب.
وقاعدة الأسباب: أنه ما من سبب إلا له شروط لا بد من توفّرها، وله موانع لابد من انتفائها، فلا يؤدي السبب إلى مسببه إلا بتوفرها، وقد كرر ابن تيمية هذه القاعدة كثيرا في كتبه، وقرر عمومها في كل الأسباب ولم يستثن منها شيئا، ومن ذلك قوله: "حقيقة الوعيد بيان أن هذا الفعل سبب في هذا العذاب"([5])، يقول أيضا: "فائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب"([6])، ولهذا قال ابن تيمية بعد كلامه السابق: "السبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه"([7]).
وهي قاعدة مهمة تعيننا على فقه باب الأسباب، وفقه باب الدعاء، ومعنى هذا: أنه ليس كل دعاء مستجاب، فقد يدعو الإنسان بدعاء، لكن لم تتوفر له شروط الاستجابة، فلا يُستجاب له.
وقد يدعو الإنسان بدعاء فيه شروط الاستجابة، لكن عنده مانع، مثل الأكل من الحرام، أو الظلم، أو الاستعجال، فلا يُستجاب له، لأنه لم تنتف عنه كل الموانع. فهذه قاعدة من القواعد المهمة في فقه التعامل مع باب الأسباب.
الحكمة من تأخير استجابة الدعاء أو عدمها:
في هذا الموضع عادةً ما تذكر مسألة من المسائل الإيمانية المهمة، وهي ما الحكمة من عدم الاستجابة؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يؤخر الاستجابة على عدد من الناس؟
هناك عدد من الحِكم([8])، وسنذكر هنا سبع حكم:
الحكمة الأولى: الابتلاء والامتحان، وهذه أصلُ الحِكَم، فالله عز وجل قد يبتلي بعض الناس بعدم استجابة دعائه.
ومفهوم الابتلاء أوسع من المصائب، فالله عز وجل قد يبتلي بعض الناس بمرض، وقد يبتلي بعض الناس بشُبهة، وقد يبتلي بعض الناس بعدم استجابة دعائه، وقد يبتلي بعض الناس بصديق مُفسد، وقد يبتلي بعض النساء بزوج غير صالح، وقد يبتلى بعض الناس بولد عاف، فابتلاءات الله عز وجل متعددة.
فإذا صبر المسلم على هذا البلاء كفّر الله به كثيرا من ذنوبه وسيئاته.
ومن معاني الابتلاء المتعلقة بتأخير الاستجابة أو عدمها: أنّ الله عزّ وجل قد يبتلي بعض الناس بذلك، ليختبر حُبّه له، أو يخبر صبره، ويختبر إيمانه بالله سبحانه وتعالى.
الحكمة الثانية: أنّ المطلوب قد يكونُ شراً للإنسان، فقد يطلب المسلم من الله عز وجل شيئا معينا، ويكون شرٌ عليه في العاجل أو في الآجل، فلا يعطيه الله مطلوبة، أو يؤخر عنه مطلوبه حتى يزول الشر الذي فيه رحمة به.
وقد يكون عدم المطلوب أكثر خيراً للعبد من المطلوب في العاجل أو الآجل من حيث لا يعلم، فلا يحقق الله له مطلوبه لأنه يريد له الخير.
وقد روي عن بعض السلف: أنه كان يسأل الله الغزو، فهتف به هاتف: إنك إن غزوت، أسرت، وإن أسرت، تنصرت([9]).
وقال ابن مسعود: "إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيظل يتطير يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل"([10])، وهذا يشمل عدم استجابة الدعاء.
الحكمة الثالثة: قد يكون الدعاء والاستمرار فيه خير للإنسان، يعني أنّ الله سبحانه أراد للإنسان منزلةً عاليةً في الجنة، لكنّ أعماله لا تؤهله لبلوغ هذا المنزلة إلا بدعائه، فإن كان يُكثر الدعاء والتضرّع بين يدي الله عز وجل والانكسار بين يديه والإخبات، فالله عز وجل لا يستجيب له حتى يُكثر الإنسان من هذا الدعاء، فتكثُر حسناته، فيعلو إلى الدرجة التي أرادها الله له في الجنّة.
في بعض الآثار أنّ عابداً من بني إسرائيل دعا الله عز وجل سنوات كثيرة فلم يُستجب له، فيَأِس وترك الدعاء، فسمع مُنادياً يقول: يا عبدي لو استجبتُ لك لانقطعتَ عن الدعاء([11])، فالله عز وجل أراد منك أن تستمر في العبادة حتى تعلو درجتك عنده سبحانه وتعالى.
الحكمة الرابعة: استثارة قلب المسلم إلى مراجعة حاله، والانكسار بين يدي الله، وذلك أن عدم قبول دعوة المسلم وطلبه تجعله يرجع إلى نفسه باللائمة، ويقول لها: إنما لم يستجب الله لي بسبب تقصيرك، يظهر مزيدا من الرجوع إلى خالقه ومحبوبه، ومزيدا من الانكسار بين يديه ليحظى بالقبول عنده، وهذا الحال من أعظم العبادات التي يحبها الله تعالى.
وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات؛ فإن يوجب انكسار العبد لمولاه، واعترافه له بأنه ليس بأهل لإجابة دعائه فلذلك يسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله، على قدر الكسر يكون الجبر([12]).
وفي بعض الأخبار عمن مضى أن رجلا تعبد زمانا، ثم طلب إلى الله عز وجل حاجة، وصام لله سبعين سبتا؛ يأكل كل سبت إحدى عشرة ثمرة، يطلب حاجته إلى الله، فلم يُعْطَها، فلما مضى ذلك ولم يعطها أقبل على نفسه، فقال: من قِبَلك أُتيت، لو كان فيك خير أعطيت حاجتك، ولكن ليس فيك خير، فنزل إليه ملك من ساعته، فقال: يا ابن آدم، إن ساعتك هذه، التي أزريت على نفسك فيها، خير من عبادتك، قد أعطاك الله حاجتك"([13]).
الحكمة الخامسة: أنّ الدعاء قد يكون ضعيفاً، ففي بعض الأحيان، فلا يستجيب الله لعبد لأن دعاؤه الذي قدمه ضعيف، إما أنه لم يقدمه بتضرع أو أنه فاقد لبعض أسباب الاستجابة أو غيره ذلك، فيمنع العبد استجابة الدعاء لأجل ضعف دعائه، فيسعى إلى تكميله وتقويته.
يقول ابن القيم عند الدعاء: "له مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء، فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه، وإن كان ضعيفا. الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه"([14]).
الحكمة السادسة: أنّه قد يوجد عند الإنسان مانع من استجابة الدعاء، فالذي يدعو الله عز وجل، ولم يستجب الله له، فليتفقّد نفسه، ربما يكون عنده مظالم للناس أو اعتداء على أعراضهم ويدنهم، ربما يأكُل من الحرام، وغذّى نفسه من الحرام، فيسعى إلى التخلص من ذلك كله، يقول صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المُرسلين؛ فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا [المؤمنون:51]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:172]، ثم ذكر الرجلَ يُطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأنَّى يُستجاب له؟!"([15]).
الحكمة السابعة: أنّ الله عز وجل قد يُحبُّ صوت هذا العبد الداعي، ويُحبّ عبادته، ويحب بكاؤه، ويحب تضرّعه بين يديه، فيؤخّر عنه الاستجابة، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنْ لو أعطاه ما أراد سينقطع عن عبادته.
وعن كردوس بن عمرو قال: "فيما أنزل الله عز وجل من الكتب أن الله عز وجل يبتلي العبد وهو يحبه؛ ليسمع تضرعه"([16])، وجاء في الآثار: "إن العبد إذا دعا ربه وهو يحبه، قال: يا جبريل، لا تعجل بقضاء حاجة عبدي، فإني أحب أن أسمع صوته"([17]).
يقول ابن القيم رحمه الله: "الله تعالى يبتلى عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه، وقد ذم سبحانه من لم يتضرع اليه ولم يستكن له وقت البلاء، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه، والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه، بل أراد منه أن يستكين له، ويتضرع اليه"([18])، وفي بعض الكتب السابقة: إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه([19]).
فإذا عرفنا أنّ الله عز وجل يُحب منا الدعاء، سنُكثر من الدعاء، حتى لو لم يُستجب لنا، لأنّ الله عز وجل يحب هذا العمل، وهذه حكمة من الحكم الجليلة التي ينبغي على المسلم أن يستحضرها كثيراً.
من أهم الدروس الإيمانية والتربوية من معرفة هذه الحكم أن المسلم يلزم نفسه بالرضا عن الله تعالى وعن تقديره، فالرضا بالله وتدبيره من أعظم المقامات وألطف الأحوال التي يعيشها العبد مع ربه.
وهذا المعنى من أعظم المعاني التي يتفاضل فيه الناس في مسيرهم إلى الله تعالى وتعاملهم مع تقديره وتدبيره، فإذا وصل المسلم إلى الرضا عن الله فقد زاد حاله عبادة وتذللا وخضوعا.
وقد كان للسلف الصالح اهتمام خاص بالرضا عن الله والتسليم لتدبيره، يقول محمد بن علي الباقر: "ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما أحب"([20])، ويقول عمر بن عبد العزيز: "ما لي في الأمور هوى سوى مواقع قضى الله عز وجل فيها"([21]).
ويقول معاذ بن يحيى: "إذا كنت لا ترضى عن الله كيف تسأله الرضا عنك؟"([22])، ويقول أبو عثمان النهدي: "منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته، ولا نقلني إلى غيره فسخطته"([23])، ويقول عبد الواحد بن زيد: "الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا، ومستراح العابدين"([24]).
يقول المؤلف: "وليتحرّى الأوقات الفاضلة: كآخر الليل، وأدبار الصلوات، وعند الأذان، ووقت نزول المطر، ونحو ذلك".
ذكر المؤلف هنا أدبا من آداب الدعاء، وهو تحرّي الأوقات الفاضلةـ التي هي مظنة الاستجابة.
وفي هذه القضية لا بد من التنبيه على ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن تحديد الأوقات الفاضلة في الدعاء أمر توقيفي لا يصح إلا بناءً على النصوص الشرعية، والنصوص الشرعية جاءت في تحديد كثير من هذه الأمور.
الأمر الثاني: أن النصوص الشرعية لم تحدد كل الأوقات التي هي مظنة استجابة الدعاء، وإنما ذكرت منها قدرا، وبقي قدر آخر اخفته عن المكلفين ليجتهدوا في تحريه.
ومما يدل على ذلك قال عليه الصلاة والسلام: "إن في الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة"([25])، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم"([26]).
ومقتضى هذا أنه ينبغي على المسلم أن يجتهد في الدعاء والتضرع في كل لحظة من لحظات الليل لعله يصادف تلك الساعة.
الأمر الثالث: اختلفت مسالك العلماء في تحديد ما هو مظنة الاستجابة، فمنهم من يذكرها إجمالا ويسمها أوقاتا كما ذكر المؤلف، ومنهم من يفرق بينها، ويقسمها إلى أسباب زمانية ومكانية وحالية، والمقصود بها حال الداعي من الافتقار والاضطرار وغيرها من الأحوال.
قوله: "كآخر الليل، وأدبار الصلوات، وعند الأذان، ووقت نزول المطر، ونحو ذلك"، ذكر المؤلف هنا جملة من الأوقات الفاضلة التي جاء ذكرها في النصوص.
وجملة ما ذكره المؤلف أربعة أوقات، ونحن سنضيف عليها غيرها:
الوقت الأول: الثلث الأخير من الليل. وهذا الحديث فيه مشهور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني، فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له"([27]).
الوقت الثاني: أدبار الصلوات، فعن أبي أمامة، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات"([28]).
وقد اختلف العلماء في تحديد المراد بأدبار الصلوات على قولين:
الأول: أنه بعد الانتهاء من الصلاة، أي بعد السلام.
الثاني: أنه في آخرها قبل السلام، وقد اختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم([29]).
والأقرب أن الإنسان يفعلها في كلا الأمرين. إما بعد الصلاة بعدما ينتهي من الأذكار، أو قبل السلام.
الوقت الثالث: عند الأذان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثنتان لا تردان، أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً "([30]).
الوقت الرابع: بين الأذان والإقامة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة"([31]).
الوقت السادس: عند نزول المطر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت المطر"([32]).
الوقت السابع: ساعة يوم الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة فقال: "فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها"([33]).
وقد اختلف العلماء كثيرا في تحديد ساعة الجمعة، ورجح عدد من العلماء أنها آخر ساعة من الجمعة([34]).
ولا بد من التنبيه على أن المراد بالساعة هنا اللحظة من الزمان، وليس المقدار الذي يساوي ستين دقيقة.
الوقت الثامن: في السجود، يقول صلى الله عليه وسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء"([35]).
الوقت التاسع: دعوة الصائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم ودعوة المسافر"([36]).
الوقت العاشر: الوقت الذي يكون المسلم فيها مسافرا، للحديث السابق، ويصح أن يجعل هذا الأمر من الحال وليس من الأوقات.
الدروس التربوية والإيمانية المتعلقة بالدعاء:
الدرس الأول: يحب أن يتذكر المسلم دائما أن محركات النفس إلى الدعاء متعددة وليست محصورة في طلب الحاجة من الله، فالمسلم يدعو الله لأن الله يحب الدعاء؛ ويدعوه سبحانه لأنه بالدعاء يحقق القرب منه سبحانه ويقوم بعبادة من أجل العبادات، ويدعو لأنه يريد حاجته م الله.
فمن أهم ما ينبغي على المسلم استحضاره في الدعاء أنه يقوم بهذه العبادة الجليلة لعدد من الأغراض وليس لغرض الحاجة فقط، واستحضار هذا الأمر يجعل للدعاء طعما خاصة يتلذذ به المسلم ويسعد به في حياته.
الدرس الثاني: إدراك سعة فضل الله وكرمه، فإن الله تعالى جعل أوقاتا تكون مظنة لاستجابة الدعاء، وهذه الكثرة تدل على ما يريده الله تعالى لعباده من الرحمة والفضل، فما كثرة أوقات الاستجابة ولا تعدد أسبابها إلا لأنه يريد رحمة عباده سبحانه.
الدرس الثالث: أن الدعاء من أكثر الحالات التي تذكر الإنسان بفقره إلى خالقه ومولاه، وتظهر عجزه وحاجته وتكشف عن انكساره وإخباته، وهذه المعاني من أجل المقامات الإيمان والأحوال التربوية، فلا بد أن يحافظ عليها المسلم ويكثر منها، فإنه كلما أكثر منها ومن إظهارها ازداد شرفا وعلوا وقربا من الله تعالى.
الدرس الرابع: استحضار العناية الإلهية، فإن الدعاء وما يرتبط به من أقوى ما يظهر عناية الله بخلقه ورعايته لهم مه أنه سبحانه غني عنهم، وهو يدل على محبته لهم ورحمته بهم.
فالله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويطلب من عبادته عرض دعواتهم وحاجاتهم واستغفارهم، ليحققها لهم ويستجيبها لهم، ويكرر حثهم على دعائه وعرض حاجاتهم عليه.
فهذا من أعظم ما يزيد الطمأنينة في نفوس المسلمين ويغرس السكينة فيها، فالله تعالى خالقهم ورازقهم معتن بهم وقائم على رعايتهم.
يقول: "وأما أرجح المكاسب: فالتوكل على الله، والثقة بكفايته، وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمُهتّم بأمر الرزق، أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه، فيما يأثُر عنه نبيه: "كلكم جائع إلاّ من أطعمتُه، فاستطعموني أُطعمكُم. يا عبادي كُلُّكُّم عارٍ إلا من كسوتُه، فاستكسوني أكسُكُم"
وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليسأل أحدكم ربّه حاجته كلها، حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم يُيّسرهُ لم يتيّسر".
وقد قال الله تعالى في كتابه: (واسألوا الله من فضله). وقال سبحانه: (فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)، وهذا وإن كان في الجمعة، فمعناه قائم في جميع الصلوات.
ولهذا، والله أعلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: " اللهم افتح لي أبواب رحمتك" وإذا خرج أن يقول: " اللهم إنيّ أسألك من فضلك" وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم (فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له) وهذا أمر، والأمرُ يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأُ إليه في أمر الرزّق وغيره أصلٌ عظيم".
قوله: "وأما أرجح المكاسب: فالتوكل على الله، والثقة بكفايته، وحسن الظن به" انتقل المؤلف إلى موضوع آخر من المواضيع التي سأل عنها السائل، وهي: أرجح المكاسب.
وسؤال أبي القاسم محتمل، فيحتمل أنه يقصد أرجح المقاصد مطلقا، فيدخل فيها ما يشمل الدين والدين، ويكون جواب المؤلف متطابقا مع مقصود السائل، وإما أن يكون مقصوده السؤال عن أرجح المكاسب الدنيوية، فيكون جواب المؤلف متضمنا لمعنى إيماني مهم، حاصله أن النظر في المكاسب الدنيوية يجب أن يكون بالنظر في المكاسب الأخروية، ولهذا جعل أرجح المكاسب تحقيق التوكل على الله والثقة به وحسن الظن به، فهذه المعاني الإيمانية لا بد أن تكون مصاحبة لطلب المكاسب الدنيوية.
وترجع حقيقة هذه المعاني إلى قطع التعلق بالخلق وتفويض الأمر إلى الخلق سبحانه، ولهذا يقول الإمام أحمد عن التوكل: "هو قطع الاستشراف باليأس من الخلق"([37])، ويقول ابن حبان: "التوكل هو قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق"([38]).
وهذا الموضع من أعظم المواضع التي يفترق فيها الإسلام عن المادية والعلمانية، فإنهم لا ينظرون في طلب المكاسب الدنيوية إلا الجانب المادي فقط، وأما في الإسلام فإن النظرة تختلف تمام الاختلاف، ولأجل هذا كان النظر في المكاسب الدنيوية متضمنا بالضرورة للنظر في المكاسب الأخروية؛ لأن المسلم لا يمكن أن يستغني عن إعانة ربه والاستمداد منه في طلب ما يكسبه في دنياه، فكانت نتيجة ذلك أن طلب المكاسب عند المسلم مركب من أمور دينية ودنيوية.
ومن المعاني الإيمانية التي يحسن التنبيه عليها في هذا المقام أن التوكل على الله عز وجل ليس محصوراً في الأمور الدنيوية، وإنما هو شامل حتى الأمور الدينية، ومعنى ذلك: أن الإنسان يتوكل على الله في تحقيق العبادات، ويتوكل على الله عز وجل في تحقيق الهداية وبلوغ الرشاد.
وهذا المعنى ربما لا يستحضره كثير من الناس، فإذا سمع قول الله U: (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)، يظن أن المقصود أن نتوكل على الله في الزواج مثلا أو الوظيفة، أو في غيرها من الأمور الحياتية.!
هذا من القصور في التعامل مع معنى التوكل، فالتوكل على الله عز وجل شامل لكل ما تطلبه أنت أيها الإنسان، وأعظم ما يطلبه الإنسان العبودية لله سبحانه وتعالى، والإيمان به، وتحصيل الهداية، فمن أعظم الأمور التي نتوكل فيها على الله، هو أن نحقق العبادة لله سبحانه وتعالى.
فكم مّن إنسان ضل طريق الهداية ومن أسباب ذلك أنه لم يتوكّل على الله في فقه الدين، وفي النظر في النصوص، فضلّ.
فيجب على الإنسان أن يعتمد على الله تعالى في تحصيل الهداية من نصوص الوحي، ويبذل الأسباب الشرعية المناسبة لذلك كطلب العلم وسؤال العلماء، ويجب عليه أن يحذر من الغفلة عن الاعتماد عن الله أو يعتمد على نفسه حدها، فإن في ذلك الهلاك والضلال.
يقول المؤلف: "والثقة بكفايته"، ظاهر كلام المؤلف أن الثقة بالله تختلف عن التوكل عليه سبحانه ولهذا عطف بينهما، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من مدارج ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين الثقة بالله، في منزلة أخرى وذكر التوكل على الله في منزلة، ففرّق بين المنزلتين.
يمكن أن يٌقال في الفرق بينهما: الثقة توكّل وزيادة، إي: أن الثقة بالله من أعلى درجة من التوكّل، وهي تعني تفويض الأمر إلى الله مع بذل الأسباب وزوال الخوف.
ففيها إضافة زوال الخوف، يعني أن الإنسان يتوكل على الله ويفوّض الأمر إلى الله ويعمل بالأسباب، مع قدرٍ من زوال الخوف، أو قلّة الخوف.
يقول أبو حازم: "كيف أخاف الفقر ولمولاي ما في السموات وما في الأرض، وما بينهما وما تحت الثرى؟!"([39]).
يقول المؤلف: "وحُسن الظن به" ضابط حُسن الظن: توقع التوفيق والعطاء من الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب، ولهذا فحسن الظن بالله حقيقة مركبة من عمل القلب وعمل الجوارح.
وحسن الظن بالله فيه معنى التوقع، وهو قدر زائد على معنى التفويض، فالتوكل، أنّ يفوّض المسلم أمره إلى الله ثم إذا أضاف في قلبه توقّع الخير فهذا حسن الظن بالله، فإذا أضاف إلى ذلك زوال الخوف أو قلّته فهذه منزلة الثقة بالله سبحانه وتعالى.
فهذه ثلاث مراتب، هي مترابطة متلازمة فيما بينها، وهذه فروق دقيقة بينها.
يقول المؤلف: "وذلك أنه ينبغي للمُهتّم بأمر الرزق، أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه" المراد بالرزق هنا كل ما ينتفع به الإنسان دنياه، لأن المؤلف قد سئل عنه بخصوصه، والرزق في معناه الشرعي أوسع من ذلك، فهو يشمل هو كل ما يحصل به الانتفاع في الدين والدنيا، أو الدنيا والآخرة.
وبناء على هذا التعريف فمن أعظم أنواع الزرق ما يتعلق بالدين والهداية إلى الحق، فالالتزام بالفرائض رزق، وقيام الليل زرق، والاشتغال بالعلم رزق، والعمل في الدعوة إلى دين الله رزق.
وينبغي على المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى في طلب هذه الأرزاق مثلما يلجأ إليه سبحانه في طلبه الأرزاق الدنيوية، بل أكثر.
فإذا أردت قيام الليل، فالجأ إلى الله وادعوه، إذا أردت الاستمرار في طلب العلم، فالجأ إلى الله وادعوه، إذا أردت حُسن الصلاة وحُسن أدائها، فالجأ إلى الله وادعوه.
وإدراكنا للمعنى الصحيح للرزاق ومعرفة سعته وشموله له أثر بليغ في فهم عدد من النصوص الشرعية، ومنها: قول النبي e: "وإن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يُصيبه"([40]).
فإنك ترى كثيرا من الناس أول ما ينقدح في ذهنه حين يسمع هذا الحديث الرزق في الأمور الحياتية، من مال وصحة ونحوهما.
وهذا التصور فيه قصور، فمن أول ما يدخل في هذا الحديث الرزق في أمر الدين، فربما يُحرم الإنسان قيام الليل لأنّه فعل ذنبا، وربما يحرم الإنسان الاستمرار في طلب العلم لأنه فعل ذنباً، لأن وربما يحرم الإنسان من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بسبب فعله للذنب، لأن قيام الليل وطلب العلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نوع من الرزق.
قول المؤلف: "وذلك أنه ينبغي للمُهتّم بأمر الرزق، أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه" ظاهر كلام المؤلف أن ثم فرق بين اللجوء والدعاء، وهذا هو الظاهر.
فاللجوء: أعلى مقاما من الدعاء، ففيه معنى الالتجاء والاستناد، والاستناد أعلى من معنى الطلب، فالدعاء يعني الطلب، ودعوته: يعني طلبته، لكن لجأ إليه: فيه أنه استند إليه، واعتمد عليه وفوض أمره إليه،
فأصل معنى اللجوء يرجع إلى الاستناد، وهذا المعنى أخصّ من الطلب، ولهذا فاللجوء أخصّ من الدعاء، وهو من درجات الدعاء العالية.
قوله: "يلجأ فيه إلى الله ويدعوه" هذا تنبيه من المؤلف على أن المسلم يجب عليه في كل أحواله ألا يغفل عن الله تعالى ويعتمد عليه نفسه أو تخطيط غيره له، فالمسلم متعلق قلبه بالله في كل شيء، ومعتمد على الله في كل شيء، ومفوض أمره على الله في كل شيء.
فأول ما يستجلب به الخير هو دعاء الله والتوكل عليه، فهذه الأمور أول خطوات الفلاح والنجاح والتوفيق.
فالمسلم يختلف عن المادي والعلمانية، فإنه إذا عنت له حاجة أو نزلت به قضية، فأول ما يلتفت إليه نظره عطاء الله وكرمه وجوده وتوفيقه، فيتوجه قلبه إلى أبواب السماء ويخضع فؤاده وبصره لخالقه ورازقه، وأما المادي فإنه إذا نزلت به حاجة أو قضية فأول ما يلتفت إليه نظره قدراته الشخصية وتخطيطه ومهاراته والقوى الأرضية.
____________________________________________________
([1]) رواه أحمد (8748)، والبخاري في الأدب المفرد (712)، والترمذي (3370).
([2]) الزهد، للإمام أحمد (1330).
([3]) رواه مسلم (7036).
([4]) رواه أبو داود (1169)، وابن خزيمة في صحيحه (1494).
([5]) الفتاوى، ابن تيمية (20/255).
([6]) المرجع السابق (12/484).
([7]) المرجع السابق.
([8]) انظر: صيد الخاطر، ابن الجوزي (82)، فقد ذكر ست حكم.
([9]) صيد الخاطر (83).
([10]) جامع العلوم والحكم (2/559).
([11])
([12]) مجموع رسائل ابن رجب (3/174)، وانظر: جامع العلوم والحكم (2/589).
([13]) الزهد، الإمام أحمد (81).
([14]) الجواب الكافي (10).
([15]) رواه مسلم (2309).
([16]) الفرج بعد الشدة، ابن أبي الدنيا (ص 41-42).
([17]) جامع العلوم والحكم (3/1158).
([18]) عدة الصابرين (36).
([19]) مجموع رسائل ان رجب (3/170).
([20]) حلية الأولياء (3/187)، والرضا بقضاء الله، ابن أبي الدنيا (106).
([21]) الرضا بقضاء الله، ابن أبي الدنيا (49).
([22]) صفة الصفوة (2/293).
([23]) حلية الأولياء (10/244).
([24]) حلية الأولياء (6/156).
([25]) رواه مسلم (757).
([26]) رواه مسلم (3009).
([27]) البخاري (1145).
([28]) رواه الترمذي (3499)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (108)، وغيرهما.
([29]) انظر: زاد المعاد(1/305)، وفتح الباري ، ابن حجر (2/328)، شرح المصابيح، ابن ملك (2:45).
([30]) رواه أبو داود (2540)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3079)
([31]) رواه أبو داود (521) والترمذي (212) وانظر صحيح الجامع (2408).
([32]) رواه أبو داود (3450)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3078).
([33]) رواه البخاري (935) ومسلم (852).
([34]) انظر: زاد المعاد، ابن القيم (1/378) وما بعدها.
([35]) رواه مسلم (482).
([36]) رواه البيهقي () وهو في الصحيحة (1797).
([37]) التبصرة، ابن الجوزي (1/112)
([38]) روضة العقلاء (156)
([39]) القناعة، ابن أبي الدنيا (49).
([40]) رواه أحمد (22386)، وابن ماجه (4022)، وابن حبان في صحيحه (872).
انقر هنا للوصول إلى صفحة الكتاب كاملاً.
انقر على الصورة للوصول إلى النسخة المصورة (pdf) قابلة للتحميل والنشر.