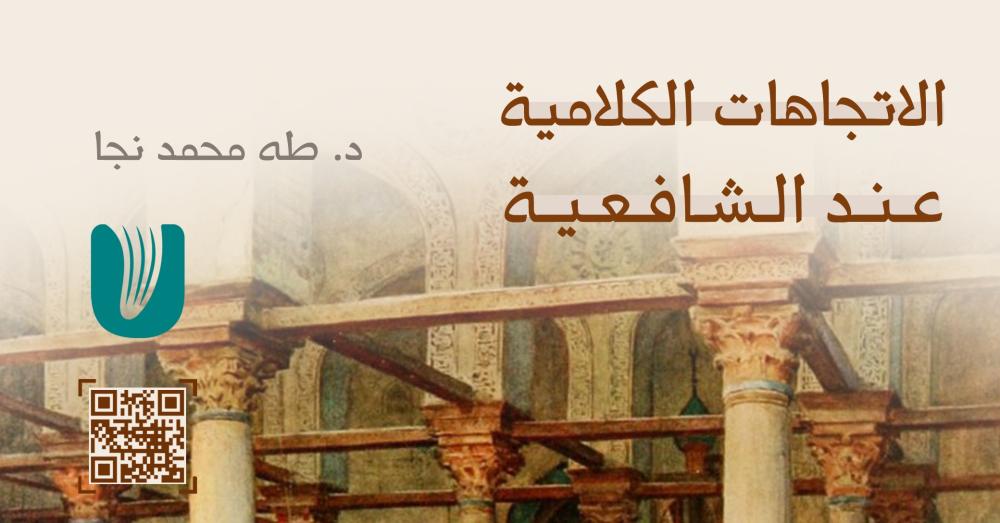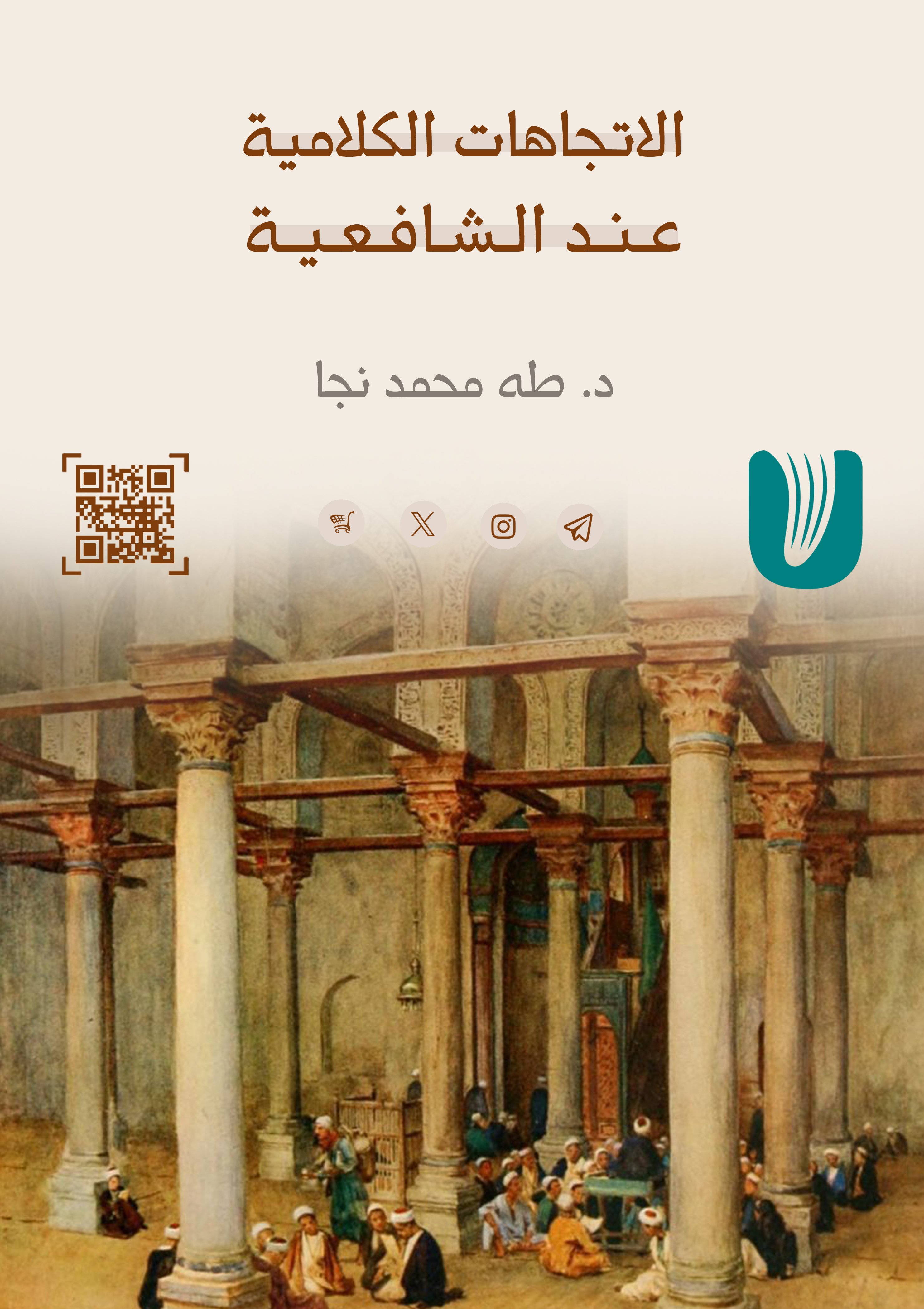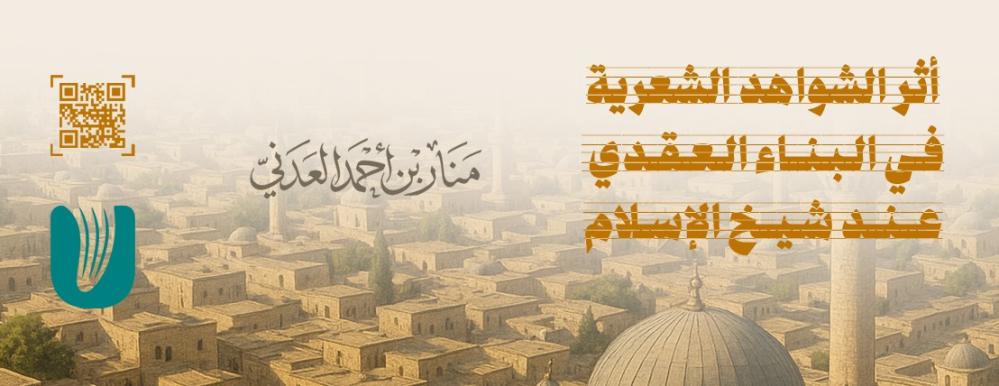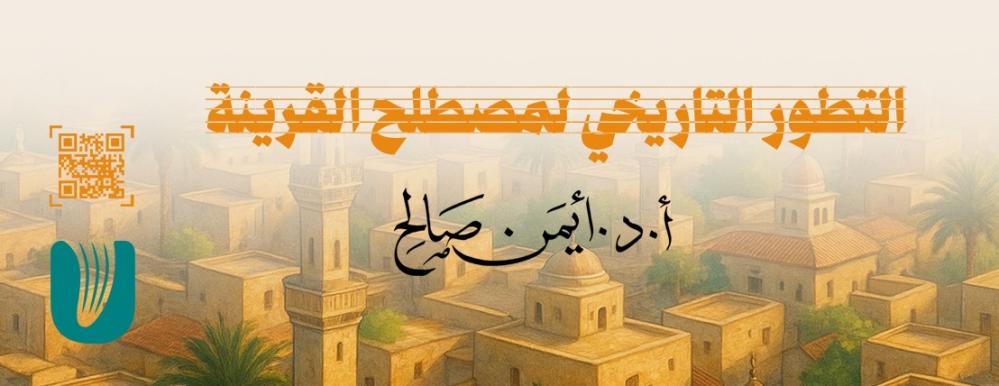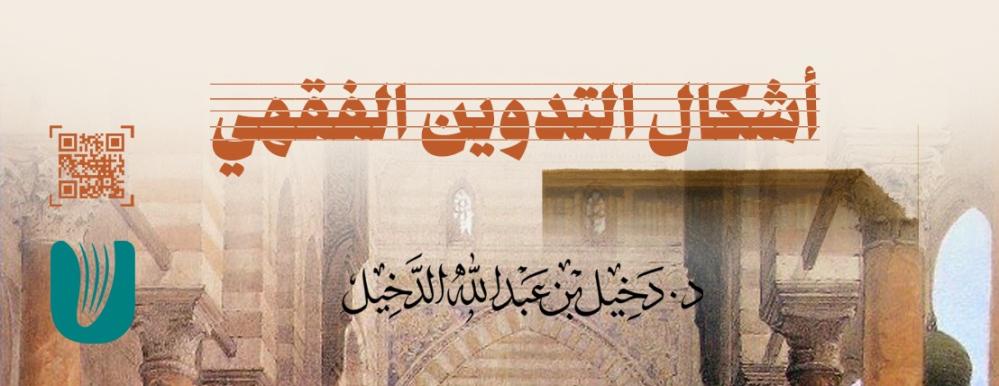الاتجاهات الكلامية عند الشافعية
د. طه محمد نجا
لم تكن وجهة المذهب منذ إمامه، الشافعي (ت: 204 هـ) بالتي تبشر بمنزع كلامي – جديد – داخله؛ أعني: أن أصول (الشافعي) المعرفية: لم يكن من الميسور للقارئ والمؤرخ أن يرى في إحدى وجهتيها: (الفقه الشافعي)، وفي وجهتها الأخرى (الكلام)، عِلمًا قائمًا برأسه؛ أو مسلكا في البحث والنظر، معروفها متداولا في ذلك الزمان، قد تميز بمسالكه عن طريق (أهل الحديث)، الخلَّص!!
ولم يكن ميسورا لنا، أن نرى هذه الأصول الشافعية، منتجة لذلك الكلام، أو تلك الفلسفة؛ ولا كان بمقدورنا، بنفس الدرجة، أن نراهما جميعًا – الفقه الشافعي، والكلام؛ أيا كانت إضافته المذهبية بعد ذلك -: رضيعي لَبانِ أصول الشافعي المعرفية!!
ففضلا عن جدلية العلاقة بين الفقه والكلام، تلك التي أرخنا لها آنفا؛ كانت نصوص الشافعي نفسه تصب في الاتجاه الرافض لعلم الكلام:
كان الإمام يرى أن (الكلام) بلية، وأي بلية: «لأن يُبتَلى المرء بكلِّ ما نهى الله عنه، سوى الشِّركِ، خيرٌ له من الكلام، ولقد اطَّلعتُ من أصحاب الكلام على شيءٍ، ما ظننتُ أن مسلمًا يقول ذلك»([1])!!
ومقولته في معاملة أهل الكلام مشهورة دائرة: «حكمي في أهل الكلام: أن يُضرَبوا بالجريد، ويُحمَلوا على الإبل، ويُطافَ بهم في العشائر، وينادَى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكلام»([2]).
ويأبى أن يصنف فيه شيئًا، ولو كان ردًّا على أهل البدع. قال الربيع: قال لي الشافعي: «لو أردتُ أن أضع على كلِّ مخالفٍ كتابًا؛ لفعلتُ، ولكن ليس الكلام من شأني، ولا أحب أن يُنسَب إليَّ منه شيء»([3]).
إننا نفهم سر إعراضه عن التصنيف في الكلام؛ لأنه يرى أن كتب (الكلام) ليست من العلم أصلًا:
«لو أن رجلًا أوصى بكتبه من العلم لآخر، وكان فيها كتب الكلام، لم تدخل في الوصية؛ لأنه ليس من العلم»([4]).
وبهذا الموقف المنهجي: يثني عليه تلميذه، وصاحبه: الإمام أحمد بن حنبل (ت: 241 هـ):
«كان الشافعي، إذا ثبت عنده الخبر: قلده. وخير خصلة كانت فيه: لم يكن يشتهي الكلام؛ وإنما همته الفقه»([5])!!
***
بيد أن التاريخ سوف يُنَبِّئُنا، بما حفظه، ووعاه، أن هذا الموقف لم يكن كافيًا لكي يحول دون اشتغال الشافعية بعلم الكلام، أو انتساب طوائف من المتكلمين إلى المذهب الشافعي، ثم ارتباط المذهب الشافعي بمذهب كلامي، آخر الأمر!!
بدأ البحث الكلامي في المذهب مبكرًا جدًّا، منذ الطبقة الأولى من أصحاب الإمام، حيث عرفنا: أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي، أبا عبد الرحمن المتكلم (ت: ؟)، الذي كان من أصحاب الشافعي، الملازمين له ببغداد([6])، حتى قيل له: الشافعي!! ثم إنه: «بدل وقال بالاعتزال»، وتبع ابن أبي دؤاد على رأيه([7]). وقد صرح الخياط، المؤرخ والمتكلم المعتزلي (ت: حوالي 300 هـ) بأنه من تلامذة معمر([8]) - ابن عباد السلمي، من رؤوس المعتزلة - (ت: 215 هـ).
ثم لم تنقطع سلسلة المعتزلة بعده([9])، بل امتدت حتى كان أشهر مصنفي المعتزلة، القاضي عبد الجبار (ت: 415 هـ) شافعي المذهب في الفروع([10])، وحتى نُسب إلى ذلك واحد من أئمة الشافعية، وقضاتهم الكبار: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوَرْديُّ (ت: 450 هـ)([11])، وهي نسبة ربما وجدت لها سندًا من بعض كلام الماوَرْديِّ نفسه([12]).
وقد كان للمعتزلة ظهور بنيسابور، مع أن أهلها شافعية([13]).
ويبدو أن قبول مذهب الشافعي في الوسط الاعتزالي، كان أكبر مما تصوره هذه الإشارات التي وقفنا عندها، حتى يقول ابن الوزير في مناقشة خصمه الزيدي:
«شيوخ المعترض وأئمته في بدعة الكلام من المعتزلة، مُصْفِقون على تعظيم الشافعي، ودعوى أنه منهم في بدعهم؛ وحاشاه من ذلك، وكثير منهم مقلدون له في الفروع، أتبعُ له من الظل، وأطوعُ له من النعل ...»([14]).
وإذا كان الاعتزال قد اختلط بالتشيع، فالمسعودي، صاحب مروج الذهب، (ت: 345 هـ) من ذلك اللون: معتزلي، متشيع، وهو مع ذلك: شافعي المذهب، فيما يقول السُّبكيُّ([15]).
وكان الوزير الكبير، والأديب العالم، الصاحب ابن عبَّادٍ (ت: 385 هـ): مع اعتزاله؛ شافعيَّ المذهب، شيعيَّ النِّحْلة([16])!!
بل إن من خُلَّص الشيعة: محمد بن الحسن بن علي، أبا جعفر الطوسي، شيخ الطائفة (ت: 460 هـ)، قال السُّبكيُّ عنه: «كان ينتمي إلى مذهب الشافعي»([17]).
وعلى النقيض من المنحى الاعتزالي، قد وجدت نزعة التجسيم في المنتسبين إلى المذهب أيضًا، كما يعترف به السُّبكيُّ (ت: 771 هـ)([18])، ومن هؤلاء: «أصناف الأكراد كلهم شافعية، وفيهم من التشبيه والتجسيم، ما لا يوجد في صنف آخر»([19])!
وخارج النطاق الكلامي: يُنسب إليهم: أبو حيان التوحيدي (ت: بعد 400 هـ): شيخ الصوفية، وفيلسوف الأدباء، وأديب الفلاسفة، ومحقق الكلام، ومتكلم المحققين ..، على حد وصف ياقوت له([20])، ومع أنه رمي بالزندقة والانحلال، والكذب، وسوء العقيدة([21]) ..، فقد صرح النَّوويُّ بأنه: «من أصحابنا المصنفين»، وترجمه السُّبكيُّ وغيره في الشافعية([22]).
وشهاب الدين السهروردي المقتول (ت: 586 هـ)، الصوفي، والفيلسوف الإشراقي، هو معدود في الشافعية، أيضًا([23]).
والشهرستاني، الإمام المتكلم المعروف (ت: 548 هـ)؛ كان شافعي المذهب، قد برع في الفقه([24])، يذكر عنه السَّمْعانيُّ (ت: 562 هـ) والخوارزمي (ت: 568 هـ)، وهما محدثان ومؤرخان شافعيان ثقتان من معاصريه([25])، كتب عنه السَّمْعانيُّ، وقال الخوارزمي: كانت بيننا محاورات ومفاوضات([26])؛ يذكر الاثنان عنه أنه: «كان متهمًا بالميل إلى أهل القلاع([27]) والدعوة إليهم، والنصرة لطاماتهم»([28]).
نقول ذلك، مع اعتبار أنه ليس كل من قال بمقالة، نسب إلى المذهب القائل بها، ما لم تكن هذه المسألة من خصائصه، وأصوله الكبار، أو يصرح بالتزام المذهب، أو البناء على أصوله.
يقول الإمام تقي الدين السُّبكيُّ - الوالد - (ت: 756 هـ): «أتباع المرء من دان بمذهبه وقال بقوله على سبيل المتابعة والاقتفاء، الذى هو أخص من الموافقة؛ فبين المتابعة والموافقة بون عظيم»([29]).
ويقول الخياط (ت: نحو 300 هـ) - فيمن ينسب إلى الاعتزال -: «.. فلسنا ندفع أن يكون بشرٌ كثير يوافقونا في العدل ويقولون بالتشبيه، وبشر كثير يوافقوننا في التوحيد ويقولون بالجبر، وبشر كثير يوافقوننا في التوحيد والعدل ويخالفونا في الوعد والأحكام؛ وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة ..، فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس، فهو معتزلي»([30]).
فإذا ما جئنا إلى المذهب الأشعري ومكانه، رأينا أنه قد صار هو الطابع الغالب على المذهب منذ وقت ليس بالقصير؛ حيث أخذ عامة أصحاب الشافعي - كما يقول ابن عساكر - بما استقر عليه مذهب الأشعري، وصنف أصحاب الشافعي كتبًا كثيرة، على وفق ما ذهب إليه الأشعري([31]).
***
لعله قد ظهر لنا مما سبق أننا، وفي نطاق المذهب الفقهي الواحد، أمام أطياف من البحث الكلامي والفلسفي: يختلفون فيما بينهم، ويتعصب كل فريق على صاحبه([32])، وإن كان يجمعهم في نهاية الأمر: مذهب فقهي واحد؛ هو المذهب الشافعي.
وفي حِسْباننا: أن مذهبًا ضخمًا كهذا، له انتشاره الواسع في أقاليم الإسلام([33])، حين وسع كل هذه الأطياف الكلامية والفلسفية؛ لن يضيق بالسلفيين: أن يكون لهم حضورهم فيه؛ فهم ناس من الناس؛ وليسوا، وإن جمُدوا، وإن بعُدوا، بأعز مسلكا، ولا أبدع مذهبا، من كل هؤلاء؛ وهذا ما تحاول هذه الدراسة إبرازه والبحث فيه!!
ومهما كانت رؤيتنا لهذا الحضور، ومهما كان تقديرنا لالتئام أصول الوجهتين؛ فلقد رأينا المذهب، وهو يسع من وسع، من الأقربين، والأبعدين؛ فأنى له أن يضيق بالسلفيين؟!!
يشير ابن تيمية، صراحة، إلى ذلك الحضور، في كثير من المواطن، حينما يذكر مذهب السلف، ومن قال به، من المالكية والشافعية والحنبلية، أو من أهل المذاهب الأربعة:
«هذا القول [يعني: نفي الجهة والتحيز] لم يقله أحد ممن يسوغ للمسلمين تقليده في فروع دينهم، فكيف يقلدونه أصول دينهم التي هي أعظم من فروع الدين؟! فإن هذا القول وإن قاله طائفة من المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة، فليس في قائليه من هو من أئمة ذلك المذهب الذين لهم قول متبوع بين أئمة ذلك المذهب؛ فإن أصحاب الوجوه من أصحاب الشافعي كأبي العباس بن سريج (ت: 306 هـ)، وأبي علي بن أبي هريرة (ت: 345 هـ)، وأبي سعيد الإصطخري (ت: 328 هـ)، وأبي علي بن خيران (ت: 320 هـ)، والشيخ أبي حامد الإسفرايني (ت: 406 هـ) ونحو هؤلاء = ليس فيهم من يقول هذا القول.
بل المحفوظ، عمن حفظ عنه كلام في هذا: ضد هذا القول.
وغايته أن يحُكى عن مثل أبي المعالي الجويني، وهو أجل من يحكى عنه ذلك من المتأخرين، وأبو المعالي ليس له وجه في المذهب، ولا يجوز تقليده في شيءٍ من فروع الدين عند أصحاب الشافعي؛ فكيف يجوز، أو يجب، تقليده في أصول الدين؟!»([34]).
قد يقال: إن ابن تيمية - هنا - متأثر برؤيته السلفية، وعداوته مع الأشعرية؛ خاصة إذا كان يكتب هذا الكتاب – التسعينية - في سجنه، بسبب محنته معهم؟!
فنقول: لسنا في حاجةٍ - في هذا المقام - لأن ندفع ذلك عن ابن تيمية، وإن كان كلُّ من له اتصالٌ بتراثه، وخبرةٌ بمنهجه، يعلم مدى دقَّته في أحكامه، وتحرِّيه، وإنصافِه.
لكن حسبنا أن نقول: وهذا الإشكال واردٌ أيضًا على تأريخ ابن عساكر والسُّبكيِّ، وغيرهما من مؤرِّخي الأشعرية، سواءً بسواءٍ!!
ويكفي لكي ندلل على ذلك أن نقول: إن السُّبكيَّ (ت: 771 هـ) في تأريخه الكلامي للمذاهب الأربعة، وهو عمدة من جاء بعده، يقول:
« أنا أعلم أن المالكية: كلَّهم أشاعرةٌ؛ لا أستثنى أحدًا.
والشافعية: غالبهم أشاعرةٌ؛ لا أستثنى إلا من لحق منهم بتجسيمٍ، أو اعتزالٍ، ممن لا يعبأ الله به (؟!).
والحنفية: أكثرهم أشاعرةٌ، أعني: يعتقدون عقد الأشعريِّ، لا يخرج منهم إلا من لحق منهم بالمعتزلة.
والحنابلة: أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرةٌ، لم يخرج منهم عن عقيدة الأشعريِّ إلا من لحق بأهل التجسيم، وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم»([35]).
إننا نزعم أن هذا التأريخ للسُّبكيِّ أثبت حضور الاتجاه الذي نؤرخ له في المذهب، من حيث أراد أن ينفيه؛ فالمتتبع لتقييم السُّبكيِّ، يعلم أن مثبتة العلوِّ والصفات الخبرية التي ينفيها، تبعًا لمتأخِّري الأشعرية، هم - عنده - من المجسمة([36])!!
وأيًّا ما كان الأمر في إثبات السُّبكيِّ أو نفيه، فمن الجناية على تأريخ المذهب بمكان أن نأخذ تقريره ذلك على محمل الجد والصرامة، ونستنيم إلى هذه الكلمة ونتائجها، دون جهد آخر نبذله، في تحقيق ذلك، وتمحيصه.
ويكفي لكي ندلل على مبلغ الخلل في هذا (المنشور)، أن السُّبكيَّ حينما ينقل عن ابن عساكر أسماء الآخذين عن الشيخ (الأشعري)، والمتابعين له على اعتقاده، قد انتقد عليه أنه «أهمل، على سعة حفظه، من الأعيان كثيرًا، وترك ذكر أقوام، كان ينبغي، حيث ذكر هؤلاء، أن يشمر عن ساعد الاجتهاد في ذكرهم تشميرًا ..»!!
ويعنينا أن نذكر ممن استدركهم السُّبكيُّ على ابن عساكر، رجلين فقط: أحدهما مالكي، وهو: أبو عمر ابن عبد البر (ت: 763 هـ) والآخر شافعي، وهو: الحافظ أبو طاهر السِّلَفيّ (ت: 576 هـ)([37]).
أما ابن عبد البر، فلن نناقش ذكره هنا باعتبار منهجه العام، من خلال كتبه المطبوعة، وأهمها وأعظمها: التمهيد، وسوف يكون مرجعًا لنا في مواطن عديدة من الدراسة؛ فإن الاستنباط شيء، ونص الكلام شيء آخر:
«أجمع أهل الفقه والآثار، من جميع الأمصار، أن أهل الكلام: أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميْز والفهم»، ثم نقل - بإسناده - عن:
«.. ابن خواز منداد، البصري([38]) المالكي (ت: 390 هـ) ... قال مالك: لا تجوز الإجارة في شيءٍ من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم، وذَكر كُتُبا. ثم قال:
وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا: هي كتب أصحاب الكلام، من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك ...
وقال في كتاب الشهادات، في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء، قال:
أهل الأهواء عند مالكٍ، وسائر أصحابنا: هم أهل الكلام؛ فكل متكلمٍ، فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريًّا كان، أو غير أشعريٍّ؛ ولا تقبل له شهادةٌ في الإسلام، ويُهجَر ويؤدَّب على بدعته، فإن تمادى عليها، استُتيب منها!!
قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد كله، في صفات الله وأسمائه، إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله، أو صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة.
وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله، أو نحوه: يُسَلَّم له، ولا يناظر فيه»([39]).
ثم قال، بعد ما روى بعض الآثار في إمرارها كما جاءت:
«نحو حديث التَنَزُّل، وحديث أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وأنه يدخل قدمه في جهنم، وأنه يضع السموات على أصبعٍ، وأن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلِّبها كيف يشاء، وإن ربكم ليس بأعور، وما كان مثل هذه الأحاديث.
وقد شرحنا القول في هذا الباب من جهة النظر والأثر، وبسطناه في كتاب التمهيد، عند ذكر حديث التَّنزُّل، فمن أراد الوقوف عليه تأمَّله هناك؛ على أني أقول: لا خير في شيءٍ من مذاهب أهل الكلام كلهم، وبالله التوفيق»([40])!!
ولسنا في حاجةٍ، بعد، إلى تعليقٍ على موقف ابن عبد البر، ولا نحن في حاجةٍ، من ثَمَّ، إلى تعليقٍ على قيمة استدراك السُّبكيِّ على ابن عساكر، ذلك الذي يعود على (منشور السُّبكيِّ) برمَّته؛ فيوهن الثقة فيه، ويجعلنا نتوقف مليًّا، قبل أن نستنيم إلى أحكامه، ونلقي القياد إلى أُقضياته.
وهذا الذي قرَّرناه: يتأكَّد أكثر بالنظر في الاستدراك الثاني، الذي ألمحنا إليه، وهو الذي يعنينا، في مقامنا هذا، ونحن ندرس الشافعية، بالقصد الأول؛ وأعني به: موقفه من الحافظ أبي طاهرٍ السِّلَفيِّ (ت: 576 هـ)([41]).
لسنا نعلم لأبي طاهرٍ مصنفاتٍ كلاميَّةً خاصَّةً([42])، بيد أننا نلاحظ أن كتاب شرح أصول أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم اللالكائيِّ (ت: 418 هـ) وهو من أهم المصادر السلفية، في المدة التي نؤرخ لها، هذا الكتاب: مدار إسناده، فيما وصلَنا، على أبي طاهرٍ السِّلَفيِّ([43]).
ومع أن رواية الكتاب وحدها ليست كافية في تبني مضمونه، فإن قوله - بعد ذكر بعض العقائد التي رواها اللالكائي في كتابه، وهو مجرد راو للكتاب -: «وبه نقول»([44])، يدل، ولو بصورة إجمالية، على موقفه العقدي من مسائل الكتاب الذي يرويه.
غير أن لأبي طاهر قصيدة (لامية)، تدل بوضوح على أنه لا تعقب على ابن عساكر في إهماله ذكر السلفي فيمن اتبع الأشعري، بل التعقب، والانتقاد، إنما هو على موقف ابن السُّبكيِّ!!
يقول في هذه القصيدة المطولة، بعد أبيات كثيرة:
وها أنا شارعٌ في شرحِ دينيِ
ووصفِ عقيدتي وخَفِيِّ حَالي
وَأَجهَدُ في البيان بقدر وُسْعي
وتخليصِ العقول من العِقال
.. .. .. .. ..
فلا تصحبْ سوى السنيِّ دِينًا
لتحمدَ ما نصحتُك في المآلِ
وَدَعْ آراءَ أهلِ الزيغِ رأسا
ولا تغرُرْك حذلَقة الرُّذَال
وقولَ أئمة الزيغ الذي لا
يُشابهه سوى الداءِ العضالِ
كَمَعْبَدٍ المضلّلِ في هواهُ
وواصلٍ اوْ كغيلانِ الِمحَال
وجعدٍ ثم جهمٍ وابنِ حرب
حميرٌ يستحقون المخالي
وثورٌ كاسمه، أو شئت فاقلب
وحفصُ الفردُ قردٌ ذو افتعال
وبِشْر لا رأى بُشْرَى فمنه
تولد كل شر واختلال
وأتباعُ ابنِ كُلّاب كِلابٌ
على التحقيق هُم من شر آل
كذاك أبو الهذيل وكان مولى
لِعبدِ القيسِ قد شان الموالي
.. .. .. .. .. .. ...
فرأيُ أولاء ليس يفيد شيئًا
سوى الهذيانِ من قيلٍ وقالِ([45])
إن أتباع ابن كلاب، الذين سلكهم السِّلَفيُّ هنا، ضمن أهل الزيغ، وسبَّهم وهجاهم: هم الأشاعرة الذين نسبه إليهم السُّبكيُّ؛ فالأشعري موافق لابن كلاب على عامة أصوله.
وقد انقرضت الكلابية، كفرقة قائمة من قديم، وورثتها الأشعرية.
يقول المقدسي (ت: 380)، في تعداده للمذاهب: «.. وأربعة: غلب عليها أربعة»، ثم قال: «وأما التي غلب عليها أربعة من شكلها: فالأشعرية، على الكُلاّبية ..»([46]).
ولا أعتقد أن بنا كبير حاجةٍ، إلى أن نعلق، أو (نتحفظ) على التذرع بالسباب، والإقذاع، لمخالفة الرأي، أو عرض الموقف الكلامي، مع اعتبارنا، أيضًا، لطبيعة الشعر التي ربما ساقت إلى شيء من ذلك، يختلف في نفسه، وقوله، عن مقام البحث والتصنيف.
على أننا نشير هنا إلى أن هذه اللائمة، لم يُختص بها أبو طاهر، وليست خاصة بفرقة دون فرقة، وإنما شاع ذلك في عامة المختلفين، حتى في المذاهب الفقهية؛ بَلْهَ الكلامية!!
فالزمخشري ينقل قول بعضهم في أهل السنة، المثبتة للرؤية والصفات، بلا كيف:
لَجَمَاعَةٌ سَموْا هَواهُمْ سُنَّة
وَجَمَاعَةٌ حُمُرٌ لَعَمْرِي مُوكَفَه
قَدْ شَبَّهُوهُ بِخَلْقِهِ وَتَخَوَّفُوا
شَنْعَ الْوَرَى فَتَسَتَّرُوا بِالبَلْكَفَهْ([47])
والحصكفي (ت: 1088 هـ) يذكر في أوائل كتابه أبياتا في فضل أبي حنيفة، يختمها بقوله:
فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ
عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَهْ([48])
وهكذا كل فريق يقول في صاحبه([49])، وهو الأمر الذي ينتقده ابن تيمية - بحق -، بقوله:
«فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل: لا يعجز عنه أحد؛ والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب؛ لكان عليه أن يذكر من الحجة، ما يبين به الحق الذي معه، والباطل الذي معهم ...»([50]).
أحسب أن عندنا الآن من الجرأة، ما يخولنا أن نمضي قدما في التأريخ للاتجاه السلفي عند الشافعية، دون أن تعيقنا تلك الأحكام المسبقة، بأننا لن نجد من الشافعية أحدًا يخالف عقيدة الأشعري، ممن يعبأ الله به (؟!)، ودون أن يرهبنا الويل والثبور، وعظائم الأمور، إذا نحن أقدمنا على مخالفة اعتقاد الأشعرية، أو التأريخ لغيرهم في الشافعية([51])!!
لكننا حين لا نتوقف عند الأَثْبات التي ذكرها ابن عساكر، أو السُّبكيُّ، أو غيرهما للأشعرية، وحين نعيد النظر في ذلك كله، ونقلب نحن صفحات التاريخ، ونقرؤه من جديد، ولا نمانع من أن يكون من هؤلاء من يخالف وجهة النظر الأشعرية؛ حين نفعل ذلك، فلن يكون بوسعنا أن نعتمد على الأثبات الذي يذكرها آخرون، كابن المِبْرد، يوسف بن عبد الهادي (ت: 909 هـ) في كتابه الذي عمله في نقد (تبيين كذب المفتري)، وأسماه: (جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر)!!
فإننا لم نجد في طول الكتاب، وعرضه، ما يلائم غرض هذه الدراسة، أو يفيدها في وجهتها التي نحت إليها، ومنهجها الذي ترسمته؛ وقد كنا على طمع في أن يسعفنا بأفكار ونصوص تدعم الدراسة، لما بين المادتين من التقاطع الواضح؛ بيد أنه، ومن أسفٍ: لم يقدم لنا في هذا السياق: شيئًا مفيدا، ذا بال!!
والواجب علينا، حينئذ، أن يكون اعتمادنا على نصوص الأصحاب، وكلام المصنفين، بألفاظهم التي دونوها في مصنفاتهم، أو نقلَها عنهم الثقات، نصًّا، لا فهمًا، أو استنباطًا!!
***
_______________________________
([1]) رواه ابن أبي حاتمٍ في مناقب الشافعي (182): «ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: سمعت الشافعي ...» فذكره، وهذا إسنادٌ صحيحٌ جليلٌ، ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية (9/118)، وابن عساكر في التبيين (335)، ومن طريق الربيع: البيهقي في المناقب (1/453)، والهروي في ذم الكلام (4/291).
([2]) رواه أبو نعيم في الحلية (9/123) والبيهقي في المناقب (1/462)، والهروي في ذم الكلام (4/292)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/941)، وقال محققه: «صحيح».
([3]) رواه الهروي في ذم الكلام (4/308)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (51/371)، قال الذهبي: «وهذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي». سير أعلام النبلاء (10/31)، ونصوص الشافعي في هذا الباب كثيرة جدًّا، يمكن مراجعتها في مصادر الآثار السابقة.
([4])رواه أبو عبد الرحمن السلمي، كما في: أحاديث في ذم الكلام، لأبي الفضل المقرئ (90)، ومن طريقه: الهروي في ذم الكلام (4/298): «... عن الربيع، عن الشافعي رحمه الله، أنه قال في مبسوطه، في كتاب الوصايا ...». اهـ ونقله الذهبي في السير (10/30).
وحول (المبسوط)، يقول ابن النديم، في ترجمة الربيع بن سليمان: «روى عن الشافعي كتب الأصول، ويسمَّى ما رواه (المبسوط)» اهـ. الفهرست (1/211). وينظر أيضًا فوائد حول (المبسوط): تاريخ الإسلام، للذَّهبيِّ (25/367)، المقفى الكبير، للمقريزي (5/194)، طبقات السبكي (2/258).
([5]) رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (82). وانظر: الحجة على تارك المحجة، لنصر المقدسي (1/246).
([6]) يقول ابن تيمية، عن الشافعي: «ولما كان بالعراق، كان به من يناظره من الموافقين والمخالفين، ما لم يكن بمصر، وقد ناظره بشرٌ المريسي، في الفقه وأصوله، مناظرةً طويلةً، جمعها أبو عبد الرحمن صاحب الشافعي». اهـ العقود (82).
([7]) طبقات الشافعية الكبرى (2/64-65)، وانظر: تاريخ بغداد (6/441-442)، ميزان الاعتدال للذَّهبيِّ (6/221).
([8]) انظر: الانتصار (99)، و أيضًا ص (96).
([9]) يقول السبكي في ترجمة أبي الحسين الآبري (ت: 363 هـ) - صاحب كتاب مناقب الشافعي -: «ومن عجيب ما رأيت في كتابه مناقب الشافعي: أنه عدَّ بشرًا المريسيَّ في أصحاب الشافعي، وليس بشرٌ من أصحاب الشافعيِّ، بل من أعدائه، لأنَّه لم يتبعه على رأيه، بل خالف وعاند، وقد قال هو، أعنى الآبريَّ، في هذا الكتاب: إنَّه من أهل الإلحاد» اهـ، طبقات الشافعية (3/147-148). وقارن نصَّ كلام الآبريِّ، بحسب النسخة المتاحة من كتابه (مناقب الشافعي)، للآبري، ت: جمال عزون (94).
([10]) صرح بذلك الخطيب البغدادي في ترجمته له (12/414) وابن المرتضى في المنية والأمل (66)، وترجمه السبكي في طبقاته (5/97-98)، وابن أبي شهبة (1/184).
([11]) قال الذهبي - ميزان الاعتدال (4/75) -: «صدوقٌ في نفسه، لكنه معتزليٌّ»!! ويقول الحموي: «ومن مشاهيرهم [أي: المعتزلة]، على ما ذكروا من الفضلاء والأعيان ... وأقضى القضاة الماوَرْديّ الشافعي؛ وهذا غريب!!» اهـ ثمرات الأوراق (20).
([12]) انظر حول هذه المسألة: سير أعلام النبلاء (18/67)، طبقات الشافعية الكبرى (5/270)، مقدمة تحقيق أدب الدنيا والدين (5-6).
([13]) انظر: المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (248، 249).
([14]) العواصم والقواصم (5/5). بل يقول ابن المرتضى، في محاولة واضحة لاعتبار الشافعي من جملة المعتزلة: إن الشافعي قد اجتمع له، في شيوخه، رجلان من القائلين بالعدل والتوحيد. انظر: المنية والأمل (25). انظر هذا الرأي ومناقشته عند العمراني في: الانتصار في الرد على القدرية (3/799-780)، وانظر أيضًا: مناقب الشافعي، للرازي (129-132).
([15]) طبقات الشافعية (3/456)، وانظر: سير أعلام النبلاء (15/569).
([16]) لسان الميزان (2/137).
([17]) طبقات الشافعية (4/126).
([18]) طبقات الشافعية (3/378).
([19]) مجموع فتاوى ابن تيمية (3/185).
([20]) انظر: معجم الأدباء (1923)، وما بعدها، وهي أوسع تراجمه، فيما أعلم، وقد اقتبس هذا الوصف د. زكريا إبراهيم عنوانا لكتابه عن أبي حيان. وانظر كلامًا حول فلسفته في: مقدمة الهوامل والشوامل، لأحمد أمين والسيد صقر (13-21)، وقد عرض د. زكريا إبراهيم صورة لفلسفته (150) وما بعدها، وهي صورة يظهر فيها الانتقائية، والرؤية الشخصية، كما قد يعترف هو - بصفة عامة - في مقدمة كتابه (9).
([21]) انظر: ميزان الاعتدال (6/192-193)، سير أعلام النبلاء (17/119-121)، وأما السبكي فقال، بعد ما نقل كلام شيخه الذهبي وغيره - (5/288) -: «ولم يثبت عندي إلى الآن ما يوجب الوقيعة فيه ...»، وهي الوجهة التي تغلب على التقييم المعاصر لفلسلفته. انظر: مقدمة المقابسات، لحسن السندوبي (14-16)، مقدمة الهوامل والشوامل (21-22).
([22]) ونقل النَّوويُّ عنه أيضًا فرعًا، غريبًا في المذهب، أنه: «لا ربا في الزعفران». انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/223). وانظر ترجمة السبكي له في طبقاته: (5/286-289)، والإسنوي في طبقات الشافعية (1/145).
([23]) انظر: وفيات الأعيان (6/272)، وترجمه الإسنوي في طبقاته (2/242-243).
([24]) انظر: وفيات الأعيان (4/273)، طبقات السبكي (6/129).
([25]) لهما ترجمتان حسنتان عند السبكي في طبقاته (7/180-185)، (7/289-291).
([26]) ويحكي لنا ظهير الدين البيهقي أنه فاوض – هو الآخر - أبا الفتح الشهرستاني، في قضية مركزية في الفكر الكلامي والفلسفي، فقال - في نص نفيس -: «وكان يصنف تفسيرًا، ويؤول الآيات على قوانين الشريعة، والحكمة، وغيرها. فقلت له: هذا عدول عن الصواب؛ لا يفسر القرآن إلا بآثار السلف، من الصحابة والتابعين؛ والحكمة بمعزل عن تفسير القرآن، وتأويله، ولا يجمع بين الشريعة والحكمة، أحسن مما جمعه الإمام الغزالي، رحمه الله. فامتلأ من ذلك غضبا!!» اهـ تاريخ حكماء الإسلام (142).
([27]) يعني: الإسماعيلية الباطنية؛ نسبة إلى القلاع التي كانوا يتحصنون بها. انظر: الملل والنحل (1/195).
([28]) انظر: سير أعلام النبلاء (20/287-288). وينقل ياقوت - معجم البلدان (3/377) - عن الخوارزمي قوله: «ولولا تخبطه في الاعتقاد، وميله إلى أهل الإلحاد، لكان هو الإمام. وكثيرًا ما كنا نتعجب من وفور فضله، وكمال عقله: كيف مال إلى شيءٍ لا أصل له، واختار أمرًا لا دليل عليه، لا معقولًا ولا منقولًا، ونعوذ بالله من الخذلان، والحرمان من نور الإيمان، وليس ذلك إلا لإعراضه عن نور الشريعة، واشتغاله بظلمات الفلسفة، وقد كان بيننا محاورات ومفاوضات، فكان يبالغ في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم ...» اهـ ونقله أيضًا: الذهبي في السير (20/288). وانظر: لسان الميزان (5/263)، طبقات السبكي (6/130).
([29]) نقله عنه ولده تاج الدين، في طبقات الشافعية الكبرى (3/366).
([30]) الانتصار (188-189).
([31]) تبيين كذب المفتري (140).
([32]) انظر حول فكرة العصبية هنا: المقدسي: أحسن التقاسيم (258، 275-276)، معيد النعم ومبيد النقم، للسُّبكيِّ (87-88).
([33]) انظر: أحمد باشا تيمور: نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة (45) وما بعدها.
([34]) التسعينية (1/196-200).
([35]) الطبقات (3/377-378)، ويكرر نفس الفكرة: (3/365-367)، وفي معيد النعم (75).
([36]) يقول السبكي لشيخه الذهبي: «فسوف تقف معه [يعني: الأشعري] بين يدي الله تعالى، يوم يأتي وبين يديه طوائف العلماء من المذاهب الأربعة، والصالحين من الصوفية، والجهابذة الحفاظ من المحدثين، وتأتى أنت تتكسّع فى ظُلَم التجسيم [كذا]، الذي تدَّعي أنك بريء منه، وأنت من أعظم الدعاة إليه، وتزعم أنك تعرف هذا الفن، وأنت لا تفهم فيه نقيرًا ولا قطميرًا»؟!!
فهو هنا يتحدث عن شيخه الذي لا يصرِّح بالتزام التجسيم، ولا يصرح باللفظ، بل يتبرأ منه، ومع ذلك يعتبر هذا التبري دعوى، وأنه ليس مجسمًا فحسب؛ بل من أعظم الدعاة إلى التجسيم، الذي يتكسع في ظلمته يوم القيامة (؟!)، وهكذا، فليكن عقوق الشيخ، عصبيةً للمذهب!!
([37]) طبقات الشافعية (3/372).
([38]) محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو عبد الله، وقيل: أبو بكر. انظر في ترجمته: جمهرة تراجم فقهاء المالكية (2/1005)، الفكر السامي للحجوي (2/115). وقد وقع هنا في النسخة المحققة (!!) تبعا للطبعة الأولى - المنيرية - (2/96): «المصري»، بدلًا من: «البصري»، وهو تحريف فاحش، كدت أن أغتر به. وانظر: لسان الميزان (5/291).
([39]) جامع بيان العلم وفضله (2/942-943).
([40]) السابق (2/944)، وانظر التمهيد - ترتيبه - (6/124-143).
([41]) هو: أبو طاهر أحمد بن محمد، قال السبكي: «كان حافظًا جليلًا، وإمامًا كبيرًا، واسع الرحلة، ديِّنًا ورعًا، حجةً ثبتًا، فقيهًا لغويًّا، انتهى إليه علو الإسناد، مع الحفظ والإتقان». وقد ترجم له الذهبي ترجمةً موسعةً جدًّا، في السير (21/5-39)، وانظر: وفيات الأعيان (1/105-107)، طبقات الشافعية الكبرى (32-44)، ونشر د. حسن عبد الحميد صالح دراسة موسعة بعنوان: الحافظ أبو طاهر السلفي، هي جزء من أطروحته للدكتوراه، حول السلفي وكتابه: معجم السفر، انظر: (7-11)
([42]) لا يذكر د. حسن عبد الحميد صالح شيئًا عن هذا الجانب في شخصيته. انظر: الحافظ أبو طاهر السلفي (140) وما بعدها.
([43]) انظر: (1/7) من الكتاب المذكور.
([44]) انظر (1/180).
([45]) القصيدة ساقها الذهبي بطولها في السير، راجع الأبيات (21/36-38)، وفي الفصل التالي نقل من قصيدة أخرى للسلفي، لامية أيضًا.
([46]) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (36)، ويشير الشهرستاني في الملل والنحل (1/93) إلى هذه الفكرة أيضًا. وانظر: بيان تلبيس الجهمية (1/74، 5/362) ط المجمع.
([47]) البيتان في الكشاف (2/156)، وانظر حواشيه. وينظر ما أورده السبكي من المقطعات، في معارضة بيتي الزمخشري: الطبقات (9/9) وما بعدها. ويشير العمراني في كتابه الانتصار (1/90) إلى أن القاضي الزيدي - الذي رد عليه العمراني -: «سلك طريق أسلافه وأئمته من المعتزلة والقدرية في الوقيعة والشتيمة ..» اهـ فالعمراني هنا يؤرخ لحالة خاصة، ويقرنها بتوجه عام للمعتزلة، على ما يؤرخه هو.
([48]) انظر: الدر المختار، مع شرحه رد المحتار (1/160).
([49]) انظر نماذج لما دار بين الحنابلة والأشاعرة عند ابن الأثير في الكامل (8/288)، والذهبي في السير (21/395).
([50]) مجموع الفتاوى (4/186).
([51]) انظر: تبيين كذب المفتري (331، 362)، معيد النعم (74-75).
انقر هنا للوصول إلى صفحة الكتاب كاملاً.
انقر على الصورة للوصول إلى النسخة المصورة (pdf) قابلة للتحميل والنشر.