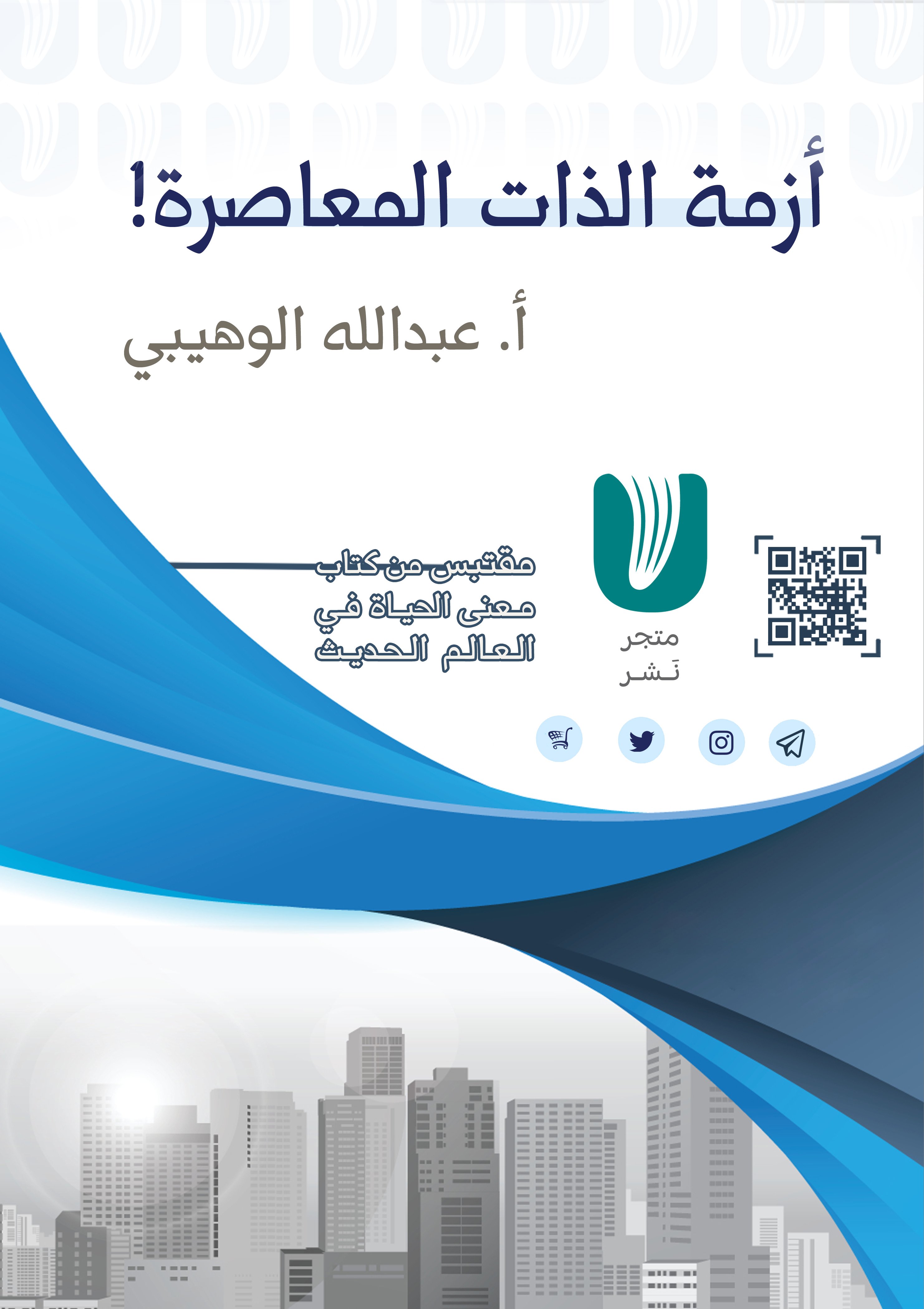أزمة الذات المعاصرة!
أ. عبدالله الوهيبي
في عام 1998م نشر عالم الاجتماع الفرنسي آلان إهرنبرغ (و1950م) كتابه "تعب أن يكون المرء ذاته"[1]، وهو يشرح ملامح أزمة الذات المعاصرة، ويرى أن هذه الأزمة تعود إلى تغيّر النموذج الثقافي الذي يواجهه الرجال والنساء، الذي يلحّ –بشدة- على أن يكون المرء ذاته، وأن يتحقّق بها، وأن يبني هويته الشخصية المستقلّة، ويربط إهرنبرغ بين تحوّل النموذج الثقافي وانتشار الكآبة وأعراضها، فـتجليات الاكتئاب (التعب، قلة النوم، الاضطراب والقلق، التردد، احتقار الذات) "تبين الثمن الذي يجب دفعه للإلزام المزدوج، أي الاستقلال الذاتي، وتحقيق الذات، وبوصفها مرض المسؤولية؛ فإن الكآبة هي عرض يصيب الفرد المتحرر من الوصاية الدينية والاجتماعية"[2]، فحين لا يرتقي الفرد -في النموذج الفرداني الحديث- إلى المستوى المطلوب من الأصالة و"الاستقلالية"؛ يقع فريسة للآلام النفسية، ويطغي عليه شعور "التألم من الذات"، وهو الشعور الذي لا ينشأ بسبب صراعات الماضي أو تعاسات الطفولة، بل ينبع "من ضعف الأنا، ومن تناقص تقدير الذات أو انهياره، ويكون ذلك أولًا –وخصوصًا- في عينيْ المرء نفسه"[3]، فالاكتئاب ليس مرضًا عاديًا، بل هو طريقة لصياغة الذات والتعرّف عليها، ونتيجة للفشل "في تحقيق مطالب الاستقلالية والحرية الشخصية التي يفرضها المجتمع المعاصر على الفرد"[4].
ويشير اهرنبرغ في تحقيب عام لشكل التحول في النموذج الثقافي والمجتمعي وانعكاساته على التشخيص وطبيعة الخلل النفسي الشائع، ويكتب:
«مسألة الشخصية المريضة ظهرت في عام 1800م مع محور الجنون-الهذيان، ثم تحوّل في عام 1900م إلى مأزق الإحساس بالذنب، وهو ما يمزّق الإنسان الذي غدا عصبيًا نتيجة محاولاته لتجاوز نفسه، وفي عام 2000م أصبحت أمراض الشخصية أمراضًا ترتبط بمسؤولية الفرد الذي تحرر من قانون آبائه، ومن الأنظمة للخضوع والتوافق مع قواعد خارجية. إن الكآبة والإدمان هما وجها العملة للفرد صاحب السيادة على نفسه»[5].
فالكآبة –في هذا التحليل- آلية نفسية لحماية الفرد المفتقر للإرشاد والدعم والتوجيه من ضغوط المحيط الثقافي، وإكراهات البيئة الاجتماعية، ويظهر ذلك في ارتباط الاكتئاب بمقاومة حركة الزمن، حيث يفقد المكتئب الطاقة اللازمة للحركة والنشاط؛ فحركته، وكلامه، وشعوره، وأعماله، ودوافعه؛ تتسم بالتباطؤ الشديد، ودوافعه للإنجاز تتلاشى، كما يعاني المكتئب من ضعف التواصل مع نفسه ومع الآخرين، وهكذا نلحظ أن النتيجة (عدم وجود مشروع، وضعف الدافع، وقلة التواصل) هي مناقضة تمامًا لمعايير التنشئة الاجتماعية والثقافية المعاصرة، التي تحثّ بشدة على إنجاز مشروع شخصي[6]، وتحفّز الفرد على الإنجاز[7]، والتواصل مع "الذات" والآخرين، لذا ينبغي أن لا نفاجأ بذيوع استخدام مصطلحي الاكتئاب والإدمان في الطب النفسي، وفي الاستعمال الشعبي العام[8].
واعتبر إهرنبرغ الكآبة والإدمان من نتاج التصوّر الفرداني عن "السيادة" الحرّة على الذات، لأن تراجع التقاليد الاجتماعية والأخلاقية واستبدال أفكار الاستقلالية والتحرّر بها أدى إلى تضخّم مساحة صنع القرارات اليومية في حياة الفرد، وكذلك في الشأن المجتمعي العام، وقد كان من مهام التقاليد تسهيل العمل والحركة في المساحات الاجتماعية، بترسيخ القواعد وتوافقية المبادئ التي تحكمها، وهذا التضخّم للقرارات الواجب اتخاذها -بطريقة فردية مستقلّة-؛ أسهم في انتشار ظواهر الإدمان، التي لم تعد تقتصر على إدمان الكحول والمخدرات، بل اتسع نطاقها لتشمل الكثير من الأنشطة اليومية، كالإدمان على العمل، والطعام، والجنس، والإدمان على الأجهزة الإلكترونية، والألعاب، ومشاهدة الأفلام، وإدمان الكافيين والسكريات، وإدمان "الحبّ"، وغيرها[9].
ويمكن فهم العلاقة بين ضعف التقاليد وتزايد الإدمان بالنظر إلى أن الإدمان هو تقليد فرداني مكرّر، ودوره يكمن في تخفيف وطأة اتخاذ القرارات تجاه التفاصيل الكثيرة في الحياة اليومية[10]، فالإدمان على طعام أو سلوك أو ممارسة معينة؛ يحمي الفرد من حيرة تعدد الخيارات، ومشقة المسؤولية الذاتية في تحديد الأولويات في النشاط اليومي، والالتزامات الدورية، فطوفان الخيارات والاختيارات المعقّدة التي يواجهها الفرد اليوم غير مسبوق في التاريخ، وهي لا تقتصر على "أنواع السلع[11] فقط، ولا بين أجزاء من أساليب الحياة فحسب، بل بين أساليب حياة بأكملها"[12].
ومن جهة أخرى ينشأ الإدمان عن الرغبة في تقليل العلاقة المفرطة مع الذات؛ التي نتجت عن الهوس المعاصر بصياغة الذات واكتشافها وتحريرها كما أسلفنا؛ حيث إن الفرد يفرّ من ألم ذاته الخاوية بـ"الانخراط في أنشطة قهريّة من شأنها أن تقلّل تركيزه على خبرته الداخلية الخاصة"[13].
ومن جهة ثالثة فإن التقليد والإدمان يتعلقان بنمط صلة الماضي بالحاضر، فالتكرار الواقع في التقاليد يربط الحاضر بالماضي، والإدمان –كما يقول انتوني غيدنز- ينتج عن "تحرير" الفرد من الماضي، وتوسيع إمكانيات الفعل، وهذا التحرير –الذي يعني فكّ الارتباط بين الماضي والحاضر- والتأكيد المفرط على الاستقلالية في الفعل؛ قد يولدان القلق، بل كثيرًا ما يفعلان، ومن ثمّ يثبّت الفرد الفعل ويكرره "أي يدمن عليه"؛ فرارًا من القلق، ورغبة في استعادة الارتباط بالماضي، الذي هو في هذه الحالة الماضي الفردي، وليس الجماعي؛ كما هو الحال في التقاليد[14].
وفي الجملة؛ فإن الآلام والتعاسات النفسية الشائعة عند المعاصرين تولدها معاناة الأفراد من وطأة "العملية المستمرة لتعريف الذات أو صناعتها، في سياق اجتماعي بالغ التعقيد"، فالفرد يتساءل -باستمرار- عن هويته وإلى أين يمضي في حياته، "ومن ثمّ؛ فإن مشاريع حياته وهوياته معرّضة -دومًا- لإعادة التنظيم بالتزامن مع جزئيات واقعه المادي والاجتماعي"[15]، وإذا كانت الاضطرابات والأزمات التي يعاني منها الأفراد في التاريخ القديم تظهر في الحروب والقلاقل والمجاعات ونحو ذلك، فإن معاناة الفرد في النموذج الحداثي تأتي من الارتباك والتشويش الذي يهدّد هويته الشخصية[16]، الذي يشكّل معنى حياته جزءًا أساسًا منها.
-----------------------------------------------------------
[1] العنوان الكامل بالفرنسية: La fatigue d'être soi: dépression et société وترجمه بعضهم بـ"التعب من تحمّل الإنسان لوجوده: الاكتئاب والمجتمع".
[2] بواسطة: فريدريك لونوار، في السعادة-رحلة فلسفية، ص133، ترجمة خلدون النبواني، نشر دار التنوير، ط1 2016م.
[3] كلود دوبار، أزمة الهويات-تفسير تحولات، ص163، هامش (1)، ترجمة رندة بعث، نشر المكتبة الشرقية، ط1 2008م.
[4] انظر: مراجعة راسموس جونسون للترجمة الإنجليزية لكتاب إهرنبرغ:
Alain Ehrenberg, The weariness of the self: Diagnosing the history of depression in the contemporary age, (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2009).
على الرابط:
http://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/11-1johnsen.pdf
[5] بواسطة: فريدريك لونوار، مصدر سابق، ص133-134. وفي دراسة شهيرة حللّ عالم النفس الأمريكي جيمس بينبيكر 300 قصيدة لشعراء منتحرين (تتراوح أعمارهم ما بين 30 و58 عامًا) وتسعة شعراء غير منتحرين، وتوصل إلى أن "كتابات الشعراء المنتحرين تحتوي على كلمات أكثر تتعلق بالذات الفردية، وكلمات أقل تتعلق بالآخرين؛ بالمقارنة مع الشعراء غير المنتحرين، أي أن الأفراد المنتحرين أكثر انفصالًا عن الآخرين، وتشغلهم ذواتهم". انظر: هاورد فرديمان وميريام شستك، الشخصية- النظريات الكلاسيكية والبحث الحديث، ص231، نشر المنظمة العربية، ط1 2013م. وسعت دراسات أخرى إلى استكشاف الصلات نفسها بين تركيز الاهتمام على الذات وبين مرض الاكتئاب، وفي إحدى هذه الدراسات طُلب من عينة الدراسة كتابة يوميات منتظمة لمدة شهر كامل، تتضمن الأحداث والحالة المزاجية والشعورية والأعراض الجسدية التي يعيشها الفرد في هذه المدة يومًا بيوم، ثم قام الباحثون بفحص هذه اليوميات بدقة، وتوصلوا إلى النتيجة الآتية: "الأشخاص الذين يركزون أكثر على ذواتهم، ويجعلونها محور اهتمامهم هم أكثر الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الاكتئاب"، كما برهنت دراسة أخرى أيضًا على "وجود علاقة وثيقة بين الاكتئاب وتكرار استخدام ضمير (أنا)، أكثر من استخدام كلمات تعبر عن انفعالات سلبية". انظر: جون مونستاس، التحرر من الذات، ص92-93، ترجمة جيهان عيسوي، نشر دار جامعة الملك سعود، ط1 1438هـ.
[6] طرح بعض علماء النفس التطوري بعض الوظائف "المفيدة" للاكتئاب أو ما يسمى بالحالة المزاجية المنخفضة عمومًا، التي تتسم بالإحجام والانزواء، والتفكير البطيء، وقلة الثقة بالنفس، والتقدير المنخفض للذات، والخضوع أو الاستسلام، ونحو ذلك؛ ومن أهم الوظائف "الإيجابية" التي تبرز بسبب الارتباط القوي بين فقدان المكانة والاكتئاب، فقد لاحظت بعض الدراسات النفسية –وهي تتقاطع بشكلٍ ما مع أطروحة إهرنبرغ مع الاختلاف الكبير في المنطلقات- أن "الكثير من نوبات الاكتئاب يسبقها فشل في قبول الخسارة في منافسةٍ ما على المكانة"، ومن ثمّ فدور الاكتئاب هو تثبيط الفرد عن مواصلة صراع عديم الفائدة، وحثّه على قبول الخسارة المؤكدة، والاستسلام الطوعي، وترى هذه الدراسات أن "العديد من المرضى يتعافون حين يتخلّون عن منافسة حول المكانة التي يستحيل الفوز بها"، ويؤكد ذلك الطبيب النفسي راندولف نيس بالإشارة إلى تجربته الشخصية مع كثير من حالات الاكتئاب التي عالجها، ويقول: "يخبرني الأطباء المقيمون الذين دربتهم أنهم يجدون أن توجيه السؤال التالي إلى مرضى الاكتئاب مفيد للغاية؛ وهو (هل هناك شيء مهم جدًا تحاول القيام به؛ ولكنك عاجز عن النجاح فيه، ولا تستطيع الاستسلام؟)". راندولف نيس، أسباب وجيهة للمشاعر السيئة، ص111-112، 304، ترجمة محمد خضر، نشر دار التنوير، ط1 2021م.
[7] وقد أصبحت "الخُطَب" التحفيزية من الظواهر الملحوظة في ثقافة العقود الأخيرة، وأصبحت متداولة ومتوقّعة من المشاهير في تقديمهم لبعض المناسبات كحفلات التخرج، وفي خطابات لحظة التكريم في الجوائز الفنية والأدبية والرياضية، ولم تعد مقتصرة على الكتب الشعبية المعروفة في أدبيات "تطوير الذات".
[8] انظر: مراجعة راسموس جونسون لكتاب إهرنبرغ، مصدر سابق.
[9] ينتقد الطبيب النفسي آلن فرانسيس التوسع المعاصر في مفهوم "الإدمان السلوكي"، والذي يكاد يشمل كافة الأنشطة الشعبية، ويرى أن مفهوم الإدمان يجب أن يحصر "على من يشعرون بأنهم مجبرون على تكرار الفعل حتى مع خمود المتعة، وارتفاع التكلفة". انظر: آلن فرانسيس، إنقاذًا للسواء، ص203-207، ترجمة سارة اللحيدان، نشر دار جداول، ط1 2019م.
والذي يعنينا هنا ليس هذا المستوى المعياري الطبي، وإنما الإدمان بوصفه فعلًا مكررًا، وظاهرة سلوكية ملحوظة، بغض النظر عن تصنيفها السيكولوجي ومقتضياته العلاجية.
[10] فالتقاليد تضع قواعد السلوك وقائمة المحظورات، والأسس الأخلاقية للاختيار، وتحدد مساحة الابتكار ومساحة الاقتداء، وكل ذلك –من المنظور العملي البحت- يسهّل معيشة الفرد، ويكفيه مؤونة "حرية" القرار المفرطة، وهذه التقاليد في معظم الأحيان ليست اعتباطية؛ بل "تمثل حكمة الأجيال بعد قرون من التجريب في معمل التاريخ" كما يقول ول ديورانت، في: دروس من التاريخ ص77، ترجمة علي شلش، نشر دار سعاد الصباح، ط1 1993م. وقد تعجّبت المعالجة النفسية الأمريكية لوري غوتليب من تخلّي الأفراد عن حرية اتخاذ القرار في حياتهم الشخصية، وقالت بأن "من أكثر الأشياء التي فاجأتني كمعالجة نفسية؛ كيف أن الناس غالبًا ما ينتظرون مني أن أقول لهم ما يتعيّن عليهم فعله". لوري غوتليب، ربما عليك أن تكلم أحدًا، ص302، ترجمة نادين نصر الله، نشر دار التنوير، ط1 2021م. والحق أن هذه الملاحظة ليست مفاجأة، لأن حرية القرار المفرطة –المصحوبة بانعدام أو ضعف الإطار الديني والأخلاقي وتراخي المساندة الاجتماعية-؛ تهدد الأمان النفسي للفرد، لنقص المعرفة، ووفرة الخيارات والإمكانات، وغموض المآلات.
[11] أحصى عالم النفس الأمريكي باري شوارتز في كتابه المعروف (مفارقة الاختيار: لماذا الأكثر هو الأقل The Paradox of Choice: Why More Is Less) المنشور عام 2004م أكثر من 280 نوعًا من البسكويتات، وأكثر 90 نوعًا من بطاطا الشيبس، وأكثر من 60 نوعًا من المشروبات المخصصة للأطفال متوفرة في الأسواق الأمريكية، وقس على ذلك أنواع الأجهزة الالكترونية والحاسبات والسيارات والهواتف...الخ.
[12] إلفين توفلر، صدمة المستقبل- المتغيرات في عالم الغد، ص334، ترجمة محمد ناصف، طبع نهضة مصر، ط 2 1990م.
[13] بواسطة: تود سلون، حياة تالفة-أزمة النفس الحديثة، ص242، ترجمة د.عبدالله الشهري، نشر ابن النديم ودار الروافد، ط1 2021م.
[14] أنتوني جيدنز، عالم جامح- كيف تعيد العولمة تشكيل حياتنا، ص75-76، ترجمة عباس كاظم وحسن ناظم، نشر المركز الثقافي العربي، ط1 2003م. وبطبيعة الحال فهناك أسباب أخرى مباشرة ومعروفة لانتشار الإدمانات؛ كتوافر المتع، وكثرتها، وتنوعها، والدعاية المفرطة لاستهلاكها؛ لذا ينتقد الروائي ميشيل ويلبك (و1956م) صناعة الترفيه الحداثية، ويقول: "لقد روّج [النموذج الليبرالي] لتحرير الرغبات، وبذلك أغرق ملايين الناس في التعاسة"، لأن "الرغبة ليست قوة طبيعية، ولكنها نتاج المجتمع، وبدون الرغبة لا يمكن للمجتمع الليبرالي أن يسير، والمجتمع يغذّي –باستمرار- الرغبة لكن دون أن يشبعها، وهكذا كلما زادت رغباتنا زاد إحباطنا". بواسطة: نانسي هيوستن، أساتذة اليأس-النزعة العدمية في الأدب الأوروبي، ص281، ترجمة وليد السويركي، نشر دار كلمة، ط1 1433هـ. بل إن الإحباط نفسه ضروري لاستمرار العجلة الرأسمالية، يقول رئيس سابق لشركة جنرال موتورز: "إن مفتاح الرفاهية الاقتصادية هو خلق إحباط منظّم". بواسطة باسكال بروكنر، بؤس الرفاهية- ديانة السوق وأعداؤها، ص193، ترجمة عبدالله ولد أباه، نشر مكتبة العبيكان، ط1 1427هـ. وللمزيد انظر: نعوم تشومسكي، صناعة الرغبات: كيف تتحكم في حياة وطريقة تفكير إنسان؟، ترجمة يوسف النوخذة، نشر في موقع مجلة حكمة، بتاريخ 3/9/2019م.
[15] تود سلون، مصدر سابق، ص28. بتصرف واختصار.
[16] انظر: المصدر السابق، ص34.
انقر هنا للوصول إلى صفحة الكتاب كاملاً.
انقر على الصورة للوصول إلى النسخة المصورة (pdf) قابلة للتحميل والنشر.