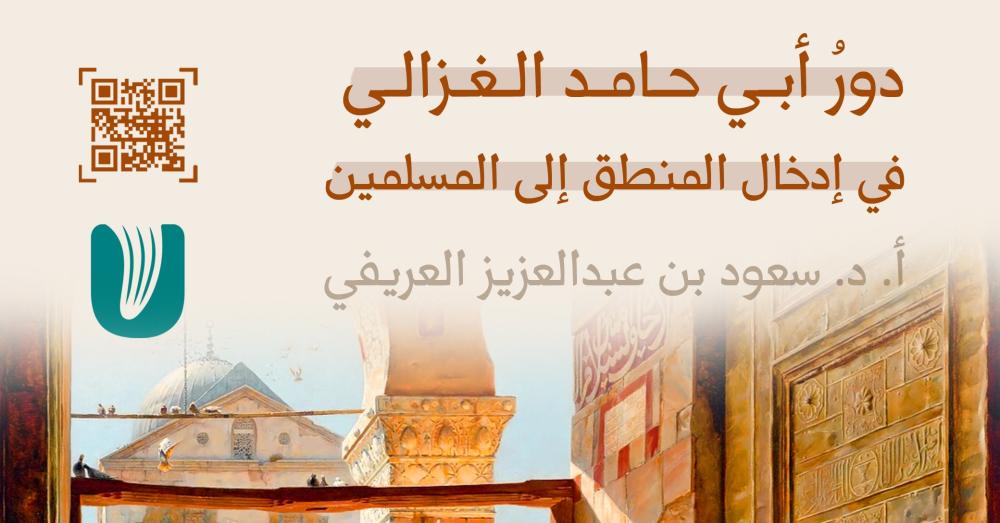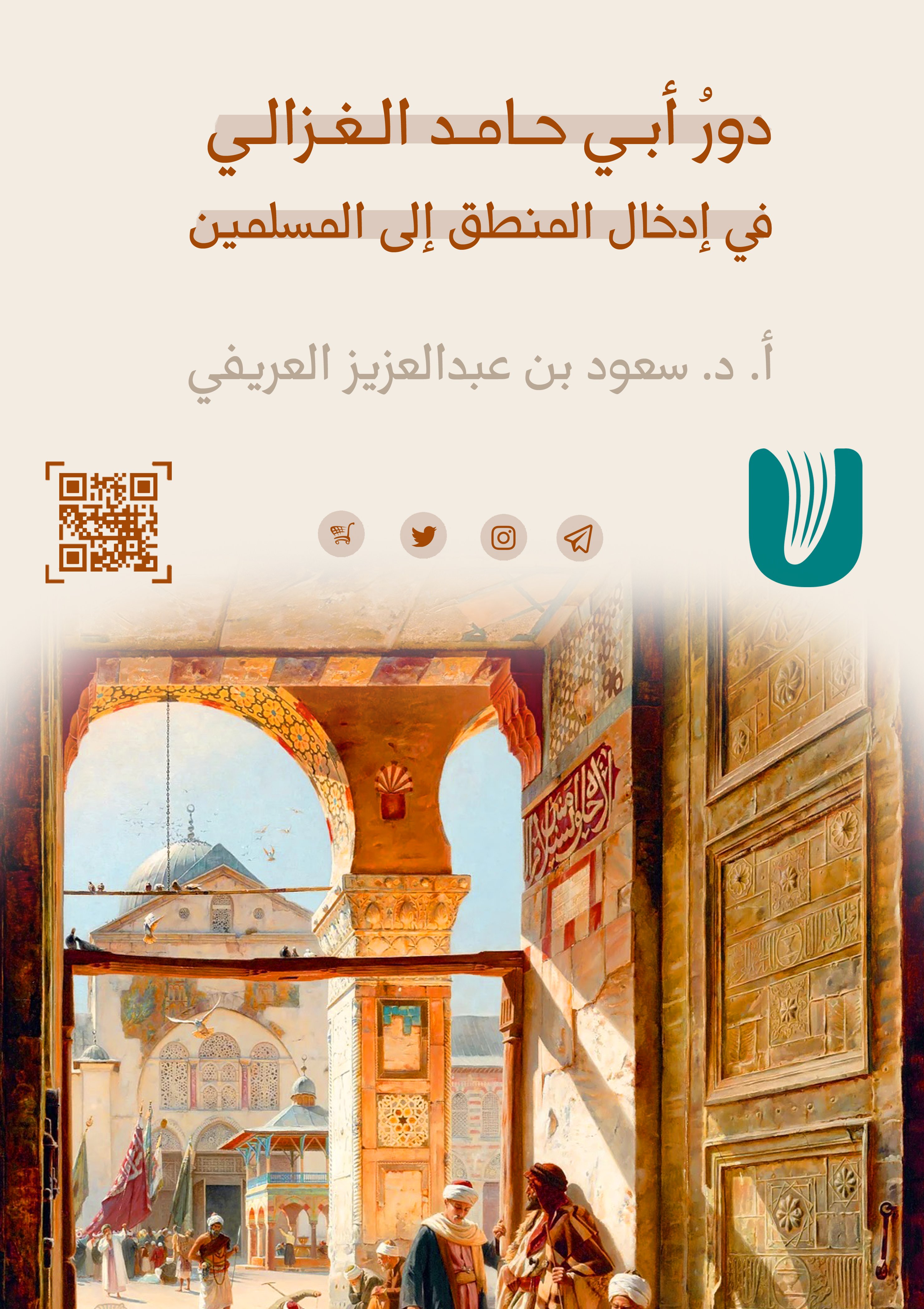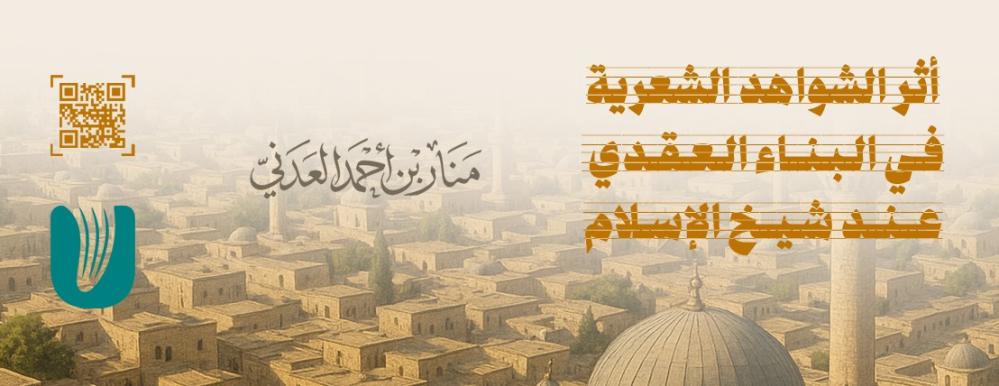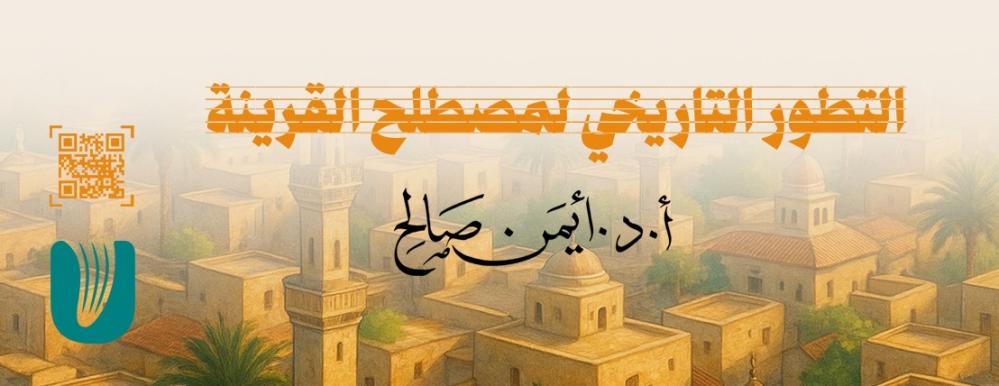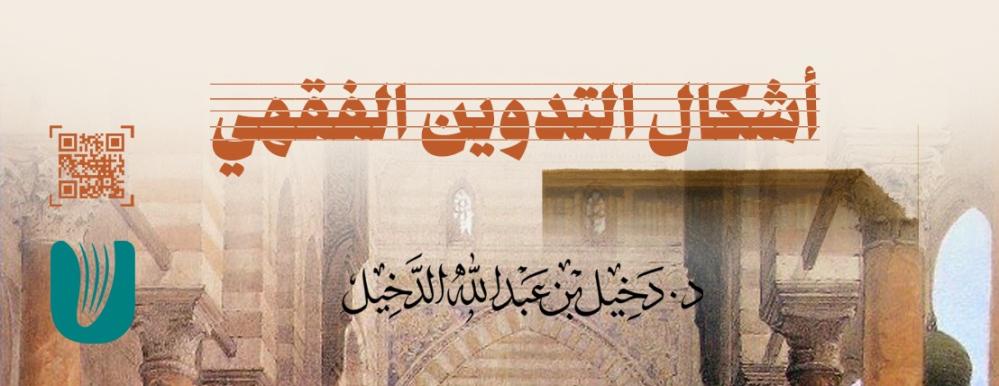دور أبي حامد الغزالي
في إدخال المنطق إلى المسلمين
أ.د. سعود بن عبدالعزيز العريفي
لئن كان المأمون في رأي ابن تيمية هو من تولَّى كِبْرَ إدخال الفلسفة على المسلمين، على الأقل من الناحية السياسية، فإن الغزاليَّ في نظره هو من تولى من الناحية العلمية كِبْر إقحام المنطق في العلوم الشرعية، ولا سيما الأصلين: أصولِ الفقه وأصول الدين؛ حيث قال الغزالي في أول كتابه "المستصفى في أصول الفقه"[1]: (نذكر في هذه المقدمة مداركَ العقول وانحصارَها في الحد والبرهان، ونذكر شرط الحد الحقيقيَّ وشرط البرهان الحقيقيَّ وأقسامَهما، على منهاجٍ أوجزَ مما ذكرناه في كتاب "مِحك النظر" وكتاب "معيار العلم"، وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول، ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمةُ العلوم كلِّها، ومن لا يحيط بها فلا ثقةَ له بعلومه أصلًا).
ووافقه على هذا القَرافي (ت ٦٨٤هـ) من المالكية، فقال معلقًا على قول الرازي في شروط الاجتهاد: (يُشترط معرفةُ شرائط الحد والبرهان على الإطلاق)، قال القرافي: (لا يكمُلُ معرفةُ ذلك إلا بإيعاب علم المنطق؛ فإنه ليس فيه إلا ذلك، فيكون المنطق شرطًا في منصب الاجتهاد)[2]، واستحسن هذا ابنُ حجر الهيتميُّ (ت ٩٧٣هـ)[3].
وقد علق ابن الصلاح على قول الغزالي السابق بقوله: (هذا مردود؛ إذ كلُّ صحيح الذهن منطقيٌّ بالطبع، وكم من إمام ما رفع بالمنطق رأسًا)[4].
والعجيب أن هذا الإقحام للمنطق في كتابٍ في أصول الفقه لم يَرُقْ حتى للفيلسوف ابن رشد (ت ٥٩٥هـ)، على الأقل من الناحية الفنية؛ فإنه عندما اختصر "مستصفى الغزالي" أسقط منه المقدمة المنطقيةَ قائلًا: (وأبو حامد قدَّم قبل ذلك مقدمة منطقية، زعم أنه أدَّاه إلى القول في ذلك نظرُ المتكلمين في هذه الصناعة في أمورٍ ما منطقية، كنظرهم في حد العلم وغير ذلك. ونحن فلنترك كلَّ شيء إلى موضعه؛ فإن من رام أن يتعلم أشياءَ أكثرَ من واحد في وقت واحد، لم يمكنْه أن يتعلم ولا واحدًا منها)[5].
وهذا على خلاف رأي الفقيه ابن قُدامة الحنبلي (ت ٦٢٠هـ)، الذي استبقى المقدماتِ المنطقيةَ في كتابه الأصولي "روضة الناظر، وجُنَّة المناظر"، الذي بناه على "مستصفى الغزالي"[6]. فهل كان هذا قناعة من ابن قدامة برأي الغزالي في ضرورة المنطق، أم مجرد تعاطٍ مع الأمر الواقع، وأن معرفة مصطلحات المنطق صارت ضرورية لدارسي الأصول؟.
والغزالي نفسُه صرح في نَصِّه السابق بأن هذه المقدمة المنطقيةَ ليست من علم الأصول، لكنه لم يقصدْ عدم توقُّفْ فهم علم أصول الفقه عليها، وإنما قصد عدمَ اختصاصها به، بل هي شرطٌ لفهم جميع العلوم النظرية؛ كما يتبين من تتمة كلامه، قال: (فمن شاء ألا يكتبَ هذه المقدمةَ فليبدأ بالكتاب من القُطب الأول؛ فإن ذلك هو أولُ أصول الفقه، وحاجةُ جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه)[7].
ومن مبالغة الغزالي في الاعتداد بالمنطق أنه ألبسه ثوبًا قرآنيًّا! فقد فسَّر مراتب الدعوة المذكورة في الآية الكريمة: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}[النحل ١٢٥] بالأقيسة المنطقية الثلاثة: البرهاني والخِطابي والجَدلي![8]. وكرر هذا التفسيرَ الفيلسوفُ ابنُ رشد (ت ٥٩٥هـ)[9].
قال ابن القيم: (وهذا باطل؛ وهو مبنيٌّ على أصول فلسفية؛ وهو منافٍ لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة)[10].
وقال أيضًا: (هذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين، ولا أحدٍ من أئمة التفسير، بل ولا من تفاسير المسلمين؛ وهو تحريفٌ لكلام الله تعالى، وحَمْلٌ له على اصطلاح المنطقية المبخوسة الحظِّ من العقل والإيمان. وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية... والقرآن بريءٌ من ذلك كله، منزَّهٌ عن هذه الأباطيل والهذَيانات)[11].
وقد ذكر الغزالي في مقدمة "معيار العلم" أن الباعثَ له على تحرير هذا الكتاب هو (تفهيمُ طرق الفكر والنظر، وتنوير مسالك الأقيسة والعِبَر؛ فإن العلوم النظرية لـمَّا لم تكن بالفطرة والغريزة مبذولةً وموهوبة، كانت لا محالة مستحصَلةً مطلوبة، وليس كلُّ طالب يُحسن الطلب... فلما كثر في المعقولات مَزَلَّةُ الأقدام، ومثارات الضلال، ولم تنفَكَّ مرآة العقل عما يُكَدِّرُها من تخليطات الأوهام وتلبيسات الخيال، رتبْنا هذا الكتاب معيارًا للنظر والاعتبار، وميزانًا للبحث والافتكار، وصَيقَلًا للذهن، ومِشحَذًا لقوة الفكر والعقل، فيكون بالنسبة إلى أدلة العقول كالعَروض بالنسبة إلى الشعر، والنحوِ بالإضافة إلى الإعراب، إذ كما لا يُعرف منزحِفُ الشعر عن موزونه إلا بميزان العروض، ولا يميَّز صوابُ الإعراب عن خطئه إلا بمِحكِّ النحو، كذلك لا يفرَّق بين فاسد الدليل وقويمه وصحيحه وسقيمه إلا بهذا الكتاب، فكلُّ نظرٍ لا يتَّزِنُ بهذا الميزان، ولا يعايَر بهذا المعيار، فاعلم أنه فاسد العيار، غير مأمون الغوائل والأغوار)[12].
ثم أورد اعتراضًا بأن العاقل مستغنٍ بكمال عقله الفطري عن هذا المعيار والميزان، وأجاب على هذا الاعتراض بأن الفطرةَ قد تنحرِف بالانقياد لحاكمَي الحسِّ والوهم، فتُقدِّمَهما على حاكم العقل؛ رغم جواز الخلل عليهما.
وضرب مثلًا لغلط الحس بعدم انتباهه لحركة الظلِّ ونمو الطفل عن النمو، بسبب بطئهما الشديد، فحاكِمُ العقل يصحِّح هذا الغلط.
ثم انتقل مع حاكم الوهم إلى مثال عقَدي يتجلَّى به توظيفُ المنطق في التأويل العقدي، فقال: (وأما الحاكم الوهمي فلا تغفُلْ عن تكذيبه بموجود لا إشارةَ إلى جهته، وإنكاره شيئًا لا يناسب أجسام العالم بانفصال واتصال، ولا يوصف بأنه داخلَ العالم ولا خارجه، ولولا كفايةُ العقل شرَّ الوهم في تضليله هذا، لرسخ في نفوس العلماء من الاعتقادات الفاسدة في خالق الأرض والسماء، ما رَسَخ في قلوب العوامِّ والأغبياء)[13].
وما وصفه هنا بالاعتقادات الفاسدة عند العوام والأغبياء ما هو إلا ما أجمع عليه السلفُ، وصرحَّ به الوحي من إثبات العلو الذاتي للباري جل وعلا! وحُجة السلف العقليةُ عليه هي امتناع موجود لا داخلَ العالم ولا خارجه؛ فإن هذا سلبٌ للنقيضين، ولا يليق بكمال الله وعظمته أن يكون مخالِطًا لخلقه، فيلزم إذن أن الله تعالى خارجٌ عن العالم منفصلٌ عن خلقه بائنٌ منهم، وإذا ثبت ذلك لزم منه إثباتُ علو الله على خلقه؛ لأن هذا مقتضى الكمال[14].
فالغزالي هنا يريد إبطالَ هذه الحُجَّة العقلية بزعم وهميَّتها، والوهْمُ إنما يَأخذ من الحس، فحاكمُ العقل إذن لا يقبلها، كما لم يقبلْ من الحس ظنَّه عدمَ حركة الظل ونموَّ المولود. بل هو يصف حاكمَي الحس والوهم في مثل هذا بالخيانة، ويزعُمُ أن الشرع سماهما وساوسَ، ونسبهما إلى الشيطان!
ثم زعم أن الخلاصَ من إغواء حاكِمَي الحس والوهم يكون بتلطف العقل بترتيب المقدمات التي يسلِّم بها الوهم، حتى يوصِلَه إلى النتيجة التي ينكرها، فيتجلى أن إنكاره إنما كان لقصورٍ في طِباعه لا لكونها كاذبةً. وهذا هو غرضُ كتابه الذي كان به معيارًا للعلم[15]!
ثم أورد سؤالًا عن سبب اختلاف مقالات النُّظَّار رغم اعتمادهم على المنطق، وأجاب من وجهين:
1. أن قُوى أكثرهم تقصُر عن تجاوز عقبات الاستدلال وتحقيق شروط البرهان المنتِج لليقين.
2. شدةُ اشتباه القضايا الكاذبة بالصادقة على الوهم[16].
وهكذا فالغزالي عفا الله عنه يعلن بأصرحِ عبارةٍ في مقدمة كتابه المنطقي الأوسع والأهم "معيار العلم" غرضَه الرئيسيَّ من مشروع إقحام منطق اليونان في علوم الإسلام؛ ألا وهو تحييدُ العقل الصريح عن تأييد مذهب السلف في الصفات الإلهية، الذين سمَّاهم العوامَّ والأغبياء[17]! ويجترئ على نسف إجماعهم على ما صرَّح به الوحيُ من عقيدة العلوِّ الإلهي فوق العرش، المؤيَّدة بالفطرة السليمة والعقل الصريح، بمجرد إلحاقها بمصطلح يخترعه ويكرِّره: "حكمُ الوَهْم"[18].
فها هو يؤكد ما ذكره في المقدمة فيقول عند بيانه القسمَ الثاني من مواد القياس، وهي التي لا تصلح للبراهين؛ لكونها ليست يقينيةً: (النوع الثاني: ما لا يصلح للقطْعيَّات ولا للظنيَّات، بل لا يصلح إلا للتلبيس والمغالطة، وهي المشبِهاتُ؛ أي: المشبِهةُ للأقسام الماضية في الظاهر ولا تكون منها، وهي ثلاثة أقسام: الأول: الوهْميات الصِّرفة، وهي قضايا يقضي بها الوهم الإنساني قضاءً جزمًا برِيًّا عن مقارنة ريبٍ وشك، كحُكمه في ابتداء فطرته باستحالة وجود موجود لا إشارَة إلى جهته، وأن موجودًا قائمًا بنفسه لا يتصل بالعالم ولا ينفصل عنه، ولا يكون داخلَ العالم ولا خارجَه: مُحالٌ، وهذا يشبِهُ الأوليَّات العقليةَ، مثلَ القضاء بأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، والواحدَ أقلُّ من الاثنين؛ وهي أقوى من المشهورات التي مثَّلْناها بأن العدلَ جميل والجَوْر قبيح، وهي مع هذه القوة كاذبةٌ مهما كانت في أمور متقدمة على المحسوسات أو أعمَّ منها؛ لأن الوهم أنِسَ بالمحسوسات، فيقضي لغير المحسوس بمثل ما ألِفه في المحسوس. وعُرف كونُه كاذبًا من مقدمات يصدِّق الوهم بآحادها لكن لا يُذعنُ للنتيجة؛ إذ ليس في قوة الوهم إدراكُ مثلها. وهذا أقوى المقدمات الكاذبة؛ فإن الفطرةَ الوهمية تحكُم بها حسَب حكمها في الأوليات العقلية، ولذلك إذا كانت الوهميَّاتُ في المحسوسات كانت صادقةً يقينيةً، وصحَّ الاعتماد عليها كالاعتماد على العقليات المحضة وعلى الحسيات)[19].
والعجيب أنه مع هذا التحكم والاجتراء يجعل العقل الصريح حِكْرًا على ما قرره وثنيُّو اليونان وملاحدتُهم! فلا لوم بعد ذلك على محققي أهل السنة أن يخُصُّوا مقالاتِه ومؤلفاته بالنقد والتمحيص؛ إذ أدركوا تمامًا مآلاتِ منهجه.
قال ابن تيمية: (وما زال نُظَّار المسلمين يعيبون طريق أهل المنطق، ويبينون ما فيها من العِيِّ واللُّكنة، وقصور العقل وعجز النطق، ويبيِّنون أنها إلى إفساد المنطق العقلي واللساني أقربُ منها إلى تقويم ذلك، ولا يرضَون أن يسلكوها في نظرهم ومناظرتهم، لا مع من يوالونه ولا مع من يعادونه. وإنما كثُر استعمالها من زمن أبي حامد؛ فإنه أدخل مقدمةً من المنطق في أول كتابه "المستصفى"، وزعم أنه لا يوثق بعلمه إلا من عرَف هذا المنطقَ، وصنَّف فيه "معيار العلم" و"مِحك النظر"، وصنف كتابًا سماه: "القسطاس المستقيم"، ذكر فيه خمسة موازين: الضروب الثلاثة الحَمْليات، والشرطيَّ المتصل، والشرطيَّ المنفصل، وغيَّر عبارتها إلى أمثلةٍ أخذها من كلام المسلمين، وزعم أنه أخذ تلك الموازينَ من الأنبياء! وذكر أنه خاطب بذلك بعضَ أهل التعليم، وصنف كتابًا في مقاصدهم، وصنف كتابًا في تهافتهم، وبيَّن كفرهم بسبب مسألة قِدَم العالَم، وإنكار العلم بالجزئيات، وإنكار المعاد.
وبيَّن في آخر كتبه أن طريقهم فاسدةٌ لا توصِل إلى يقين، وذمَّها أكثرَ مما ذمَّ طريقة المتكلمين، لكن بعد أن أودع كتبَه المضنونَ بها على غير أهلها وغيرها من معاني كلامهم الباطل المخالف لدين المسلمين ما غيَّر عبارتَه وعبَّر عنه بعبارة المسلمين التي لم يريدوا بها ما أراده...).
إلى أن قال: (والمقصود هنا أن كتب أبى حامد وإن كان يذكُر فيها كثيرًا من كلامهم الباطل، إما بعبارتهم أو بعبارة أخرى، فهو في آخِر أمره يبالغ في ذمِّهم، ويبين أن طريقهم متضمِّنة من الجهل والكفر ما يوجب ذمَّها وفسادها أعظمَ من طريقة المتكلمين، ومات وهو مشتغِلٌ بالبخاري ومسلم، والمنطقُ الذي كان يقول فيه ما يقول ما حصَّل له مقصودَه، ولا أزال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة، بل كان متوقفًا حائرًا فيما هو من أعظم المطالب العالية الإلهية، والمقاصد السامية الربانية، ولم يُغْنِ عنه المنطق شيئًا، ولكن بسبب ما وقع منه في أثناء عمره وغير ذلك صار كثير من النُّظَّار يُدخلون المنطق اليوناني في علومهم، حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من المتأخرين يظن أنه لا طريقَ إلا هذا، وأن ما ادَّعوه من الحد والبرهان هو أمر صحيح مسلَّمٌ عند العقلاء، ولا يَعلم أنه ما زال العقلاءُ والفضلاء من المسلمين وغيرهم يعيبون ذلك ويطعَنون فيه، وقد صنف نُظَّار المسلمين في ذلك مصنفاتٍ متعددةً، وجمهور المسلمين يعيبونه عيبًا مجملًا؛ لما يرونه من آثاره ولوازمه، الدالة على ما في أهله مما يناقض العلمَ والإيمان، ويُفْضي بهم الحال إلى أنواع من الجهل والكفر والضلال)[20].
وقال أيضًا: (والمقصود هنا أن نُظَّار المسلمين ما زالوا يصنفون في الرد عليهم في المنطق وغير المنطق، ويُبَيِّنون خطأهم فيما ذكروه في الحد والقياس جميعًا، كما يُبَيِّنون خطأهم في الإلهيات وغيرها، ولم يكن أحد من نُظَّار المسلمين يلتفت إلى طريقتهم، بل المعتزلة والأشعرية والكَرَّامية والشيعة وسائر طوائف النظر كانوا يعيبونها ويثبتون فسادها، وأولُ من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي، وتكلم فيه علماءُ المسلمين بما يطول ذكره)[21].
ونُقِل عن أبي بكر بن العربي قوله عن شيخه الغزالي: (شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قَدَر )[22].
وذَكر عن ابن القشيري قوله في الغزالي:
برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من كتاب الشفا
وكم قلت يا قومُ أنتم على شفا جرف من كتاب الشفا
فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله حتى كفى
فماتوا على دين رِسطالسْ وعشنا على ملة المصطفى[23]
وقال ابن تيمية في أول المقام الثاني من رده؛ وهو ما خصَّصه لنقد دعوى أن فائدةَ الحد المنطقي تصويرُ المحدود: (وإنما دخل هذا في كلام من تكلم في أصول الدين والفقه بعد أبي حامد، في أواخر المائة الخامسة وأوائل المائة السادسة، فأما أبو حامد فقد وضع مقدمةً منطقيةً في أول "المستصفى"، وزعم أن من لم يُحِطْ بها علمًا فلا ثقة له بشي من علومه، وصنف في ذلك "محك النظر" و"معيار العلم"، ودوامًا اشتدت به ثقتُه، وأُعجِب من ذلك أنه وضع كتابًا سماه "القسطاس المستقيم"، ونسبه إلى أنه تعليم الأنبياء، وإنما تعلَّمه من ابن سينا؛ وهو تعلَّمه من كتب أرسطو، وهؤلاء الذين تكلموا في الحدود بعد أبى حامد هم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني، وأما سائرُ طوائف النُّظَّار من جميع الطوائف المعتزلة والأشعرية والكَرَّامية والشيعة وغيرهم ممن صنف في هذا الشأن من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، فعندهم إنما تفيد الحدودُ التمييزَ بين المحدود وغيره... وهذا مشهورٌ في كتب أهل النظر في مواضعَ يطول وصفها من كتب المتكلمين من أهل الإثبات وغيرهم، كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر، وأبي إسحاق، وأبي بكر بن فورك، والقاضي أبي يعلى، وابن عَقيل، وأبي المعالي الجويني، وأبي الميمون النسَفي الحنفي، وغيرهم، وقبلَهم أبو علي وأبو هاشم وعبد الجبار وأمثالهم من شيوخ المعتزلة، وكذلك ابن النُّوبَخْتيِّ[24] والموسوي والطوسي، وغيرهم من شيوخ الشيعة، وكذلك محمد بن الهَيْصَم وغيره من شيوخ الكَرَّامية؛ فإنهم إذا تكلموا في الحد قالوا: إن حدَّ الشيء وحقيقته خاصتُه التي تميزه)[25].
والقصد من الإطالة بذكر تأكيد ابن تيمية على الدور الرئيسي للغزالي في ترويج المنطق بين الشرعيين، وابتداعه خلطَ المنطق بأصول المسلمين: التنبيهُ على أن ابن تيمية في رده على المنطقيين إنما ينسُب لهم ما ينسُب من الآراء والقواعد بحسَب ما قرره عنهم وعبَّر به أبو حامد الغزالي في كتبه المنطقية، ولا سيما "معيار العلم" الذي وصفه ابنُ تيمية بالكبير، فهو المرجع الأساس لابن تيمية في توثيق آراء المناطقة، وإن كان قد اطلع على كتب أرسطو وابن سينا والرازي وغيرهم، كما صرح في رده ونقل عن بعضها، لكن الذي فشا في المتفقهين إنما هو ما قرَّره الغزالي، وعنه أخذ المتأخرون[26].
وقد قال الدكتور علي النشَّار عن كتاب "المستصفى في أصول الفقه":(ولهذا الكتاب أهمية خاصة في تاريخ علم أصول الفقه؛ لأن صاحبَه أول من مزج علوم المسلمين بالمنطق، وكان هذا المزجُ في "المستصفى")[27].
ولعل من المهم أخيرًا التنويهَ بما ذكره السيوطي من رجوع الغزالي عن إباحة المنطق فيما نقله بعض العلماء[28].
والأشبهُ أن هذا من جنس ما ذكره شارح "الطحاوية" وغيره من أن الغزالي (انتهى أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطُّرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات و"البخاريُّ" على صدره)[29].
هذا ولم ينفرد الغزالي بين الفقهاء بتعظيم المنطق والاعتداد به، فهذا ابن حزم الظاهريُّ (ت٤٠٦هـ) قد سبقه إلى تعظيمه وجعْله شرطًا للتفقُّه؛ فقد ألّف فيه رسالته: "التقريب لحد المنطق، والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية"، قال في صدرها: (ومن لم يعلمْ صفاتِ الأشياء المسمَّيات، الموجبةَ لافتراق أسمائها، ويحدَّ كل ذلك بحدودها، فقد جهِل مقدارَ هذه النعمة النفيسة، ومر عليها غافلًا عن معرفتها، مُعرِضًا عنها، ولم يَخِبْ خيبةً يسيرة بل جليلةً جدًّا.
فإن قال جاهلٌ: فهل تكلم أحدٌ من السلف الصالح في هذا؟ قيل له: إن هذا العلم مستقرٌّ في نفس كل ذي لُبٍّ؛ فالذهنُ الذكيُّ واصِلٌ بما مكَّنه الله تعالى فيه من سَعة الفهم إلى فوائد هذا العلم، والجاهل مُنكسِعٌ كالأعمى حتى يُنبَّه عليه.
وهكذا سائر العلوم؛ فما تكلم أحدٌ من السلف الصالح رضي الله عنهم في مسائل النحو، لكن لما فشا جهلُ الناس باختلاف الحركات التي باختلافها اختلفت المعاني في اللغة العربية، وضع العلماءُ كتب النحو، فرفعوا إشكالًا عظيمًا، وكان ذلك مُعينًا على الفهم لكلام الله عز وجل، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان مَن جهِل ذلك ناقصَ الفهم عن ربه تعالى، فكان هذا من فعِل العلماء حسَنَا، وموجِبًا لهم أجرَا، وكذلك القول في تواليف كتب العلماء في اللغة والفقه؛ فإن السلف الصالح غَنُوا عن ذلك كله بما آتاهم اللهُ به من الفضل ومشاهدة النبوة، وكان مَن بعدهم فقراءَ إلى ذلك كله، يُرى ذلك حسًّا، ويُعلم نقصُ من لم يطالع هذه العلوم ولم يقرأ هذه الكتب، وأنه قريبُ النسبة من البهائم.
وكذلك هذا العلم؛ فإن من جهِله خفي عليه بناءُ كلام الله عز وجل مع كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاز عليه من الشَّغْب جوازًا لا يفرَّق بينه وبين الحق، ولم يعلم دينه إلا تقليدًا، والتقليد مذمومٌ، وبالحِرَى إن سلِم من الحيرة، نعوذ بالله منها. فلهذا وما نذكره بعد هذا إن شاء الله، وجب البِدارُ إلى تأليف هذا العلم، والتعبُ في شرحه وبسطه، بحول الله وقوته)[30].
ومع هذا الغلوِّ من ابن حزم في المنطق فقد كان أثره محدودًا في شيوع المنطق بين الفقهاء، إذا ما قِيسَ بتأثير الغزالي، ولعل ذلك راجعٌ إلى نفرتهم من ظاهرية ابن حزم وغلظته مع مخالفيه، ولا سيما الأشاعرةَ الذين كان مذهبهم سائدًا آنذاك[31]، لذلك نرى ابن تيمية يكتفى بالإشارة إلى ابن حزم عند ذكر ما يُثْبِتُه المناطقة من أقسام الوجود، وأن أكثرها عائدٌ إلى مُقدَّرات ذهنيةٍ لا وجود لها في الخارج، قال: (وقد اعترف بذلك من ينصرُهم ويعظِّمهم كأبي محمدِ بن حزمٍ وغيرِه، ولتعظيمه المنطقَ رواه بإسناده إلى متَّى، التَّرجُمانِ الذي ترجمه إلى العربية)[32].
---------------------------------------------------------
[1] ص ١٠. وقد لاحظ ابن طملوس الأندلسي (ت ٦٢٠هـ) أن الغزالي يتحاشا ذكر لفظ "منطق" في عناوين كتبه المنطقية؛ لما لحق هذا اللقب من الذم والاستهجان. انظر: "التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية"، ص ١٥٤.
[2] انظر: القرافي، "نفائس الأصول في شرح المحصول"، (٩/٣٨٣٣)، وانظر له: "شرح تنقيح الفصول"، ص ٤٣٧.
[3] انظر: "الفتاوى الكبرى الفقهية"، (١/٥٠).
[4] انظر: الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، (١٩/٣٢٩).
[5] "الضروري في أصول الفقه"، ٣٧، ٣٨، تحقيق جمال الدين علوي، ط١، ١٩٩٤م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
[6] انظر: على الشبكة العالمية: http://feqhweb.com/vb/t3141.html
[7] "المستصفى"، ص ١٠.
[8] انظر: الغزالي، "القسطاس المستقيم"، ص ١٢، ١٣، ٦٢، ٦٣، تحقيق محمود بيجو، ١٤١٣هـ، المطبعة العلمية، دمشق. ولمحمد مهران بحث: "المنطق والموازين القرآنية، قراءة لكتاب القسطاس المستقيم للغزالي"، نشره المعهد العالمي للفكر الإسلامي ضمن سلسلة أبحاث علمية (١٣).
[9] انظر: "فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال"، ص ٣٠، ٣١، تحقيق محمد عمارة، دار المعارف، ط٢. وانظر: محمد رشاد سالم، "مقارنة بين الغزالي وابن تيمية" ص ٣٥ – ٣٨، دار القلم، ١٤١٣هـ، الكويت.
[10] "مفتاح دار السعادة" (١/٤٣٣).
[11] السابق، (١/٤٩١، ٤٩٢).
[12] "معيار العلم"، ص ٥٩، ٦٠.
[13] "معيار العلم"، ٦٣.
[14] انظر: ابن أبي العز، "شرح العقيدة الطحاوية"، (٢/٣٨٩ – ٣٩١).
[15] انظر: "معيار العلم"، ص ٦٤، ٦٥.
[16] انظر: "معيار العلم"، ٦٥.
[17] قال يزيد بن هارون: (من زعم أن {الرحمن على العرش استوى}[طه ٥] على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي). رواه عبد الله بن أحمد في "السنة" (٢/٤٨٢) رقم ١١١٠، وانظر: ابن تيمية، "بيان تلبيس الجهمية"، (١/٤٣٥).
[18] كرر الغزالي دعواه أن الحكم بامتناع موجود لا داخل العالم ولا خارجه حكمٌ وهمي لا عقلي في مواضع من "معيار العلم"، انظر: منه: ص ٦٣، ١٩٩، ٢٢٦.
[19] "معيار العلم"، ص ١٩٨، ١٩٩.
[20] "الرد على المنطقيين"، ص ١٩٤ – ١٩٨.
[21] "الرد على المنطقيين"، ص ٣٣٧.
[22] "الرد على المنطقيين"، ص ٤٨٣.
[23] "الرد على المنطقيين"، ص ٥١٠، ٥١١. وقد وقع فيه خطأً: (ابن العربي) مكان (ابن القشيري)، والتصحيح من مختصر السيوطي ص ٣٤٢. كما وقع في المختصر: [قطعنا الأخوة] بدل: (برئنا إلى الله).
[24] هو الحسن بن موسى، (ت ٣٠٠هـ)، ذُكرت له رسالة في نقد المنطق، لكنها مفقودة، وقد نقل ابن تيمية بعض آرائه النقدية للقياس المنطقي. انظر: مصطفى طباطبائي، "المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني"، ص ٣٢.
[25] "الرد على المنطقيين"، ص ١٤ – ١٦.
[26] رجح وائل الحارثي أن الغزالي ليس له سبق خاص في خلط الفلسفة والمنطق بالعلوم الإسلامية، بل سبقه بذلك المعتزلة وبعض الأشاعرة، وإنما تميز بتخصصه في الفلسفة شرحًا ونقدًا، وبكثرة مصنفاته المنطقية، ما جذب الانتباه عن دور من سبقه. انظر: "علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق" ص ١٩١.
[27] "مناهج البحث" ص ٣٦٦.
[28] انظر: السيوطي، "القول المشرق في تحريم المنطق"، ص ١٣٢، تحقيق السيد عبد الوهاب، دار الحديث، القاهرة، ٢٠٠٨م.
[29] ابن أبي العز: "شرح العقيدة الطحاوية"، (١/٢٤٣، ٢٤٤).
[30] "التقريب لحد المنطق"، ص ١٠، تحقيق أحمد المزيدي، دار الكتب العلمية.
[31] انظر: سلطان العميري، "تميز ابن تيمية في نقد المنطق الأرسطي"، بحث منشور ضمن كتابه "إضاءات في التحرير العقدي"، ص ٢٣٥ – ٢٣٧.
[32] "الرد على المنطقيين" ص ١٣١، ١٣٢، وانظر ص ٣٠٧.
انقر هنا للوصول إلى صفحة الكتاب كاملاً.
انقر على الصورة للوصول إلى النسخة المصورة (pdf) قابلة للتحميل والنشر.