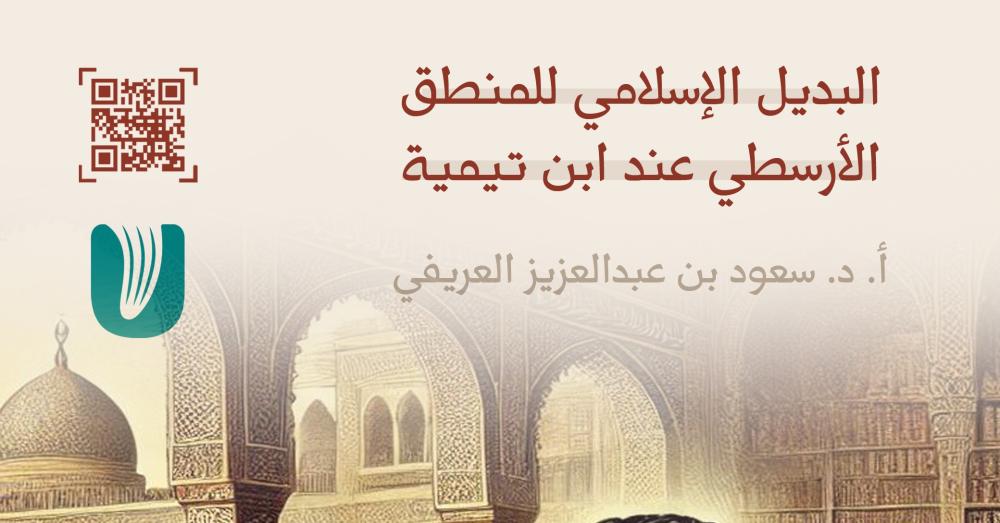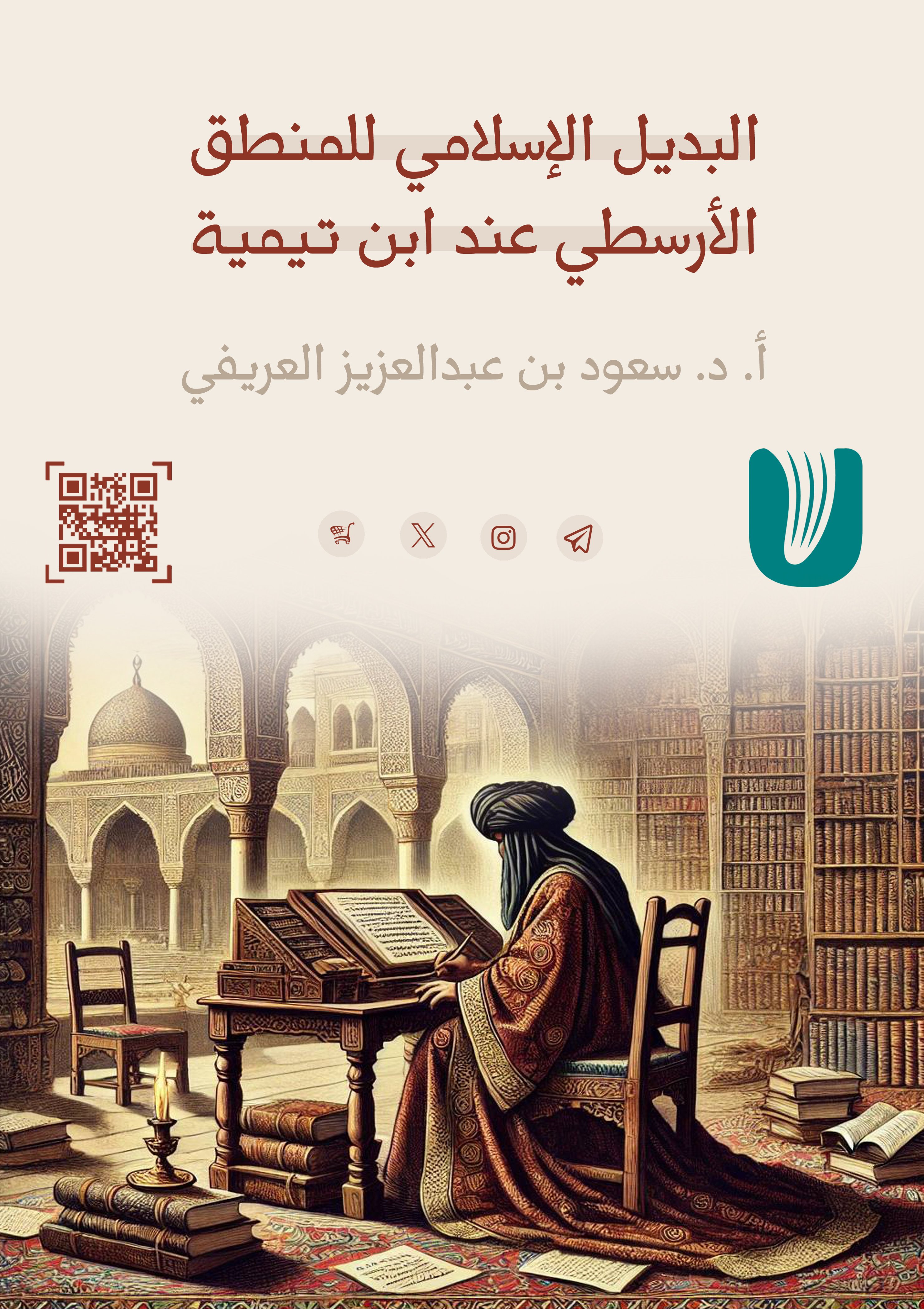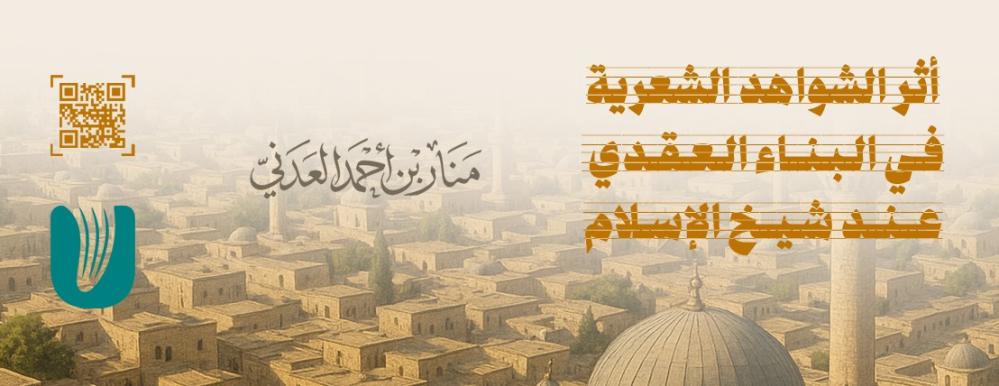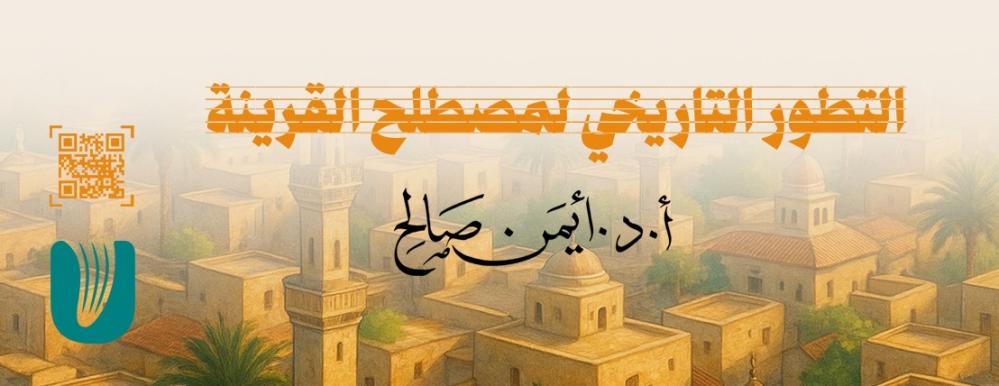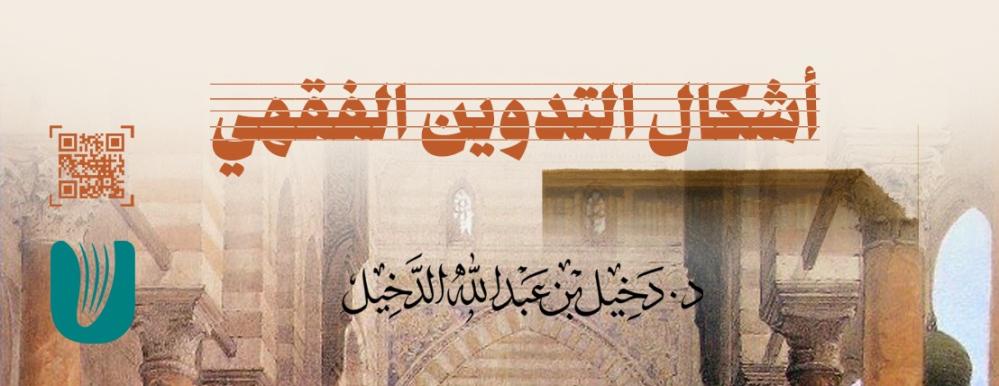البديل الإسلامي للمنطق الأرسطي عند ابن تيمية
د.سعود العريفي
لم يقتصِرِ النقد التيمي للمنطق اليوناني على جانب الهدم، بل إنه قدَّم بديلًا إسلاميًّا مستمدًّا من الفطرة السهلة، والوحي المبين، واستعمالات علماء المسلمين، سواءٌ في قسم التصورات أو التصديقات:
أولًا: بدائل الحد الأرسطي:
لئن نقض ابنُ تيمية الحد الأرسطيَّ القائم على الذاتيات المقوِّمة للماهية، بنقض التفريق بين الذاتي والعرَضي، وبإيراد اللوازم الباطلة للحد الأرسطي كالدَّور أو التسلسل أو الاستعصاء، وغير ذلك من وجوه النقد التي لا انفكاكَ منها، فلقد حرَص ابن تيمية على بيان البديل السالم من هذه الانتقادات؛ وهو ما اتفق عليه نُظَّارُ المسلمين من كفاية التمييز بين المحدود وغيره غايةً للحد، ولو لم يكن التمييز بالصفات الذاتية، وإنما يُشترط لهذا التمييز تحقُّق المساواة بين المعرِّف والمعرَّف بالاطراد والانعكاس، بأن يكون الوصف المميِّزُ للمعرَّف جامعًا لجميع أفراده، مانعًا لغيرها من الدخول في التعريف، فهذا هو القدْر الفِطري الشرعي للحد، وعليه جرى خطابُ الشريعة وأحكامها، وهكذا تفسير اللغات وترجماتها، بل تعامل العقلاء كافَّةً[1].
فالحدُّ عند ابن تيمية ما هو إلا تفصيلُ ما دل عليه الاسم بإجمال؛ وهو ما يسمَّى في كتب المنطق بالتعريف اللفظي، فيكفي فيه أدنى مميِّز معروف للمخاطب؛ لأن غرض الحد التمييزُ لا تصويرُ الماهية، وبهذا تتيسر سبلُ اكتساب المعرَّف، ويسهل على كل عاقل تعريف غيره بما يريد.
ويدخل في هذا المفهوم التيمي الواسع لمفهوم الحدِّ أنواعٌ من التعريفات الدارجة في العلوم المختلفة، منها[2]:
1- التعريف الاسمي؛ وهو ما يُسَمَّى التعريف اللفظي؛ وهو ما اعتمده الغربيون بديلًا للحد المنطقي، ومن أمثلته ما في المعاجم وكتب المصطلحات والتعاريف. ومن هذا النوع معنى قوله تعالى: {وعلَّم آدم الأسماء كلها}[البقرة ٣١].
2- التعريف بالمميِّز، وعليه علماء المسلمين كافَّةً، وأكثر التعريفات من هذا النوع، ومن أمثلته تعريفُ الغِيبة في الحديث بأنها: ((ذِكْرُك أخاك بما يكره))[3]، وتعريفُ الكِبْر بأنه: ((بطَر الحقِّ وغَمْطُ الناس))[4].
3- تعريف المصطلحات الشرعية، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق.
4- تعريف المصطلحات العُرفية، وهي ما يُسَمَّى في أصول الفقه: الحقائقَ العرفية، وقد تكون أعمَّ من اللغوية وقد تكون أخصَّ، كلفظ "رقبة"، صار يطلق عرفًا على جميع البدن عند الحديث عن تحرير الرقبة.
ويدخل في هذا المصطلحات المتعارف عليها في الفنون المتنوعة؛ كما في مصطلحات علوم الحديث والفقه والعقيدة والبلاغة واللغة وغيرها من العلوم. وأُلِّفت في ذلك معاجم وموسوعات مشهورةٌ بين العلماء، مثل "الحدود" لابن عرفة، و"التعريفات" للجرجاني، و"الكليات" للكفوي، و"كشاف اصطلاحات الفنون" للتهانوي، و"دستور العلماء" للأحمد نكري، وغيرها.
5- التعريف بالمرادِف اللفظي؛ وهو ما في المعاجم والقواميس اللغوية.
6- التعريف بالمثال؛ كما في قولك تعريف صفات الله تعالى: كعلمه وقدرته وسمعه وبصره.
7- التعريف بالإشارة والصورة؛ كقولك لمن سألك عن معنى لفظ "الكنغر" مثلًا: مثل هذا، وتُشير إلى صورته، أو تذهب به إلى حيث يوجد فتُشير إليه.
ثانيًا: بدائل القياس الأرسطي:
يرى ابن تيمية أن البديل الإسلامي للقياس الأرسطي هو ما سمَّاه القرآن الكريم بالميزان، ويشمل الأمثالَ المضروبة والأقْيِسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرِّق بين المختلفات، ويدخل فيها أنواع من القياس الفطري المباشر[5]:
1- القياس الفقهي:؛ وهو قياسُ التمثيل الذي يستعمله فقهاءُ الشريعة في الأحكام، وألحقوا به ما لم يَرِدْ فيه نص بما كان منصوصًا على حكمه، إذا كان الوصف المؤثر في الحكم جامعًا لهما؛ كما في النبيذ مع خمر العنب، وكما في الأموال الربوية مع الأصناف الستة المنصوص عليها، وكما في تنزيل أحكام النقْدَين على ورق العُملة، ونحو هذا، فما يسميه الأصوليون هنا العلةَ الجامعة التي ألحقت هذه الفروعَ بأصولها في القياس، هي البديل المقابل لما يُسَمَّى في القياس الأرسطي بالحد الأوسط.
2- دلالة الآيات: وهي العلامات والأماراتُ التي تدل على المطلوب بملازمتها له، وتفترق عن القياس المنطقي بتعيينها للمطلوب مباشرة، دون توسُّط قضية كلية، فهي استدلالٌ بجزئي على جزئي، لا بكُليٍّ على جزئي؛ كما في القياس المنطقي. فالمخلوقات المعيَّنةُ آيةٌ على خالقها المعيَّن، والمعجزات المعينة آيةٌ على النبي المعين الذي اختصَّت به، وهكذا.
3- قياس الأولى: وهو ما يكون المطلوبُ فيه أولى بالثبوت من الـمَقيس عليه؛ وهو الذي ورد استعماله في القرآن والحديث وكلام السلف في حق الله تعالى؛ كما في إثبات كماله وتنزيهه عما لا يَليق به، وكما في إثبات القدرة الإلهية على بعْث الأموات، وكما في تنزيه الأنبياء عن الكذب.
[1] انظر: علي النشار، "مناهج البحث"، ص ٢٠٢ – ٢٠٦، علي السويلم، "رؤية نقدية لنظريات أرسطو طاليس المنطقية"، ص ٨١ وما بعدها.
[2] انظر: عبد الله السهلي، "البدائل الإسلامية للحدود المنطقية"، ضمن مجلة جامعة الإمام، عدد ١١، ص ٣١٣ – ٣٢٨.
[3] صحيح مسلم، برقم ٢٥٨٩.
[4] صحيح مسلم، برقم ٩١.
[5] انظر: علي النشار، "مناهج البحث"، ص ٢٧٢ – ٢٨٠.
انقر هنا للوصول إلى صفحة الكتاب كاملاً.
انقر على الصورة للوصول إلى النسخة المصورة (pdf) قابلة للتحميل والنشر.