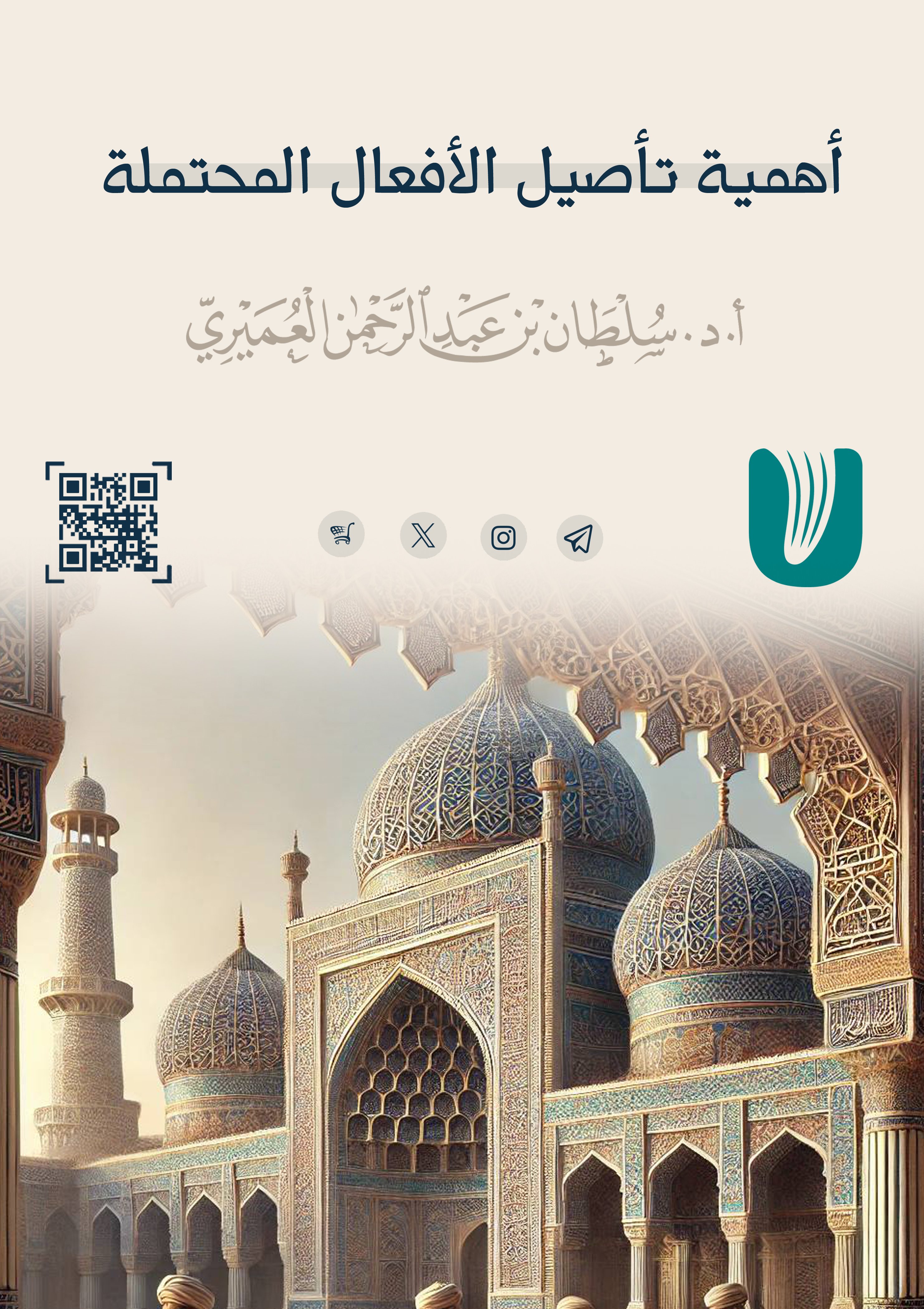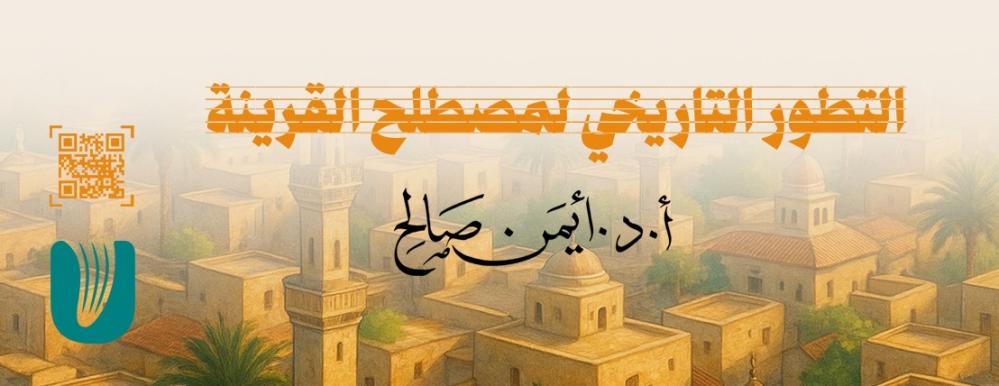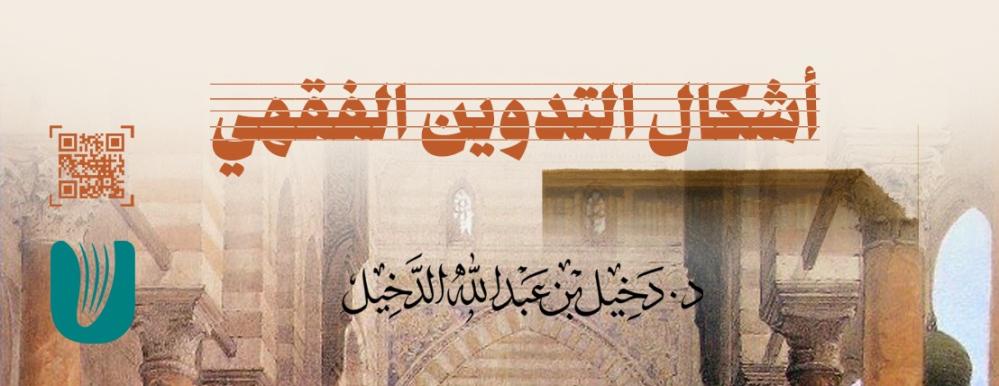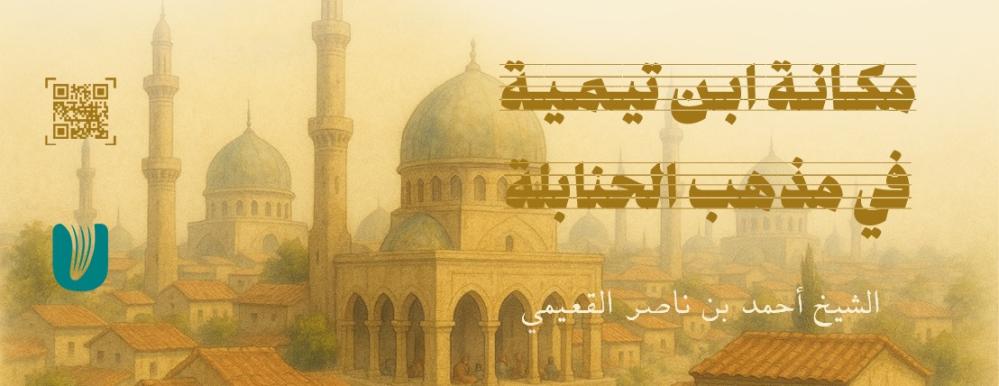أهمية تأصيل الأفعال المحتملة
أ.د. سلطان بن عبدالرحمن العميري
تأصيلُ الأفعال المحتمِلة من جهة مفهومِها وضوابِطها وشروطِها وضبطِ أحوالها مهمٌّ جدًّا في البحث العقدي، وذلك لعدد من الأمور:
الأمر الأول: أنّ كثيرًا من طلبة العلم لا يدركون ذلك التأصيلَ، ولا يعلمون كثيرًا مما يتعلق به من ضوابط وقيود، وقد أدى هذا إلى حدوث عدد من الإشكالات، بل وصفها بعض العلماء بالاضطراب.
وقد شكا بعض العلماء المعاصرين من كثرة الإشكال في هذا الجنس من الأفعال، وبيَّن أن كثيرًا من طلبة العلم يدخل عليهم الاضطرابُ من عدم تحريرهم للمناطات المؤثّرة فيها، يقول الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- بعد أن ذكر أنواعَ الخوف: الخوف الجائز، والخوف الشركي، والخوف المحرم: "هذه أقسام ثلاثة مشهورة، وبها تجمع مسائل أقسام الخوف، والشركيّ منه وما ليس بشركي منه، وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب العلم؛ لأنه ليس عندهم ضبط للخوف الذي يحصل به إن صُرِف لغير الله جل وعلا الشركُ الذي يوصَف به من قام به أنه مشرك، أي خوف هذا؟ هو خوف السر، ووصفُه وضبطُ حاله هو ما ذكرته لك من قبل، فكن منه على ذكر وبيّنة في فهمك لهذه المسألة العظيمة"([1]).
ومن تتبع واقع كثير من المشتغلين بالعلم يجد صدقَ هذا الكلام، فكثير منهم ليس لديه تصوُّر عن أصل انقسام الأفعال العبادية، ويتصور أن تقسيم ما يتعبَّد به إلى عبادات محضة وأفعال محتملة خطأ في نفسه، وبعضهم يقرّ بهذا التقسيم، وليس لديه ضابط محرَّر يفرِّق به بين النوعين، ولا بين موجبات التوحيد والشرك في الأفعال المحتملة.
الأمر الثاني: أن معرفة الأفعال المحتملة وقاعدة التعامل معها يعين على فهم كثير من النصوص الشرعية، ويحقِّق الفقه الدقيقَ لها ودقة تأصيلها، وذلك أن كثيرًا من تلك الأفعال المحتملة جاء استعمالها في النصوص الشرعية، وأطلقت على الله تعالى وعلى المخلوق في سياق واحد، وهذا الإطلاق يحتاج إلى فقه وتأصيل ومعرفة للضوابط والقيود التي يمكن من خلالها معرفة المراد من تلك النصوص، ودفع ما يتوهَّم من حدوث الإشكال فيها.
ومن أمثلة على تلك النصوص: تعليق التوبة بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟"([2]).
فعائشة في هذا الحديث قالت: "أتوب إلى الله وإلى رسوله"، ومن المعلوم أن التوبة من أجلّ العبادات وأعلاها قدرًا، فكيف قالت: وأتوب إلى رسوله؟!
ومن أمثلة ذلك: ما جاء من تعلّق الخوف بالله وبالمخلوق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "والله ليتمَّنَّ هذا الأمرُ حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه"([3]).
فمن المعلوم أن الخوف عبادة من أجلِّ العبادات، ومع ذلك فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الخوفَ من الذئب وعطفَه على الخوفِ من الله، فهل يقال: إن هذا الحديثَ تضمَّن صرف شيء من العبادة لغير الله؟!
ومن أمثلة ذلك: ما جاء من إطلاق التقرب إلى الله ورسوله، فقد جاء أن امرأة ابن مسعود لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحثّ على الصدقة خرجت بحُلِيِّها، فقال لها ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت: "أتقرّب به إلى الله ورسوله"([4]).
ومن المعلوم أنّ التقربَ عبادة من أجلّ العبادات، فكيف قالت امرأة ابن مسعود: أتقرب إلى الله ورسوله؟!
ومن أمثلة ذلك: تعليق القنوت بالله ورسوله، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ}.
فمن المعلوم أنَّ القنوت عبادة من أجلّ العبادات، ومع ذلك فقد أطلق الله تعالى في هذه الآية القنوتَ للرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يقال: إن هذه الآية تضمَّنت صرفَ شيء من العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم؟!
وكذلك الحالُ في كثير من الأعمال التي جاء في النصوص الشرعية ما يدلّ على أن صرفها للمخلوقين وتعليقَها بهم ليس شركًا، كالسجود والإعانة والاستغاثة والنصرة وغيرها، كما في قوله تعالى: {فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما} [الكهف: 95]، وقوله تعالى: {فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه} [القصص: 15]، وقوله تعالى: {أن اشكر لي ولوالديك} [لقمان: 14].
فهذه النصوص كلّها تحتاج إلى فقه وتأصيل، بحيث يكون المشتغل بالعلم عارفًا بالمراد منها، ومدركًا للضابط المميز بين الحالة التي تكون فيها تلك الأفعال عبادةً لا يجوز صرفها إلا لله تعالى، وبين الحالة التي لا تكون فيها عبادة.
وقد حاول بعض المنحرفين أن يستثمرَ هذا النوعَ من النصوص، وادّعى أنها تدلّ على أن تلك الأفعال ليست مما يُدخِل الإنسان في الشرك الأكبر؛ بحجة أن الله تعالى ذكرها منسوبةً إلى المخلوقين، بل ومعطوفة على نسبتها إليه سبحانه.
فدراسة الأفعال المحتمِلة وما يتعلَّق بها من تقسيم وضوابط وقيود مهمٌّ جدًّا في فهم النصوص الشرعية، وحسن التعامل معها.
الأمر الثالث: أن الأفعال المحتمِلة من أكثر المواضع التي يشغِّب من خلالها المنحرفون في مفهوم العبادة على مذهب أهل السنة، ومن أوسع الأبواب التي يدخلون من خلالها للتشكيك وبثّ الشبهات.
ومن يتتبَّع أطروحاتهم المكتوبةَ والمسموعةَ يجد أن الأفعال المحتملة من أكثر ما يدندنون حوله، ويدّعون من خلالها أن المذهب السلفي غيرُ منضبط في مفهوم العبادة والتوحيد والشرك.
فتراهم يقولون: الله تعالى أمرنا بتعظيمه، فتعظيمُه عبادة من أجلّ العبادات، وفي الوقت نفسه أمرنا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يكون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم شركا أكبر؟! فما الفرق بين هذين النوعين من التعظيم، وكلاهما معنى قلبي، ولا فرق بينهما من جهة حقيقة التعظيم؟!
وكذلك يقولون: السجود لله تعالى عبادة من أجلّ العبادات، وإذا كان السجود للمخلوق على جهة التحيّة فهو لا يكون عبادة له، فما الفرق بين الحالين مع أن صورة الفعل في الحالين واحدة، ولا فرق بينهما في الحقيقة؟!
فالدكتور حاتم الشريف اتَّهم مخالفيه بأنهم "كفَّروا بشرك العبادة، وهم لم يعرفوا متى يكون عمل الظاهر أو القلب عبادة، فضلا عن أن يعرفوا متى يكون عمل الباطن من أعمال القلوب -كالحب والرجاء والخشية- عبادة"([5]).
وعقد مبحثا بعنوان "التحدي بذكر الفرق بين العبادة وغيرها من أعمال القلوب والجوارح"، وقال فيه: "كنت -وما زلت- أتحدَّى المخالفين أن يبيّنوا الحدّ الفاصل بين العبادة وغيرها من أعمال القلوب، التي هي أساس الإيمان والكفر، كالحب والرجاء والخوف من أعمال القلوب، بل هي أساسها، وحتى الآن لم يستطيعوا القيامَ بهذا التحدي، حيث إنهم عجزوا كل العجز عن بيان الحد الذي يفصل بين عمل القلب الذي هو عبادة وعمله الذي ليس بعبادة، بل صار بعضهم يهرب عن إلزامه الذي عجز عنه بادعاء أنه لا يلزم وجود هذا الحد أصلا"([6]).
ثم أخذ يطرح أسئلة من قبيل: متى تكون المحبة لغير الله شركا؟ ومتى يكون الخوف من غير الله شركا؟ ومتى يكون السجود لغير الله عبادة؟ وغيرها من الأسئلة([7])، وقد تناول هذه القضية مرات عديدةً في كتابه.
وليس المقصود هنا بيان تهافت هذا الكلام وبطلانه، فإنه سيأتي في مبحث مفرد، وإنما المقصود بيان أهمية الاهتمام بالأفعال المحتملة وضبط أحوالها وأقسامها ومناطاتها، وبيان أنها من المداخل التي يركز عليها المخالفون كثيرًا في الاعتراض على مفهوم العبادة والتوحيد والشرك.
فلأجل هذه الأسباب وغيرها كان من المهمّ جدًّا أن يحرص طلاب العلم على ضبط هذه القضية، وأن يدقّقوا في أحوالها ومناطاتها، وأن يكون منطلقهم فيها تحرير البحث الشرعي، وإتقان مآخذه وقيوده وشروطه.
الأمر الرابع: أن معرفة الأفعال المحتملة وفهم قاعدة التفصيل والتفريق فيها يعين على ضبط باب التفكير، فإن الشريعة شدَّدت كثيرًا في باب التكفير من جهة تحديد جنس المكفرات، ومن جهة تنزيل أحكام التكفير على المعيَّنين.
وضبط الأفعال المحتملة يتعلّق بفقه جنس المكفّرات، فإن الفعل إذا كان محتمِلا لعدد من الأحكام، ولا يكون فعلا موجبًا للكفر الأكبر أو الشرك الأكبر إلا في حالات مخصوصة، فلا بدّ من ضبط هذه الحالات، وتدقيق النظر فيها، وتمييزها عن غيرها من الحالات التي لا توجب الكفر ولا الشرك، وهذا الأمر الجليل إنما يتحقَّق بدراسة الأفعال المحتملة، وضبط معيار التوحيد والشرك فيها.
_______________
([1]) شرح ثلاثة الأصول (90).
([2]) رواه البخاري (2105).
([3]) رواه البخاري (6943).
([4]) رواه أحمد (8862) وابن خزيمة (2461).
([5]) مفهوم شرك العبادة (18).
([6]) مفهوم شرك العبادة (109).
([7]) انظر: مفهوم شرك العبادة (110-118).
انقر هنا للوصول إلى صفحة الكتاب كاملاً.
انقر على الصورة للوصول إلى النسخة المصورة (pdf) قابلة للتحميل والنشر.